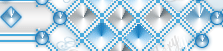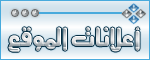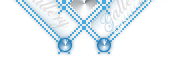|
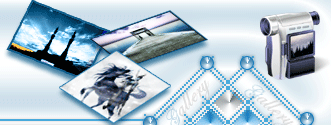 |
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
 اهداءات نور الأدب
اهداءات نور الأدب |
|
|
|
|||||||
|
| الاتحاد الأوروبي العربي للديمقراطية و الحوار مسجل في بريطانيا تحت رقم تسجيل (656 9308 02) رئيسته ومؤسسته و المشرفة عليه الشاعرة فابيولا بدوي |
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
|
رقم المشاركة : [1] | |
|
طبيب أسنان - شاعر وأديب - مشرف منتدى السويد - الفعاليات الإنسانية والمركز الافتراضي لإبداع الراحلين
    
|
الإسلام في السويد يكون أو لا يكون - الحلقة الثالثة
مع انتهاء العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
2001-2010م الإسلام في السويد: يكون أو لا يكون ! - الحلقة الثالثة – ربما كان من البديهي وقد إبتدأنا سلسلة هذه المقالات بقضية الرسوم المسيئة دانماركياً فسويدياً في الأعوام 2005م و2006و2007م أن نستمر زمنياً مع تطورات هذه القضية في الأعوام التالية 2008و2009و2010م إلا أنني ولإعتبارات خاصة قد أتمكن من الحديث عنها يوماً سأتوقف عند ذات العام 2005م ومنه أنتقل إلى بداية هذا العقد في محطات هامة ومفصلية تشكل في رأيي وإجتهادي الهزات السببية والأساسية والإرتدادية على السواء لما حدث ويحدث في السويد وسأعود بإذن الله تعالى تاريخياً إلى المتابعة في تطور هذه القضايا ومجرياتها بعون الله وتوفيقه ما إن إنتهت قضية القس السويدي رونار سوغورد حتى كانت إحصائيات هيئة الإندماج السويدية واستطلاعات الرأي تشير إلى زيادة في انعدام الثقة وتدهور العلاقة بين المسلمين والمجتمع السويدي . ونشرت جريدة سيد سفنسكا في الاول من سبتمبر 2005 نتائج تقرير يشير إلى أن " ثلثي الشعب السويدي لا يرى توافق قيم الجالية المسلمة مع قيم المجتمع السويدي وهي نتيجة اقلقت مجلس مسلمي السويد ودعتهم لقرع جرس الخطر والمسارعة للإجتماع مع رئيس الوزراء انذاك يوران بيشون, ووزير الاندماج ينس اورباك الذي لم يعلق أهمية كبيرة على هذه النتيجة لكنه أكد " أن هناك مسافة كبيرة اليوم بين المجتمع السويدي والمسلمين". ثمانية من كل عشرة سويديين رأوا أن من الجيد أن يندمج الناس من مختلف الثقافات والتقاليد ولكن هذه الرؤية لم تكن ذاتها عندما يتعلق الأمر بمجموعة معينة : المسلمون !بالطبع لم يكن الأمر جديداً لانه في العام 2004م أظهرت الأكثرية التي شملها الإستطلاع معارضتها لإرتداء الحجاب في اماكن العمل والمدارس وعارض الثلث من العينة بناء المساجد في السويد. هذه النتيجة لم تكن مفاجئة لـ هيلين لوف رئيس منتدى التاريخ الحي التي رأت أن الحرية متاحة في السويد لليهود والمسلمين والشواذ جنسياً ولكن قضية توافق القيم الإسلامية مع المجتمع قضية خادعة!! في تلك الفترة 2004م -2005م شكلت هذه المشاعر الحانقة ضد الإسلام والمسلمين الأرضية الخصبة لما أصبح لاحقاً يعرف سويدياً وأوربياً بمصطلح " الإسلام فوبيا" أي " الكره والخوف من الإسلام " والذي بحسب تقرير لـ معد الشمري دخل عام 2006م لأول مرة ضمن التعداد العام لحالات جرائم الكره في السويد والتي بلغت في العام المذكور حوالي (3300)جريمة. "جرائم الكره" هذه ازدادت بنسبة 11% عن السنة ما قبل الماضية 2005م! دخل ضمن تلك الجرائم العداء العنصري للمهاجرين، والتي بلغت نسبتها حوالي63% من مجموع جرائم الكره..ولجأ البعض إلى الإعتداء على المسلمين، بدءاً من إرسال رسائل ذات طابع عدواني إلى منزل أو مكان عمل الضحية، وانتهاءاً بالاعتداء المباشر عليهم كما حدث مع السياسية الأشتراكية الديمقراطية (مريم عثمان شريفاي) التي استلمت عدداً من الرسائل الإلكترونية تضمنت الإساءة والإهانة العنصرية. لقد ساهم أتباع لوبي الإسلام فوبيا إبتداءاً بإثارة مشكلة منع الحجاب في أوروبا وألف أتباع هذا التيار بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عدة كتب معادية للإسلام، وإنخرط الكثير من الكتاب والصحفيين الأوروبيين في موجة العداء للإسلام وحملات الإساءة لمقدسات المسلمين وبالتأكيد كانت السويد ضمن هذا نطاق هذا التأثير, وبدأت دائرة العنصرية تضيق وتتحدد من "المهاجر القذر" إلى "العربي القذر" و"المسلم القذر" .- انظر تقرير معد الشمري للجزيرة توك في 10/10/2007م. ليس علينا أن نستغرب من هذه الصورة المشوهة وهذه المشاعر المتفجرة جهلاً وكراهية لأننا في قرارة أنفسنا وكجالية مسلمة كنا وما يزال البعض منا يعيش حالة غريبة يعجز أطباء وعلماء الإجتماع والنفس وصناعة الحضارات عن وصفها أو تقديم وصفة طبية عاجلة لعلاجها وبدل أن نلتفت لمواجهة هذا الإعصار المتزايد من مشاكل الجالية المسلمة والمد المتصاعد من الهجمات والطعنات من مجتمعاتنا الأوروبية كنا نخوض وقبل هذا التاريخ بأعوام طوال معارك الإتهام فيما بيننا ويمكننا أن نتوقف عند مقالة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عددها 8107 في 7 فبراير 2001م تضمنت جدلا بين كتاب وقراء مسلمين من كل من ألمانيا والسويد وهي توضح بشكل كبير مستوى التفاوت في نظرة العرب والمسلمين الذاتية لأنفسهم ونظرتهم الى الاخر الغربي يقول بكري الصايغ من لايبزج في المانيا: نشر الاخ سليم سليدا من السويد ـ رأيه الخاص جداً في اسلوب حياة العرب في السويد في ظل ديمقراطية هي ـ وبحسب وجهة نظره ـ عبارة عن شذوذ عنصري تفوح منها رائحة الحقد والتخلف. وشن هجوماً ضارياً على هذه الديمقراطية وأهلها وسلطاتهم الحاكمة وكال للجميع (شعباً وحكومة) أنواعاً من السباب والتي ما سمعنا بعربي يصف بها دولة أوروبية أو غيرها بهذه الحدة مع كونه مقيماً فيها!. وانهى مقالته بمطالبته الجمعية العامة للامم المتحدة ولجان حقوق الانسان ان تراقب وضع الاجانب في دولة السويد. " وبالحقائق والبراهين التي تفند كلامه أذكره بمقالة كتبها الاخ أحمد الركابي نشرت في صفحة كاملة في باب «تحقيقات» بجريدة الشرق الأوسط وكان التحقيق المصور عن حياة العرب في السويد. ومن هم.. وكيف يعيشون.. وقد رأيت ان اقتطف منها مقاطع مهمة تبين كيف تلوى الحقائق وتزيف المواضيع. يقول الركابي: «تعد الجالية العربية من الناحية العددية اكبر اقلية عرقية بعد الفنلنديين الذين يقدر عددهم بنحو 350 الف نسمة.. وعلى الرغم من ذلك لا يبالغ المرء اذ يصف الناطقين بالضاد على انهم أقل تأثيراً والاضعف حضوراً في المجتمع السويدي ولعل ذلك مرده الى ان العرب اتفقوا على الا يتفقوا في اي مكان في العالم». ويكمل موضوعه فيقول: «ان وضع العرب هنا لا يبعث على السعادة.. فنادراً ما تجد انساناً يمكن ان تتجاذب معه اطراف الحديث في موضوع ثقافي أو مسألة فكرية. انك تجد هنا نماذج سيئة ما كنا نعلم بوجودها في بلداننا!!». في ضوء هذا الوضع يعيش احد اللبنانيين وهو يصرف معظم وقته في ممارسة الرياضة وهو يفضل ايضاً مخالطة السويديين على معاشرة العرب.. اذ يعتقد ان عدم الاقتراب من بني جلدته راحة للبال ووقاية من الخوض في القيل والقال، فهم لا شغل لهم سوى الطعن في بعضهم بعضا ولا يسلم أحد من شر السنتهم. بل والادهى من كل ذلك ان العرب هنا لا يقرأون الصحف سواء كانت عربية أو سويدية «فشغلهم الأول هو جمع المال ولا يولون أهمية تذكر للمسائل الاخرى، أضف الى ذلك ان الخيار الناتج عن نقص الوعي جعل المهاجر الذي غادر بلده في الستينات أو السبعينات متقوقعاً داخل عقلية الحقبة الزمنية تلك ولم يعد قادراً على مواكبة التطور سواء كان ذلك في وطنه الأصلي أو في السويد».. تقول مقاطع من المقالة ان مدينة أودفالا ـ مدينة ساحلية صغيرة في غرب السويد يقطنها بضع مئات من العرب ومع ذلك تزخر بأمثلة كثيرة من التشرذم المخيب للآمال.. وليت الأمر وقف عند هذا الحد المحبط عربياً، فتذكر المقالة ان الفضائيات العربية قد ساهمت الى حد لا يستهان به في تعميق عزلة المهاجرين. فهناك عرب في السويد لا علم لهم على الاطلاق بما يجري من احداث في السويد، وان معرفتهم بالتطورات التي تجري في دبي على سبيل المثال أفضل بكثير من معلوماتهم عن حدث يقع على مقربة من بيتهم!!. أوردت المقالة حقيقة خطيرة حيث تقول «ثمة احصائية تبين ان المراهقات الشرقيات بمن فيهن العربيات يلجأن الى الاجهاض اكثر من السويديات وان هذا يعكس بشكل واضح عجز الكثيرين من العائلات المهاجرة عن ممارسة الدور التربوي وفق اسس صحيحة. ومما زاد الطين بلة ان ما يسمى بجرائم الدفاع عن «الشرف» العربي تحتل فيها الجالية العربية بالسويد المرتبة الأولى في أوروبا، مما حدا باحدى اعضاء البرلمان السويدي والتي هي من اصل كردي ان تدعو لطرد أي مهاجر يثبت تورطه في جرائم من هذا النوع، خصوصاً بعد ان استبد الغضب بعامة الشعب السويدي نتيجة لهذه الجرائم التي تستهدف النساء بصورة خاصة». وبعد هذه المقتطفات التي كانت هامة لالقاء نظرة على الجالية العربية وأحوالها في السويد، وهو الامر الذي لم يذكر الاخ سليم شيئاً عنه، نطرح سؤالاً حول كيف تعاملت الحكومة مع جالية عربية بهذا الوضع وبهذه الحالة؟ وأي نوع من الممارسات اتخذتها معهم السلطات المسؤولة؟ يقول الاخ الركابي في مقالته «يحق لكل مواطن سويدي بلغ الثامنة عشرة من عمره ان يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية.. كما يحق للمواطن الاجنبي ان يشارك في انتخابات البلدية والمحافظة بعد مرور ثلاث سنوات على اقامته في البلاد. ولا يوجد رقم دقيق يبين حجم المشاركة العربية في أي من هذه الانتخابات على ان الاحصائيات الرسمية تشير الى مشاركة ضعيفة عموماً من قبل المتحدرين من أصول اجنبية.. ولهذا فقد رصدت الحكومة والبلديات مبالغ كبيرة لرفع مستوى المشاركة وتشجيع المهاجرين على الإدلاء بأصواتهم». وليت هذه العزلة ما بين العرب والجهات الحكومية قد اقتصرت فقط على الانتخابات فهناك شكوى من الجهات السويدية العاملة في حقل التعليم ان الاباء المهاجرين لا يحضرون الاجتماعات المخصصة لهم في المدارس في حين يتابع السويديون أوضاع اطفالهم باستمرار وهو الجانب المهمل لدى غالبية الآباء. اهتمت الحكومة السويدية انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي بالاهتمام بمشكلة تنامي المهاجرين المشردين الذين قدموا من دول اخرى وقد هدتهم المخدرات والادمان وعملت على معالجة احوالهم الاجتماعية بصورة تحفظ كرامتهم. وكان من بين الذين شملهم هذا الاهتمام عرب من شمال افريقيا. وقبل ان اختم مقالتي أقول ان هذه المقالة قد اصابت كل عربي في الغربة الأوروبية في مقتل.. واظهرتنا بمظهر الجاحدين والناكرين للعرفان والجميل.. واننا لا نعرف آداب وأصول احترام البيت وأهله وهي مقالة (وان كانت تعبر عن رأي شخصي) الا ان منظمات اليمين ستستغلها كبطاقة حمراء سترفعها دوماً في وجوهنا العربية اينما حللنا وأقمنا في هذه القارة؟ ان الديمقراطية السويدية بخير.. بدليل ان السيد سليم سيلدا كتب اسمه وعنوانه على رأس هذه المقالة بلا خوف أو وجل من أي جهة سويدية.. ومستفيداً من حرية الصحافة والرأي والكلمة التي لم تمنعها السويد حتى عن الاجانب؟. اخي لقد انطبق عليك المثل الذي يقول: «شحاذ وفي حزامه خنجر». اي اننا نشحذ واذا رفض احدهم ان يعطينا ما نطلب نسحب خنجرنا ونغرسه في كبده!. ان كل الموجودين من بلداننا الذين يعيشون لاجئين في دول أوروبا يعرفون جيداً ان من بين معارفهم من لا يستحق حق اللجوء ولا امتيازاته ومعوناته، ومع هذا يتمتع بهذه الامتيازات من معونات نقدية الى سكن الى حق العمل وغيرها. بل ان هناك من يتدلل على السلطات في موطنه الجديد ويطالبها بتغيير مسكنه لأنه لا يليق بعائلته! أو ان الضوضاء في الشارع المجاور له كثيرة وتؤثر على صحته.. وهناك من يشتغلون سراً في أعمال مختلفة ويقبضون نقداً من دون علم دائرة الضرائب وهم الذين أصلاً يتقاضون معونات اجتماعية لهم ولاسرهم. ومع هذا كله نتهم أوروبا بالعنصرية.. ومن دون خجل.!!!" أ.ه بالتأكيد لم يكن لمثل هذه الهزائم النفسية القابعة في النفوس أن تحقق نصراً أو إنجازاً وبما أننا بهذا المقال عدنا الى بداية العقد الاول من القرن العشرين فلم لا نتوقف في ذات السياقين "نحن والاخر" عند حدث كبير أقام الدنيا واقعدها خارج السويد واشك أن أحداً من منظمات وهيئات واتحاد الجاليات الإسلامية إهتم له, كاد هذا الحدث أن يكون عادياً ككل سنة " .توزيع جوائز نويل" السويدية العالمية لكن إسم المكرمّ غير المكرم أثار شكوك وحفيظة المسلمين في العالم الإسلامي ضد السويد. فيديادر سوراجبراساد نيبول المسمى أديباً القادم من جزيرة ترينيداد - الجزيرة الصغيرة في البحر الكاريبي والتي لا تكاد ترى بالعين المجردة قبالة السواحل الشرقية لفنزويلا يسمى بقرار لجنة التحكيم السويدية فائزاً بجائزة نوبل للآداب لهذا العام 2001 !! تعود أصول نيبول المولود عام 1932 في "شاغواناس" قرب مرفأ أسبانيا في ترينيداد إلى أسرة هندوسية هاجرت من الهند واستقرت في هذه البقعة من العالم. غادر نيبول في سن الثامنة عشرة إلى إنكلترا حيث حاز شهادة في الأدب عام 1953 من جامعة أوكسفورد. وهو يقيم منذ تلك الفترة في إنكلترا, كرس حياته للكتابة الأدبية، باستثناء سنوات قليلة في منتصف الخمسينات عمل خلالها صحافيا متعاونا مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي. كتب بصورة خاصة روايات وقصصا قصيرة، وله أيضا بعض النصوص الوثائقية. يورد الكاتب حسان محمود الحسون في مقالة له تحت عنوان نوبل " نيبول" .. جائزة للآداب أم لغاية في نفس أبناء يعقوب؟! أن هذه الجائزة أصبحت مع الوقت، أو ربما قبل الوقت بقليل، رسالة "سياسية" خفية، ومكافأة للبعض على حساب البعض .نيبول كاتب شديد العداء للإسلام، ويعرف عنه تبجحه بالهجوم الصريح والفج على الإسلام والمسلمين، والعرب بالجملة ,وقد هاجمته صحيفة الثورة العراقية واصفة إياه بالكاتب الهجين والمعروف بعدائه للإسلام، وشككت في دوافع الأكاديمية السويدية معتبرة أن فوزه جاء لانحياز الأكاديمية السياسي والديني والثقافي وتلفيقها مسوغات منح الجائزة لنيبول.ورأت الثورة أن اتجاهات الأكاديمية السويدية منحازة، وأن اختيارها نايبول جاء لينسجم مع الموجة المعادية للإسلام والمسلمين في الغرب. ولا يحمل منحه الجائزة سوى هذه الدلالة.لا سيما وانه صاحب محاولات مستمرة لـ تشويه الإسلام، وأنه الذي اعتبر الإسلام أسوأ مشكلة في العالم الثالث، وصاحب الفكرة القائلة بأن الإسلام أسوأ بلية تحل في تاريخ الهند وتشوهها. ولشدة هواننا وضعفنا وتفرقنا لم ينف نيبول هذه التهم عن نفسه لا سيما وأنه أمام جائزة عالمية يبدي فيها المرء ويخفي بل على العكس فلقد شن نيبول في تصريحات له لجريدة " الـ موندو " الأسبانية واسعة الانتشار هجوما عنيفا على الإسلام والمسلمين لم يسبق له مثيل في تاريخ جائزة نوبل. ودعا إلى إجبار المملكة العربية السعودية ودول عربية وإسلامية أخرى على دفع تعويضات العمليات التي وقعت في نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر 2001. و أنه يتعين على المملكة العربية السعودية دفع التعويضات عن كل عملية "إرهابية" نفذها متطرفون إسلاميون على حد قوله!!. كما اتهم نيبول العرب بأنهم "يريدون أن يمدوا صمت الصحراء إلى كل مكان، فهم أمة جاهلة لا تقرأ، وهم يقفون ضد الحضارة"، وأن المسلمين بشكل عام شعوب "مليئة دائما بالحقد، ويعتقدون أنه لا سبيل إلى التعايش مع شعوب أخرى إلا بالقوة".ومضى نيبول في تهجمه على "الهمجية الإسلامية" متهكما هذه المرة على العمليات الاستشهادية التي يقوم بها فدائيون فلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي قائلا: إن الأمر يتعلق بمتطرفين يحلمون بدخول الجنة، وهم من أجل ذلك يتذرعون "تارة بإسرائيل وتارة بالإمبريالية الأميركية".وتعليقا على نظرية الأميركي اليهودي صمويل هنتنتون القائلة بصدام الحضارات والتي أشار فيها إلى حتمية الصدام بين الإسلام والغرب، يقول نيبول"أنا لم اسمع يوما عن صدام بين الهندوس والغرب ولا بين اليابان والغرب" منوها إلى أن الصدام دائما يقتصر على الإسلام والغرب" ويرى نيبول أنه "إذا تعرضت دولة واحدة (غربية) للهجوم من طرف الإرهابيين المسلمين فإن هذا يعود لكون كل الدول الإسلامية مسؤولة عن هذا الهجوم، ولذلك فإنه يجب عليها أن تدفع التعويضات. ليس فقط المملكة العربية السعودية ولكن أيضا مصر والجزائر اللتان تشجعان الإرهاب" ، هذا المنطق الذي لم يتبعه نيبول أمام إرهاب الدولة التي تمارسه إسرائيل وأمريكا، وحتى بريطانيا التي منحته جنسيتها دون زرقة عيونه !!.- من مقال للكاتب حسان محمود حسون بتصرف. مع مرور الوقت باتت جائزة نوبل محطة سويدية من محطات التحيز والتسيس والتحريض ومكافأة السياسات المعادية للعرب والمسلمين ومن يدور في فلكها أو يعمل في نطاقها وخدمة أجندتها فمنذ تأسيسها " فاز بالجائزة مئات الأدباء والعلماء والساسة الدوليين ورجال الإقتصاد إلا أن نصيب العرب من هؤلاء لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة فقد منحت جائزة نوبل للسلام للرئيس المصري أنور السادات 1978م مناصفة مع مناحم بيجن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي لتوقيعه إتفاقية كامب ديفيد المصرية الإسرائيلية كما منحت ذات الجائزة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1994 مشاركة مع إسحق رابين رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي وشمعون بيريز وزير خارجيته انذاك وللدكتور المصري أحمد زويل في مجال الكيمياء وللأديب نجيب محفوظ في الاداب عام 1988م فيما منحت للمصري محمد البرادعي المدير التنفيذي الوكالة الدولية للطاقة النووية عام 2005م – صاحب المواقف المعروفة بشأن أسلحة العراق -ويؤكد البروفيسور”غيرلونتساند” مدير معهد نوبل للسلام أن نظام لجنة جائزة نوبل للسلام يرتكز على تسمية المرشح من قبل البرلمانات الحكومية أو المنظمات الدولية المعتبرة أو الجامعات، فقد يتم مثلاً اختيار أحد الأساتذة من جامعة معيَّنة في اختصاص معيَّن وهكذا دواليك يقفز عدد المرشحين عن تلك الجهات عن الألف مرشح لتنظر فيها لجنة نوبل وتصفيها على عدة مراحل لتصل في مرحلتها الأخيرة.ويعتقد “لونتساند” أن سبب شهرة الجائزة وتحولها إلى أرفع جائزة عالمية يعود إلى عمر الجائزة الذي تجاوز القرن وسجلها التاريخي الذي يميزها بالمصداقية والحياد والعلمية. ومثلما حظيت جائزة نوبل بشهرة عالمية يطمح كل مبدع وأديب وعالم إلى نيلها كحلم حياة وتاج إبداع فقد حظيت بجدل لا يقل صخباً وحدة عن شهرتها وقد أثار منتقدو الجائزة عرباً وأجانب عدة أسئلة حول حياد الجائزة وإبتعادها عن المؤثرات السياسية و والمصالح الغربية لذا فقد طرحت الأسئلة التالية… ألم يصف الكاتب الأميركي إيرفينغ ووليس جائزة نوبل بأنها فضيحة عالمية تتحكم بها الرشوة والجنس والجاسوسية السياسية والمصالح الاقتصادية وفساد الضمير؟ ألم يقل الأديب اليوناني العظيم كزنتزاكيس لم أفهم كيف يتاجر رجل في الديناميت ثم يدعو للسلام وينشئ جائزة عالمية لمَن يسهمون أو يساهمون في خدمته؟ ألم يرفض الأديب الأيرلندي الشهير جورج برنارد شو جائزة نوبل قائلا إنني أغفر لنوبل إنه اخترع الديناميت لكنني لا أغفر له أنه اخترع جائزة نوبل؟ألم يقل الأديب المصري صنع الله إبراهيم ليست هناك جوائز بريئة فما بالنا بجوائز يرعاها القتلة والخونة والأعداء؟ ألم يتبرأ منها الأديب اللاتيني الكبير غابرييل غارثيا ماركيز الذي قال سامحوني إذا قلت إنني أخجل من ارتباط اسمي بجائزة نوبل ثم قال إنه لمن عجائب الدنيا حقا أن ينال شخص مثل بيغن جائزة نوبل في السلام تكريما لسياسته الإجرامية؟ثم يتساءل البعض عن مصداقية الجائزة حين ُيفرضُ على “يوسف إدريس” أن يناصفه فيها إسرائيلي فيرفضها جملة وتفصيلا…؟ وعن سبب حجبها عن الأديب العالمي السوفيتي تولستوي صاحب الرائعة أنا كارنينا ..أيام الحرب البادرة ومنحت لأندريه سخاروف المنشق عن الإتحاد السوفيتي الثائر ضده! أماالأديب النرويجي المسرحي اهنوك إبسن فلماذا حرم من الجائزة بحجة أنه من أبناء إسكندنافيا ثم منحت في العام التالي لنرويجي اخر؟!…ولماذا تعطى الجائزة ل174 يهوداً من اصل الأقلية اليهودية في العالم فيما تمنح لثلاثة صينين من أصل مليار صيني ول 12 مسلماً فقط من اصل مليار ونصف المليارمسلم ويتم تجاهل مليار هندي وأكثر من 300 مليون عربي …!؟ولماذ لا تمنح جائزة نوبل إلا لشيرين عبادي الإيرانية المعارضة لبلادها والتركي باهوك الداعي لتوريط بلاده تركيا في مذابح الأرمن..؟! ولماذ لا تمنح لفيلسوف ومفكر عالمي مناصر للشرق وقضاياه كـ ” روجيه غارودي “! وإذا كان البعض يتذرع بالتخلف العربي تقنيا فلماذالم تمنح جائزة نوبل للأداب حتى الان لمحمود درويش الفلسطيني الثائر الذي إضطرت إسرائيل للإعتراف بعالميته وتدريس بعض من نصوصه في المدارس الإسرائيلية بعد أن أقرت بإستحالة تجاهل أديب عالمي مثله أو إدوارد سعيد المعترف عالمياً بعالميته..أو حتى نزار قباني شاعر المرأة الأول بلا منازع!هل هي أزمة نوبل.. أم أزمة إبداع عربي..!؟ ُيقرّ “غير لونتساند” رئيس معهد نوبل للسلام بوقوع بعض الأخطاء في عملية توزيع الجوائزها وفي اساس نظامها الذي تقوم عليه وهو يعتبر أن من أعظم هذه الأخطاء هو عدم منحها للزعيم الهندي التاريخي المهاتما غاندي وهو يعترف في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية أن ” ثمة مَن حظي بجائزة نوبل للسلام من دون أن يستحقها فهناك الكثير من الصعوبات التي تعتري عملية الاختيار وبالتالي فرأيي أن هناك الكثير ممَن أُغفلوا وهم يستحقونها بينما نالها البعض ولم يكونوا يستحقونها.! فيما علق” لونتساند” في سياق هذه المقابلة على قول لأحد الكتاب الإسرائيلين” أن أكثر من ربع الحائزين على جائزة نوبل هم من اليهود “بأنه محض صدفة لا أكثر. في أوكتوبر 2003 م ثارت ضجة كبير في الولايات المتحدة الأمريكية عنما نشرت ثلاث صحف كبيرة وهي نيويورك تايمز، واشنطن بوست، لوس أنجلوس تايمز إعلانا ل” “ريموند داماديان”، أحد رواد التصوير بالرنين المغناطيسي في الطب. ” يتهم فيه جائزة نوبل بتجاهله كأحد أهم مخترعي التصوير بالرنين المغناطيسي عندما منحت جائزة نوبل للطب للعام 2003م بشكل مشترك إلى الأمريكي “بول لوتربور” (74 عاماً) رئيس مختبر الطب الحيوي للرنين المغناطيسي بجامعة أيلينوي، والبريطاني “بيتر مانسفيلد” (70 عاماً) أستاذ قسم الفيزياء في جامعة نوتنجهام البريطانية، لإنجازاتهم في مجال التصوير بالرنين المغناطيسي الذي أتاح تحسين تشخيص الأمراض وتوفير الكثير من المعاناة على ملايين المرضى وكانت لجنة جائزة نوبل ذكرت في حيثيات قرارها أن “لوتربور” و”مانسفيلد” الفائزين بجائزة نوبل في الطب لعام 2003م تميزا بوضع التقدم في مجال الرنين المغناطيسي موضع التطبيق الطبي. إلا أن حيثيات قرار اللجنة لم تتضمن أي إشارة لـ”داماديان” أول طبيب يستعمل أسلوب الرنين المغناطيسي النووي -ما يسمى الآن بالرنين المغناطيسي- في يونيو/حزيران 1970 لتمييز الأنسجة الصحيحة من الأنسجة المصابة بالسرطان في الفئران ومؤسس أول تطبيق طبي في العالم لأسلوب الرنين المغناطيسي النووي.وهو أول طبيب يلفت النظر لإمكانية استخدام الرنين المغناطيسي النووي في التشخيص الطبي، بعد أن كان أداة للفيزيائيين والصيادلة بعد اكتشافه في عام 1937، وبعد أن نال مكتشف الرنين المغناطيسي النووي جائزة نوبل للفيزياء 1944م. وفي عام 1998 منحته جامعة “ويسكونسن ماديسن” درجة الدكتوراه الفخرية بوصفه “أحد مخترعي التصوير بالرنين المغناطيسي. وفي عام 2001 منح جائزة “إم آي تي ليميلسون لإنجازات العمر”، وقد وصفت لجنة الجائزة “داماديان” بأنه الرجل الذي اخترع ماسح الرنين المغناطيسي وهو أول من تبين أنه يمكن التفريق بين الأنواع المختلفة من الأنسجة الصحيحة باستعمال الرنين المغناطيسي، وأنه يمكن تمييز أنسجة العضلات من العظام من الدماغ باستخدام هذه الوسيلة. و أول من سجل براءة اختراع في الاستعمال الطبي للرنين المغناطيسي. وأول طبيب يتمكن من رسم صورة كاملة لجسم إنسان باستخدام الرنين المغناطيسي. و أول من طور ماسحا يعمل بالرنين المغناطيسي ويستخدم في التطبيق التجاري!! يؤكد بعض الكتاب الأمريكيين أن “داماديان” كان على القائمة السوداء للوبي الصهيوني الأمريكي AIPAC ولم ينافسه إلا الممثل والمخرج السينمائي “ميل جيبسون” بعد الفيلم الأخير الذي أظهر فيه دور اليهود في صلب المسيح، وأنه باحث مستقل لم ينضم إلى أي لوبي أن السبب في تجاهله بهذا الشكل الفاضح هو كونه مسيحيا متدينا لا يؤمن بنظرية التطور ويؤمن بنظرية الخلق، وأن هذا ما أثار حفيظة كثير من العلماء ضده وبالذات اللوبي المسيطر على لجان جائزة نوبل! . – مقتظف من مقال سابق بعنوان جائزة نوبل ديناميت الشهرة والجدل – د. محمد شادي كسكين – موقع شاعر الغرباء. جهاد فاضل الكاتب المعروف كتب يومها في العدد الصادر من جريدة الرياض السعودية بتاريخ 20-12-2001م مقالا تحت عنوان لماذا نايبول وليس أدونيس؟ قال فيه " وصفت الصحافة العالمية "نايبول" الكاتب الإنكليزي الهندي الأصل الذي فاز بجائزة نوبل للآداب مؤخرا، بأنه الكاتب الذي طارد جائزة نوبل طويلا قبل أن يفوز بها، أو أنه الكاتب الذي ظل يحوم حول نوبل حتى أقنعها بكفاءته وجدارته بها.. ويبدو أن "نايبول" كاتب ماكر وممن يوصفون بأنم يعرفون كيف تؤكل الكتف، أو بأنهم يعرفون اتجاه الرياح مسبقا.. فمنذ قرأ، أو سمع في وسائل الإعلام أن الغرب يبحث عن "عدو" جديد له بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وكتلته الشرقية، تساءل بينه وبين نفسه: "ومن يكون هذا العدو غير الإسلام"؟ كان ذلك في بداية التسعينات، أي قبل عشر سنوات تقريبا من اليوم، شدّ هذا الهندي الأصل، المشبع حقدا على الإسلام، والطامع بجائزة نوبل، رحاله من بريطانيا حيث يقيم، إلى دول إسلامية مجاورة للهند أو قريبة منها، وبعضها ترتبط بعداء تاريخي معها، هي الباكستان وإيران وماليزيا واندونيسيا، زار مجتمعات هذه البلدان وقلبه يقطر حقدا عليها وعلى أهلها، وليس بعسير تأصيل هذا الحقد وردّه إلى أسبابه.. فاذا كانت "الهندية" المشتبكة بصراع تاريخي مع الاسلام الآسيوي، مسؤولة عن جزء كبير منه، فعلينا ألا ننسى اثر الثقافة المسيحية الغربية في صياغته، وأياً كان الأمر فقد تحوّل هذا الكاتب من "روائي" و"قاص" وهذه هي الغاية قبل هذه الرحلات، إلى كاتب رحالة شبيه بأمين الريحاني في أدبنا العربي الحديث من حيث وصف ما شاهده في رحلاته.ولكن الفرق شاسع بين رحالة ورحالة، فإذا كان الريحاني قد جاب بلاد العرب مدفوعا بحبهم، عاملا على جمع كلمتهم، وهذا ما يتبدّى في كتبه المشهورة، فان "نايبول" جاب بلاد المسلمين بعين غربية حاقدة عليهم، متقصدة وصف سلبيات وعيوب ونواقص مجتمعاتهم، فكأنه عالم اجتماع في إحدى الجامعات الإسرائيلية.. ولكن مردود هذه الرحلات إلى بلاد المسلمين، على نايبول،فاق ما توقع أو ما توقعه له أصدقاؤه. فلم يعد يعرف في الغرب "بالروائي" أو "القاص" بل بالكاتب "الريبورتر" أو كاتب التحقيقات الصحفية، وإذا كان صديقه سلمان رشدي قد اشتهر بروايته آيات شيطانية" فإن كتب "نايبول" عن رحلاته الى بلاد المسلمين لاتقل شهرة في الغرب عن رواية سلمان رشدي، بل إنه بات يشار إلى هذه الكتب على أنها جوهر ما كتبه، وعلى أساس هذه الكتب تقدم إلى جائزة نوبل للفوز بها، ويبدو أن "لحظة" تقدمه إلى جائزة نوبل كانت "لحظة" الحظ السعيد بالنسبة إليه، كانت نوبل تفتش عن كاتب له نفس مواصفات "نايبول" وهي أن يكون قد كتب ضد الإسلام، حاقدا عليه.. وهكذا فاز "نايبول" بجائزة نوبل..قد يقول قائل: إن الشاعر السوري ادونيس له نفس مواصفات "نايبول" بصورة عامة، فلماذا أعلنوا فوز "نايبول" ولم يعلنوا فوز أدونيس؟ ثمة أجوبة عديدة على هذا السؤال قابلة جميعها للمناقشة، أولها أن أدونيس متخصص بهجاء التراث العربي الإسلامي والتاريخ العربي الإسلامي، لا بالمجتمعات الإسلامية المعاصرة التي فاز "نايبول" لأنه ازدراها وهجاها.كانت نوبل بحاجة لهجاء المسلمين الحاليين، لا لهجاء التاريخ والتراث وحدهما. لقد أرادت أن تشرب المنكر وأن يقول لها ساقيها انه المنكر، ولم تكن ارادتها البحث في من "الثابتون" في تاريخ الأدب العربي، ومن هم "المتحولون"، رغم ان هذا الحديث يلذ لنوبل سماعه، ولكن نوبل كانت تبحث عن زيت يصب على نار معاصرة، أو عن زيت يصب على صرح فاغر ينادي بالِثأر في الوقت الراهن، لا عن نار قديمة أو جرح قديم.. فوجدت من يصب هذا الزيت في "قنّ" انكليزي من أصل هندي لديه شخصيا يكفي من الزيت ليصبه من الآن إلى أبد الآبدين.. فلماذا لا يُعطى إذن جائزة نوبل؟ ان لياقة ادونيس لنيل جائزة نوبل- في ظروف تكون فيها الأعصاب أقل توترا- لباقة كاملة بالطبع، ولكن اعصاب الغربيين في هذه السنة كانت فاترة، متوترة، جياشة بالغضب، بحاجة الى مثل "نايبول" فوجدته في "نايبول" و"نايبول" ليس بالتأكيد خاتمة هذا النوع من الكتاب، أو خاتمة مواصفات معينة، بقدر ما هو بداية نوع وبداية مواصفات، وليس أدل على ذلك من الصراع الذي نشب داخل اجتماعات اللجنة السويدية حول من سيكون الفائز، إذ تخلف ادونيس عن نايبول بصوتين، فكما كان المنشق الروسي صاحب رواية "الدكتور زيفاكو، بوريس باسترناك، اية المنشقين عن الشيوعية وحائزي جائزتي نوبل استنادا الى ذلك، يجب التعامل مع فوز نايبول على أنه بداية مجموعةمن المعادين للإسلام، أو المنشقين عنه، سيفوزون تباعا، فمن لم يفز منهم هذه السنة، سيفوز في سنة لاحقة، طالما ان موجة العداء للإسلام آخذة بالاتساع، وطالما أن الإسلام يصنف في دوائر غربية ثقافية وسياسية نافذة، بأنه العدو الجديد للغرب، بعد الشيوعية. ولعل نوبل أرادت عن طريق "نايبول" سبر غور ردود العرب والمسلمين لخلع كل الأقنعة في السنوات المقبلة فتهب نفسها في سنة لأدونيس، وفي سنة أخرى لسلمان رشدي، وفي سنوات لاحقة لكتاب ريبورتاجات، وتحقيقات بلا حصر يستعدون الآن لامتطاء هذه الطائرة أو تلك إلى هذه الدولة العربية أو الإسلامية، ولسان حالهم يقول: "لقد هان عندنا أمر جائزة أسباب منحها، في العمق، هجاء المسلمين".! أ.ه وفي مقال أخر عن ذات الموضوع يكتب الأستاذ جهاد فاضل في ذات الصحيفة بعد يومين من مقاله السابق وتحت عنوان" الأسباب الموجبة لفوز ‘نايبول’! قائلاً": باعطاء الكاتب الانكليزي نايبول (من ترينيداد والهند أصلاً) جائزة نوبل للآداب لهذا العام، تكون مدة الجائزة قد بدأت مرحلة جديدة في تاريخها، تتلخص بمنح جوائزها لكتّاب معادين للإسلام، أو منشقين عنه إذا كانوا مسلمين من حيث المولد والنشأة، فمنذ سقط الاتحاد السوفياتي، ومعه كتلته، الشرقية، وأعني بهذا السقوط منح الجائزة للمنشقين السوفيات ومن في حكمهم، يبحث الغربيون عن عدو جديد يتمثل في رأي الأكثرية المطلقة منهم في الإسلام. وليس أفضل، بنظر الغربيين، من أجل تسليط الضوء على هذا العدو، من اعطاء نوبل، وهي جائزة النظام العام الغربي، لكتّاب يعالجون شتى الوجوه العقائدية والسوسيولوجية والفكرية والسياسية لهذا العدو. وإذا كانت نوبل قد بدأت مرحلتها الجديدة هذه بمنح جائزتها لانكليزي من أصل ترينينادي ـ هندي، لا لشيء إلا لأنه ذم الإسلام في ثلاثة كتب رئيسية له هي التي جلبت شهرته، فليس ما يمنع في العام القادم، أو في الأعوام القادمة، من أن تمنح النوبل جائزتها لمنشقين (عرب أو غير عرب) عن الإسلام، من نوع سلمان رشدي الهندي الأصل، أو تسليمة نسرين البنغلاديشية. ويبدو أن الذي رجّح فوز "نايبول" بجائزة هذا العام الغليان الذي يجتاح الغرب إثرالأحداث التي وقعت في واشنطن ونيويورك. ومع أن الساسة الغربيين يرددون باستمرار أنهم يميزون بين "الإسلام" و"الإرهاب"، إلا أن أحداً لا يستطيع أن يفكر أن الرأي العام الغربي ليس قادراً على مثل هذا التمييز، أو أنه لا يتحلى بالدبلوماسية التي يتحلى بها سياسيوهم.. فكراهيتهم للإسلام تتبدى فيما لا يحصى من المظاهر الاجتماعية والثقافية التي تنقلها وسائل الإعلام المختلفة، والتي تتجاوز بلا أدنى شك كراهيتهم السابقة لأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية. ذلك أن الإسلام بالنسبة إليهم هو عدو تاريخي وحضاري. " لقد أذنت الساعة الآن للمجاهرة بهذا العداء بوسائل مختلفة. وليس أفضل، في هذا الإطار، من وسيلة ثقافية شديدة الفاعلية والنفوذ، هي جائزة نوبل السنوية التي ينتظرها الملايين في كل مكان على سطح المعمورة. لقد جرى توظيف هذه الجائزة في السابق بنجاح منقطع النظير لفضح المجتمع الشيوعي والأنظمة السائدة فيه، فلماذا لا تُوظّف اليوم لفضح الإسلام ومجتمعاته المغرقة في التخلف بشتى مظاهره وفق رؤيتهم؟ لقد وجدوا ضالتهم في كاتب انكليزي من أصل هندي يحمل في قلبه كل أصناف الضغائن التاريخية على الإسلام والمسلمين، وقد أضاف هذا الكاتب إلى ما في قلبه من الضغائن التي ورثها عن ثقافته الهندية، ما تلقاه من ثقافة أوروبية لا تقل حقداً على العرب والمسلمين من ثقافته الأصلية. ويبدو أن هذا الكاتب كان يبحث عن نفسه لمثل هذا اليوم إذ انه كتب الرحلات الثلاث الكبرى التي نوهت بها الأكاديمية السويدية، كأساس لمنحه الجائزة، عبارة عن كتب رحلات قام بها إلى إيران وماليزيا وأندونيسيا والباكستان، وضمنها ما لا يُحصى من المطاعن بالإسلام وأهله. وبذلك أرسى القاعدة الصلبة لجائزة كان يحوم حولها، كما تقول الأخبار، منذ عدة سنوات.. ومن الطريف أن الأكاديمية السويدية، في تعدادها للأسباب الموجبة لمنح "نايبول" جائزة نوبل للآداب، قالت إنه وصف المجتمعات الإسلامية "بدقة"، وبهذا الوصف أعلنت انحيازها الصحيح لوجهات نظره، وتأييدها الذي لا لبس فيه لموقفه المشين من حضارة باذخة ظلت تسطع على الأرض، وعلى الغرب، قبل سواه، أكثر من ألف سنة! لقد فقدت نوبل مصداقيتها. لم تعد، أو لم تكن يوماً، جائزة نزيهة مجردة لوجه الأدب والحق والمثالية، كما شاءها مؤسسها. لقد تحولت إلى جائزة غربيـة، ومنذ اليوم إلى جائزة لحلف الأطلسي، قبل سواه! بالطبع لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي وبالتأكيد لا يضر القضية الإسلامية أن مسلمي السويد ومنظماتهم وما أكثرها لم يهمسوا حتى اليوم ببنت شفة عن هذه القضية لكن التاريخ سجلها كدليل إضافي أن مسار السويد إنحرف أو أنه منحرف أصلاً وإن كنا عنه لغافلين! الى الملتقى صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ورسولنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد وأله واصحابه وأحبابه وأنصاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيراً. د.محمد شادي كسكين – أديب سوري – رئيس الجمعية الدولية للعلوم والثقافة في السويد – 15/06/2010م shadi_dentist_5@yahoo.com info@profeten.org www.profeten.org http://sha3eralghoraba2a.maktoobblog.com نور الأدب (تعليقات الفيسبوك) |
|
|
|

|
|
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| الإسلام في السويد يكون أو لا يكون - الحلقة السادسة | د.محمد شادي كسكين | الاتحاد الأوروبي العربي للديمقراطية و الحوار | 0 | 02 / 01 / 2011 30 : 02 AM |
| الإسلام في السويد يكون أو لا يكون - الحلقة الخامسة | د.محمد شادي كسكين | الاتحاد الأوروبي العربي للديمقراطية و الحوار | 0 | 14 / 12 / 2010 47 : 02 AM |
| الإسلام في السويد يكون أو لا يكون - الحلقة الرابعة | د.محمد شادي كسكين | الاتحاد الأوروبي العربي للديمقراطية و الحوار | 0 | 25 / 11 / 2010 02 : 05 AM |
| الإسلام في السويد: يكون أو لا يكون ! الحلقة الأولى | د.محمد شادي كسكين | الاتحاد الأوروبي العربي للديمقراطية و الحوار | 10 | 15 / 06 / 2010 26 : 08 PM |
| الإسلام في السويد يكون أو لا يكون - الحلقة الثانية | د.محمد شادي كسكين | الاتحاد الأوروبي العربي للديمقراطية و الحوار | 0 | 15 / 06 / 2010 19 : 01 PM |
الساعة الآن 07 : 10 AM
|
|