 |
 |
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
 اهداءات نور الأدب
اهداءات نور الأدب |
|
|
|
|||||||
|
| الشؤون المغاربية خاص بشؤون بلاد المغرب العربي |
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
|
رقم المشاركة : [1] | |
|
كاتب نور أدبي ينشط
  
|
أعجبني هذا الكتاب الصادر عن اتحاد الكتاب العرب لكاتبه" توفيق ميدني" وأردت أن أنقله لكم على مراحل، وهو عبارة عن دراسة مستفيضة عن دول المغرب العربي بستة فصول وينقسم على النحو التالي: توطئة: جدلية صراع الجغرافيا والتاريخ القسم الأول: الموانع السياسية تقف حائلاً أمام الاندماج المغاربي الفصل الأول: الاتحاد المغاربي مسيرة متواصلة من التعثر الفاضح الفصل الثاني: المغرب العربي بين مأزق الصحراء وسياسة الهيمنة الإقليمية الفصل الثالث: انفجار قضية الأمازيغ في الجزائر .. الخلفيات والآفاق الفصل الرابع: الصراع اللغوي في المغرب العربي ( الجزائر أنموذجاً) الفصل الخامس: تطورات متفاوتة في حرية المرأة المغاربية الفصل السادس: الاختراق الصهيوني الكبير لبلاد المغرب العربي نور الأدب (تعليقات الفيسبوك) |
|
|
|

|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [2] | |
|
مشرف - مشرفة اجتماعية
            
|
الأستاذة القديرة هيا الحسيني / حفظك الله حقاً أنت رائعة .. فكل ما تقدميه لهذا المنتدى من مواضيع أو مداخلات يثري المنتدى ننتظر منك سرد الدراسة التاريخية السياسية المفصلة عن دول المغرب العربي أرى أن نشر فصول هذا الكتاب سيمنحنا معلومات كثيرة ربما الكثير منَّا يجهلها دمت بخير 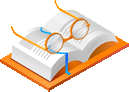 |
|
|
|

|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [3] | |
|
أديبة ومترجمة / مدرسة رياضيات
           
|
رد: اتحاد المغرب العربي بين الإحياء والتأجيل ـــ توفيق المديني - دراسة تاريخية سياسية
يبدو كتابا مهما أستاذة هيا ننتظر إدراجه ونتمنى الاستفادة.
شكرا لك وفقك الله و لك مني أجمل تحية . |
|
|
|

|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [4] | |
|
أستاذة وباحثة جامعية - مشرفة على ملف الأدب التونسي
         
|
رد: اتحاد المغرب العربي بين الإحياء والتأجيل ـــ توفيق المديني - دراسة تاريخية سياسية
الأستاذة الفاضلة هيا الحسيني
تحية لفكرك و لإختيارك هذا الكتاب حول المغرب العربي سأنتظر بشوق إدراجاتك لهذه الدراسة تقبلي تقديري و إحترامي |
|
|
|

|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [5] | |
|
كاتب نور أدبي ينشط
  
|
رد: اتحاد المغرب العربي بين الإحياء والتأجيل ـــ توفيق المديني - دراسة تاريخية سياسية
الأستاذة الفاضلة ناهد شما أنت يا سيّدتي الرائعة.. أشكرك
ألاستاذة الفاضل نصيرة تختوخ.. أشكرك الكتاب هام جداً الاستاذة الفاضلة أسماء بو ستة..أشكرك وأرجو أن ينال الكتاب إعجابك أتمنى أن يكون هذا الكتاب مفيداً للجميع وشكراً لكم |
|
|
|

|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [6] | |
|
كاتب نور أدبي ينشط
  
|
رد: اتحاد المغرب العربي بين الإحياء والتأجيل ـــ توفيق المديني - دراسة تاريخية سياسية
[align=justify]القسم الأول الموانع السياسية تقف حائلا ً أمام الاندماج المغاربي: ـ الفصل الأول الاتحاد المغاربي مسيرة متواصلة من التعثر الفاضح
1 ـــ الاتحاد المغاربي مشلول بعد 17 سنة على تأسيسه لا أحد يشك من الذين تعاطوا ولو بقليل من الجدية والموضوعية مع فكرة إنشاء اتحاد دول المغرب العربي في أن هذه الفكرة والحلم يمران اليوم بأزمة ليست كسابقاتها المتكررة في عهد لم يتعد عقدا أو أكثر من نصف عقد من الزمن، وأخطر ما في هذه الأزمة أنها تتعدى في حجم استعصائها على المعالجة حدود أزمات الإقليم العصية على الاختراق إلى أخرى تجوب انتماءه القومي الأرحب والقاري والعالمي، وتتحكم بموجبها بعض الدول "الكبرى" في مصير الدول والشعوب العاجزة عن خلق نظامها الإقليمي الطبيعي الذي يعتبر لها ضرورة تاريخية كما هو حال الوحدة بين أقطار دول المغرب العربي. إذ يؤكد التاريخ للباحثين والمهتمين بشؤون المنطقة أن هذا الإقليم ظل طيلة مراحل تاريخية يكوّن وحدة اقتصادية وجغرافية وثقافية واحدة، وإن لم تنف هذه الحقيقة بالطبع واقع أن شمال إفريقيا، كما هو الوضع في العديد من أقاليم العالم الموحدة اليوم، قد عرف خلال مراحل متقطعة من تاريخه وجود دول أو عدة دول على أراضيه الشاسعة، لكن تلك الدول لم تكن تشكل في حد ذاتها وحدة اقتصادية أو ثقافية مستقلة، كما أن وجودها بقي ثانويا مقارنة مع وجود الدول الموحدة، كما يشهد تاريخ المنطقة الذي ظلت فيه الوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية والجغرافية هي القاعدة الأصل. وفي العصر الحديث استطاعت الدول الوطنية التي ظهرت داخل الإقليم أن تواجه خطر القضاء على الهوية الذي مورس ضدها بلا هوادة من طرف الجهة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، لا سيما فرنسا، لكن تلك الدول لم تتمكن من استيعاب آليات تستعيد بها وحدتها التاريخية، بل دخلت أحيانا آليات عديدة في لعبة الصراعات الحدودية، واقتسام النفوذ والسيادة على المناطق التي لم يشأ الاستعمار حسم أمرها النهائي بين دول جديدة اقتطع خريطتها بعناية لمقاصد سيئة لا تخفى على المراقب. من أخطر تلك الأمور ما فجر أزمة الحدود بين الجزائر والمغرب، وما عرف بأزمة إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب الذي أدخل الجزائر في مواجهة مزدوجة مع المغرب وموريتانيا سنة 1975، وما زال أهم العقبات أمام محاولات الأنظمة المغاربية في أن تحتذي بالنماذج التوحيدية في ضفة البحر الأبيض الشمالية، محاولات لم تتعرض لهذه الإعاقة الوحيدة وإنما تعرضت لعجز الأنظمة السياسية في بلدان المغرب العربي عن تحديث ممارساتها السياسية في الحكم، وفرز نخب تعبر عن إرادة شعوبها الحقيقية، لأن ذلك الأمر كفيل وحده بتعزيز مسار الوحدة المغاربية بحكم أنها مطلب شعبي تعززه الحاجة الاستراتيجية في خلق كيان يواجه به تهديد الاتحادات القائمة والمنتظرة في المنطقة والعالم. لم تنجح المجموعة المغاربية في تحويل مشروع المغرب العربي الكبير إلى فعل تاريخي قادر على تعزيز مقومات التنمية في الأقطار المغاربية، بل إنها لم تنجح في تركيب برامج مشتركة في العمل قادرة على تحويل بنود ميثاق الاتحاد إلى معطيات ومواد قابلة للانغراس في تربة الواقع، وقادرة في الآن نفسه على تحويل المشروع إلى تاريخ.ورغم المعطيات الجغرافية والتاريخية والثقافية العامة التي صنعت مشروع الاتحاد وحلمه، فإن ضغوط الواقع في أبعاده المختلفة قد كرست واقع الحال القائم بين أقطار المغرب العربي. يفترض المراقب من الخارج أن دول المغرب العربي مهيأة أكثر من غيرها لرسم معالم تعاون عربي إقليمي فاعل في محيطه المجتمعي ومطور لآليات في التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بحكم الطابع الواقعي والبراغماتي الذي وسم أغلب سياسات أقطاره. ولعله يفترض أيضا ً أن غياب الوعي القومي الشمولي عن نخبه السياسية، كما هو الحال عليه في المشرق العربي عموماً، قد يساعد في بلورة أهداف واضحة ومتدرجة، وهو ما يمنحها إمكانية التحقق الفعلي في مستوى الممارسة والإنجاز.. إلا أن ما حصل منذ إعلان ميثاق الاتحاد لا يدعم مثل هذا الرأي، ولعله يكشف بكثير من القوة، وجود خلل ما في الإرادة السياسية يقف بمنزلة حجر عثرة أمام الطموح المجتمعي المغاربي في بناء قوة عربية إقليمية في شمال غرب إفريقيا، قوة قادرة على ركوب درب التنمية بإيقاع أسرع، وقادرة في الوقت نفسه على إعداد محاور للاتحاد الاوروبي الذي يزداد قوة، ويتجه لتعزيز مسيرته التاريخية في بناء القارة الأوروبية.(1). من الواضح أن الإحساس بالأزمة البنيوية العميقة وانغلاق سبل الخروج منها، هو الذي دفع الأنظمة المأزومة إلى محاولة البحث عن مخرج جماعي بإحياء وحدة المغرب العربي بهدف التخفيف من المخاطر الداهمة، علماً أن اتحاد المغرب العربي قام على أساس قطري واندمج في إطار تشكيل وحدة إقليمية على غرار الوحدات الإقليمية العربية، وحدة أنظمة قطرية مسيطر عليها من قبل الإمبريالية الأميركية، ولها وظيفة في هذه الاستراتيجية الأميركية في العالم العربي، والبحر الأبيض المتوسط، لدعم ركائز هذه الأنظمة القطرية، ومنع الحركات الإسلامية الأصولية المغاربية من أن تحقق أهدافها، وخلق نوع جديد من التوازنات يساند فيه النظام القوي النظام الضعيف، ويمنع الأقطار الأكبر من احتواء الأقطار الأصغر. اتحاد المغرب العربي ( ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، وموريتانيا ) الذي تم إنشا ؤه في مدينة مراكش بالجنوب المغربي في 17 شباط/فبراير 1989، يجابه تحديات داخلية وخارجية يلخصها الشلل الكامل لمؤسساته، والتأجيل المستمر لاجتماع مجلس الرئاسة الذي كان مفترضاً أن يعقد في الجزائر عام 1995. ويضم هذا الاتحاد المغاربي حوالي/80/ مليون نسمة من العرب، ويشمل المنطقة من حدود ليبيا مع مصر إلى نهر السنغال، وتصل مساحتها إلى نحو 5.380591 كيلو مترا ً مربعا ً، وفي هذا الاتحاد دولتان مهمتان من حيث الموقع وعدد السكان هما المغرب والجزائر. لا شك في أن وحدة المغرب العربي كمشروع بناء إقليمي قديم متجذر في ضمير شعوب المنطقة، غير أنه يمكن تصنيف المعوقات الكبرى التي اصطدم بها مشروع بناء وحدة المغرب العربي إلى ثلاث: مرحلة إزالة الاستعمار وبناء الدولة الوطنية الحديثة: فبعد عامين من استقلال تونس والمغرب عام 1956، وتجذر الثورة الجزائرية في مقاومة الاستعمار الفرنسي عقدت في مدينة طنجة أول قمة مغاربية ضمت قادة أحزاب الاستقلال المغربي والدستور التونسي، وجبهة التحرير الوطني الجزائرية، لا الحكومات بحكم أن الجزائر لم تنل استقلالها بعد. وبعد استقلال الجزائر عام 1962 كان بناء المشروع المغاربي في قلب المفاوضات بين البلدان الثلاثة، حيث تم توقيع اتفاقيات الرباط في عام 1963، التي نصت على تحقيق التطابق في سياسة البلدان الثلاثة تجاه السوق الأوروبية المشتركة، وتنسيق مخططات التنمية، وسياسة التبادل التجاري. غير أن كل هذه الاتفاقات لم تتجسد مادياً على الأرض، ولم يتجاوز بناء المغرب العربي إطار المشروع النظري بسبب الصراع التنافسي الذي دب بين حكوماته المختلفة على زعامته، واستمرار النزاعات الحدودية الموروثة من الحقبة الكولونيالبة بين مختلف البلدان المغاربية (نذكر في هذا الصدد النزاع المسلح بين المغرب والجزائر في تشرين الأول/أكتوبر 1963 )، وهو ما عكس لنا بروز المظاهر والنعرات الإقليمية التي أصبحت سائدة في عقول وممارسات النخب الحاكمة، والتي قضت على أي تفكير جدي في بناء المغرب العربي الكبير، على نقيض الاعتقاد الذي كان سائداً، والذي كان يعتبر أن استقلال الجزائر سوف يساعد على تحقيقه. ومغزى آخر هو أن الدول المغاربية أغلقت أبوابها على نفسها، ووضعت حدودا ً لها بحواجز إدارات الهجرة والجمارك، وبثقافة جديدة تخلع كل قطر من هويته المغاربية والاسلامية، وسلمت بالكيانات القطرية، وصارت تنظر إلى مشروع المغرب الكبير على أنه مجرد تعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية دون التفكير في تنازل الدول عن أي شيء من سيادتها لحساب هيئة اتحادية مهما كانت هذه الهيئة مجردة من السلطات. وهي روح تختلف عن تلك التي سادت مؤتمر طنجة سنة 1958. وأسهم اختلاف الاستراتيجيات الاقتصادية في البلدان المغاربية في تهميش مشروع التكامل الاقتصادي الإقليمي خلال عقدي الستينيات والسبعينيات، وإلى تأجيج الصراعات الايديولوجية بين محوريه تونس والمغرب من جهة، مقابل الجزائر وليبيا من جهة أخرى. وأمام تفاقم الضغوطات الهائلة التي مارستها الأزمة الاقتصادية، والخوف المرتقب من تفاقم هذه الازمة عشية إلغاء الحواجز الاقتصادية، بين دول السوق الأوروبية المشتركة، سارعت دول المغرب العربي إلى تحقيق نوع من التقارب والتنسيق فيما بينها على صعيد المشاريع الاقتصادية. في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، والعزلة السياسية للأنظمة، بدأت السلطات الحاكمة في بلدان المغرب العربي البحث في بعث وتفعيل المشروع المغاربي من جديد في أواسط الثمانينيات، عبر تطويق مجالات الصراعات والتوترات التي تفرقها، والاتجاه نحو تطبيع العلاقات المغاربية – المغاربية. وقد توجت هذه المحاولات بعقد زعماء الدول المغاربية الخمس في مراكش في 17 شباط 1989، والتوقيع على معاهدة مراكش المؤسسة لاتحاد المغرب العربي، وتحديد البنيات السياسية لهذا الاتحاد. لقد شكل تأسيس الاتحاد المغاربي في 17 فبراير/شباط 1987 خطوة نوعية في مسار الوحدة المغاربية، وعقدت عدة آمال على ذلك، أقلها إيقاف الاستنزاف المتبادل بين أطراف المجال المغاربي، خصوصا أنه جاء بعد معاناة شعوبه ودوله من سياسات المحاور الثنائية المتصارعة على الزعامة طيلة عقدي السبعينيات والثمانينيات. وجاء تبلور هذا المشروع إفرازا لسلسلة تطورات نوعية في المنطقة، نجملها في خمسة عناصر: أولا ً، عودة العلاقات الدبلوماسية المغربية الجزائرية، بعد قطيعة دامت 14 سنة، وذلك على إثر لقاء العام 1988 بين الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد. وهذا التقارب أشار إلى تراخي قبضة المؤسسة العسكرية الجزائرية في توجيه السياسة الخارجية للجزائر. ثانيا ً، التفاهم على تسوية نزاع الصحراء المغربية في إطار خطة استفتاء بإشراف أممي، وجرى التفاوض على هذه الخطة طيلة 1988 ـ 1990. ثالثا ً، تراجع حدة الضغط الأجنبي على المنطقة والناجم عن التقاطب الدولي بين المعسكرين الشرقي والغربي بسبب بداية تفكك المعسكر الشرقي. رابعا ً، بروز تحدي التكتل الأوروبي في مواجهة دول الشمال الإفريقي. خامسا، فشل سياسات المحاور الثنائية وخصوصا بعد التجربة المرة لمحور المغرب ـ ليبيا في مقابل محور الجزائر – تونس ـ موريتانيا، والتي أدت لإضعاف كل الأطراف. وقد استمرت هذه العناصر تحكم مسيرة الاتحاد المغربي إلى غاية اللحظة، مع تغير في العنصر الثالث حيث استبدل عامل التقاطب الدولي شرق ـ غرب بالتقاطب الفرنسي ـ الامريكي، حيث أن الوضعية العامة للاتحاد المغاربي تتغير كلما عرفت هذه العناصر تغيرات وازنة، ولهذا سنجد عند تحليلها كيف أن جمود الاتحاد هو نتاج لتحول هذه العناصر إلى عناصر مضادة وسلبية في مشروع الوحدة المغاربية، وهو ما سنبينه لاحقاً، وذلك بعد بسط حيثيات المشروع المغاربي(2). وعقدت أول قمة للاتحاد المغاربي بعد المؤتمر التأسيسي في تونس بين 21 ـ 23 كانون الثاني يناير 1990، واتخذت عدة إجراءات مهمة بشأن التعاون في مجال الدفاع وتعزيز التعاون مع المجموعات الإقليمية العربية الأخرى والعلاقة مع السوق الأوروبية المشتركة الخ. .كما أصبح التعاون السياسي بين البلدان المغاربية الخمسة ممكنا ً عن طريق اتخاذ مواقف سياسية مشتركة حول مواضيع الساعة فضلاً عن قبول الزعماء المغاربة أن يكون واحد من بينهم يمثلهم على الصعيد الدولي. وجاءت قمة الجزائر التي عقدت في تموز/ يوليو 1990، بعد الفوز المدوي للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات البلدية، لتسجل بداية التراجع في ديناميكية الوحدة المغاربية. ومما لا شك فيه أن الأنظمة المغاربية تخوفت كثيرا ًُ من مشاهدة الإسلاميين يصلون ديمقراطياً إلى السلطة في الجزائر، باعتبار هذا الوصول في حال تحققه فعلياً سيكون لـه وقع كبير في كل منطقة المغرب العربي، لاسيما تونس، إذ إن حركة النهضة تحتل ما بين 20 ـ 30 % من الناخبين، وتطرح إقامة السلطة الإسلامية البديلة في تونس. وجاءت أزمة الخليج لتبين التنوع الكبير في مواقف الدول المغاربية الخمس المختلفة والمتعارضة أحياناً. ففي القمة العربية التي عقدت بالقاهرة اتخذت الدول المغاربية مواقف مختلفة حول قرار إدانة العراق،موريتانيا تحفظت، المغرب لمصلحة القرار، الجزائر تحفظت، تونس لا تشارك في القمة، ليبيا ضد القرار. في ظل هذا التنوع في المواقف المغاربية حول أزمة الخليج إضافة إلى نجاح الإسلاميين في الانتخابات البلدية في الجزائر، وما أظهرته من هوة عميقة تفصل الشعوب عن الأنظمة، واجه اتحاد المغرب العربي أول أزمة حقيقية. ومنذ الانقلاب العسكري الذي حصل في الجزائر مع بداية كانون الثاني 1992 بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وتدخل الجيش لإلغاء الانتخابات التشريعية، وإرغام الرئيس السابق الشاذلي بن جديد على الاستقالة، دخلت الجزائر في مرحلة الصراع المدمر بين النظام والمعارضة الإسلامية الأصولية. وكان لهذا الوضع المأساوي الذي استمر في الجزائر طيلة عقد التسعينيات من القرن الماضي، أثره الكبير في إبطاء وتيرة اجتماعات مجالس الرئاسة لاتحاد المغرب العربي، وهي مصدر القرار الرئيس، وبالتالي في إبطاء مركبة الوحدة المغاربية. وهكذا تعثر القطار المغاربي مع بداية الأزمة الجزائرية، وتفجر أزمة لوكربي بين ليبيا وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا والتي تطورت إلى فرض عقوبات دولية على ليبيا في عام 1992، بسبب انكفاء الأنظمة على أنفسها لحل مشكلاتها الداخلية، بدءاً من موريتانيا الغارقة في همومها السياسية والاقتصادية، مروراً بالجزائر التي تواجه حرباً أهلية طاحنة، وانتهاء بليبيا التي تطاردها أزمة لوكربي، والمغرب الذي ينشغل بأمور منها قضية الصحراء وأثرها المباشر في احتدام صراع المحاور الإقليمية بين المغرب والجزائر والموقع الذي احتلته في استراتيجية التطويق والمحاصرة لدى كل من البلدين. وكانت ليبيا قد رفضت المشاركة في الاجتماعات الوزارية للاتحاد في العام 1994 بسبب ما اعتبرته تقصيراً في إظهار التضامن معها بوجه العقوبات المسلطة عليها منذ العام 1992، إثر رفضها تسلم الرئاسة للاتحاد من الجزائر عام 1995، قبل رفع الحصار الظالم عنها. لكن الاتحاد تعطل منذ قمة 1994 مع انتقال الرئاسة الدورية إلى الجزائر التي تحتفظ بها، لأن الدول الخمس لم تتمكن منذ ذلك الحين من اللقاء على مستوى القمة، على الرغم من إن كلا ً منها لا يترك مناسبة من دون الإصرار على التمسك بالبناء المغاربي والاستعداد لإطلاق عمل هياكله قوية. صحيح أن مؤسسات تابعة للاتحاد كانت تجتمع بين فترة وأخرى، وحتى على مستوى وزاري، لكن الصحيح أيضاً أن هذه الاجتماعات كانت أقرب إلى الفولكلور من اللقاءات المثمرة. ثمة إجما ع على أن الجمود في الاتحاد المغاربي يعود أساساً إلى العلاقات الثنائية المتوترة بين دوله، أو تشكيل محاور ثنائية أو ثلاثية يعتبرها مَنْ هو خارجها موجهة ضده. وكان التوتر ينتقل من دولتين إلى دولتين أخريين، والمحاور تتشكل وتختفي بحسب الظروف السياسية، وحاجة هذا الطرف أو ذاك إلى دعم من طرف آخر تتلاقى مصلحتهما آنياً. لكن الثابت في كل هذه الشبكة من التوتر والتحالف، هو الخلاف الجزائري ـ المغربي على حل النزاع في الصحراء الغربية. فالجزائر تعتبر أن مصير المستعمرة الإسبانية السابقة من اختصاص الأمم المتحدة بوصفها "قضية تصفية استعمار"، والمغرب يتمسك بسيادته عليها كجزء لا يتجزأ من وحدته الترابية. إن الانهاك والتعب اللذين أصابا المجتمع الجزائري بسبب من تعمق أزمته الداخلية، وتدهور الوضع الأمني، ألقيا ظلالاً كثيفة على مسيرة الاتحاد المغاربي، لجهة اضطرار الجزائر التي تتولى رئاسة الاتحاد منذ أربع سنوات إلى الانكفاء على ذاتها لمعالجة أزمتها. والجزائر تظل قلب الجسد المغاربي، وأطرافه الأخرى موزعة بين المغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، وعندما يكون القلب مريضًا، ينعكس كليًا على باقي الجسم. فأصيب الاتحاد المغاربي بشكل تام وأصبحت هياكله خاوية بلا دماء تتدفق في شرايينها. واليوم، بعد 17 عاماً على ولادة الاتحاد، نجد انعدام التحرك الوحدوي حتى في المجال الاقتصادي. فلا منطقة التبادل الحر تأسست، ولا الوحدة الجمركية، ولا السوق المشتركة. وفي المقابل فإن المبادلات التجارية بين الدول الخمس المغاربية لا تتجاوز نسبة 3 في المئة من مجمل مبادلاتها الخارجية. في حين أن هذه النسبة تصل إلى 70 في المئة مع دول الاتحاد الأوروبي. ولو لم يتبادل قادة الأقطار المغاربية رسائل التهنئة بمناسبة حلول الذكرى 17 لتأسيس الاتحاد العتيد في 17 شباط 1989، لنسي الناس تماماً وجود مثل هذا المشروع المغاربي الذي بقي في مصاف الأماني، وفي مرتبة الأحلام.بقي شاهدان على ذلك اللقاء التاريخي بين زعماء الدول الخمس (المغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا) هما الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وقائد ثورة الفاتح العقيد معمر القذافي. الثلاثة الباقون رحلوا. واحد إلى رحمته تعالى (العاهل المغربي الحسن الثاني) والآخر إلى منزله بعد دفعه إلى الاستقالة مطلع العام 1992 (الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد)، والثالث إلى المنفى القطري بعد الاطاحة به في الصيف الماضي (الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيد أحمد الطايع).هؤلاء الخمسة كانوا على موعد يوم 17 شباط 1989 في مدينة مراكش المغربية لإعلان ولادة "اتحاد المغرب العربي"، قبل أن يستقلوا معاً سيارة "الكاديلاك" المكشوفة، فيعبرون بها شوارع عاصمة المرابطين، وسط الحفاوة الجماهيرية، مُتجهين إلى مسجد "القتبية" ليؤدوا معاً صلاة يوم الجمعة، على أمل أن تُكلّل البركة الالهية مسعاهم الحميد. يبقى أن مطلب الوحدة المغاربية أصبح اليوم مطلباً أميركياً... وأوروبياً... مُلحاً، للأسباب الأمنية والاقتصادية والسياسية المعروفة، التي يجهر بها يومياً دفق المبعوثين الذين يتوافدون على المنطقة... بلا انقطاع! 2 ـ العلاقات المغربية الجزائرية تبلورالإحباطات و على الرغم أن الجزائر والمغرب ينتميان إلى فضاء عربي – إسلامي واحد،هو العالم العربي، والأمة العربية، ولا ينفكان يتغنيان بالروابط المشتركة بينهما :اللغة العربية، والدين الإسلامي(المذهب المالكي)، والتاريخ المشترك منذ الفتح العربي ـ الإسلامي، والجغرافيا الواحدة، والعادات والتقاليد والخصائص النفسية المشتركة،و هي كلها عوامل لا تشجع على التطبيع وحسن الجوار بين البلدين فقط، بل إنها تشكل أساسا ً صلبا ً لأي وحدة اندماجية خالصة، فإنه ومنذ إستقلال الجزائر عام 1962 اتسمت العلاقات بين "البلدين الشقيقين" ـ بالعدائية في معظم مراحلها، وكانت دائما على حافة القطيعة باستثناء المرحلة الواقعة بين 1969 و1974. وقد ترجمت حالة العداء المستمرة هذه بالمواجهة العسكرية في تندوف عام 1963، وهي تضع البلدين منذ عام 1975 على حافة المجابهة حول مسألة الصحراء الغربية. ويعود أساس هذا التناقض بين فعل الإيمان بالوحدة والعدائية في واقع العلاقات إلى النمط السلطوي في شرعنة الحكم السائد في كلا البلدين. بالنسبة للنظام المغربي يشكل استمرار الملكية محوراً استراتيجيا ًتعطى لـه الأولوية. وبالنسبة للجزائر، وأقله حتى غياب هواري بومدين عام 1978، فالثورة مهددة بالفشل إذا كانت ستتوقف عند الحدود المغربية.و ما كثبان الرمل ومساحات الأرض في تندوف عام 1963 أو في الصحراء الغربية منذ 1975 سوى ذرائع للمنافسة بين النظامين اللذين يرى كل منهما في الآخر تهديدا ً لـه. وكان دفاع الملكية عن نفسها إزاء معارضة الأحزاب اليسارية لها في الستينيات تماهيها مع المغرب الأبدي ومصيره. أما الجزائر فقد ادعى نظامها شرعية ثورية أعاق مشروعها التحرري التحالفات التي عقدها المغرب الجار مع مع الدول الغربية(3). ويقول الدكتور عبد الهادي بوطالب وزير الخارجية المغربي السابق عن بدايات العلاقات المغربية – الجزائرية، إنها كانت تبشر بمستقبل مغاير لما شهدناه طيله العقود الماضية :ابتدأت شهور العسل حيث قام الملك الحسن الثاني بزيارة مودة وتكريم وتهنئة إلى حكومة الجزائر الأولى بعد الاستقلال التي كان على رأسها الرئيس أحمد بن بلّه، واصطحب معه وفدا وزاريا كنت أحد أعضائه بوصفي وزيرا ً للإعلام. وعن كثب شاهدت وعشت جو المودة والصفاء الذي ساد الزيارة الملكية، وأضفى عليه الرئيس الجزائري حلة الابتهاج بمقدم الوفد المغربي الذي جاء حاملا لهدايا سلاح متنوع ثقيل وخفيف إلى الجزائر الشقيقة، و23 سيارة مرسيدس مهداة من ملك المغرب إلى وزراء الحكومة الجزائرية البالغ عددهم 23 وزيرا ً. وقد عبر الملك الحسن الثاني للرئيس الجزائري عن تمنياته الشخصية وتهاني المغرب باستقلال الجزائر، وقال عنه إنه امتداد لاستقلال المغرب، ووضع جميع إمكانات المغرب المستقل في خدمة تعزيز استقلال الجزائر، مؤكدا ً على أن الدعم المغربي للجزائر المستقلة سيكون امتدادا ً لدعمه لقضية تحررها من الاستعمار الفرنسي الذي أسهم فيه المغرب بسخاء. ورد عليه الرئيس الجزائري منوها بما قدمه المغرب للجزائر من دعم مادي وسند معنوي لتحقيق تحرر الجزائر من الاستعمار. وقد كانت أغلبية الوزراء الجزائريين قضت في المغرب فترة المنفى، ولقيت دعم المغرب وسنده بلا قيد أو شرط، ما جعل من مدينة وجدة المغربية طيلة سنوات الكفاح الجزائري بالأخص الواجهة الثانية للتحرير. خلال هذه الزيارة قبل الملك الحسن الثاني طلب الرئيس أحمد بن بلّه أن ترجئ الجزائر إعادة التراب المغربي الممتد على حدوده الشرقية مع الجزائر الذي كانت اقتطعته فرنسا من المغرب وضمته إلى التراب الجزائري الواقع تحت احتلالها في نطاق سياستها الاستعمارية التي كانت تعتبر الجزائر جزءاً منها لا يتجزأ، وكانت تطلِق على الجزائر اسم المقاطعات الفرنسية الثلاث. ولم تكن الجزائر تنازع في مغربية هذا الجزء، لكن الرئيس بن بلّه طلب إلى المغرب أن يرجى تسليمه إلى المغرب بعد أن تنهي الجزائر إقامة بنياتها الأساسية. ووافق الملك على هذا الإرجاء المؤقت، إذ كان الأهم هو أن يجدد الرئيس الجزائري لملك المغرب قبوله إعادة الأراضي المغربية المغتصبة من لدن الاستعمار الفرنسي إلى صاحبها (المغرب). [/align] |
|
|
|

|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [7] | |
|
كاتب نور أدبي ينشط
  
|
رد: اتحاد المغرب العربي بين الإحياء والتأجيل ـــ توفيق المديني - دراسة تاريخية سياسية
[align=justify]لكن شهر العسل هذا لم يطل إلا قليلا باندلاع حرب الرمال بين البلدين، وذلك بعد عودة الملك الحسن الثاني إلى المغرب، وعلى إثر مناوشات بين الجيشين الجزائري والمغربي. وجرت وقائع الحرب فوق الأراضي المغربية المغتصبة التي كانت ضمنها منطقة تندوف التي تؤوي اليوم الجزائر فوقها جماعة البوليساريو المتمرد ة على وطنه، وتدعمه وتسلّحه وتموّله.
وعرفت العلاقات جو الصفاء والتقارب بعد الانقلاب الذي أجراه العقيد هواري بومدين وزير الدفاع في حكومة الرئيس الجزائري بن بلّه وأطاح فيه بحكمه. وتأسست نواة اتحاد المغرب العربي على قاعدة اقتصادية، وحرص العقيد بومدين على أن يكون التعاون المغربي حلقة أساسية في المؤسسة الاقتصادية. لكن الجزائر أصبحت بعد سنوات من التجربة تعلن أنها تفضل اتحاد الشعوب على اتحاد النظم. وبذلك تعثرت مسيرة العمل المغاربي. وفي هذه الأثناء انعقدت في السابع من آيار/مايو1970 قمة تلمسان بين المغرب والجزائر، وحضرتها بوصفي وزير خارجية المغرب ضمن الوفد الذي رافق الملك الحسن الثاني. وفي هذه القمة صُفيت قضية الأراضي المغربية التي اغتصبتها فرنسا وضمتها إلى التراب الجزائري، وذلك بقبول المغرب التنازل عن هذه الأراضي لفائدة الشقيقة الجزائر. وسجل الاتفاق وصول الطرفين إلى وفاق لإقامة شراكة ثنائية في منجم غارة جبيلات الواقع في التراب المغربي المتنازَل عنه للجزائر، على أن يؤمّن المغرب للجزائر المرور عبر سكة حديدية لنقل إنتاج المنجم من ميناء مغربي على المحيط الأطلسي لتصديره وتسويقه. ولم تنفذ الجزائر للمغرب التزاماتها، ولم يلحّ المغرب على الجزائر للوفاء بوعدها، مفضلا ً ألا يثير مع الجزائر ما من شأنه أن يعكر الجو السياسي بين الجارتين. وأثناء انعقاد القمة العربية في المغرب أعلن الرئيس هواري بومدين أمام القادة العرب أن الجزائر تساند المغرب في مطلبه استرجاع الصحراء المغربية، وأنها لا طمع لها فيها، وأنها تؤيد بشأنها ما يتفق عليه الطرفان المعنيان: المغرب وموريتانيا، وأنها على استعداد لتقديم سند عسكري للمغرب من أجل تحرير الصحراء ومدينتي سبتة ومليلية من الاستعمار الإسباني. بيد أن العلاقات دخلت في أزمة كبرى امتدت إلى اليوم بعد تحرير المغرب أقاليمه الصحراوية بالمسيرة الخضراء وإبرام المعاهدة الثلاثية مع إسبانيا في مدريد، إذ ظهرت الجزائر كاشفة عن وجهها لتعلن أن المغرب لا حق لـه في الصحراء التي ينازع في مغربيتها جماعة "البوليساريو" المتمردة. كما طالبت ـ ولا تزال ـ بتخويل الشعب الصحراوي (أي شعب ؟) حق تقرير المصير. وتبنت الدفاع عن مطلب البوليساريو لدى هيئة الأمم المتحدة، وأصبحت الناطق باسمه في المحافل الدولية. وهو ما حوّل أزمة العلاقات إلى قطيعة مستمرة، وشلّ مسيرة الاتحاد المغاربي، وأصبح انعقاد مؤسساته مستحيلا في جو مواجهة الجزائر لحق المغرب في استرجاع صحرائه، وهو المطلب الوطني الذي ينعقد عليه الإجماع المغربي. وبالرغم من زيارة الملك محمد السادس للجزائر مرتين، وعرضه على الرئيس بوتفليقة تحييد دعم البوليساريو، ووضع هذا الملف على الرف ولو مؤقتا، وبالرغم من فتح المغرب الحدود، وإلغاء التأشيرة بالنسبة للمواطنين الجزائريين، فإن الجزائر لم تجب على التحيات المغربية إلا بقبلات مسرحية كان يتقن الرئيس بوتفليقة إطالتها على وجه شقيقه المغربي. ولا يزيد الأمر على ذلك(4). ومنذ رحيل الاستعمار الفرنسي عن أرض الجزائر، لم يشهد تاريخ العلاقات بين الدول المغاربية سوى تراكم العقبات التي تعترض سبيل بناء وحدة المغرب العربي، إلى درجة أنه يمكن القول أن سد هذه العقبات أصبح يحجب أطول الأعناق عن التمتع بالنظر إلى حلم الوحدة المغاربية، أهمها قضية الصحراء وهي محل خلاف بين المغرب والجزائر. ولكي تنجلي الصورة أكثر لا بد من العودة للوراء قليلا حتى نعرف طبيعة المشكلات بين دول الاتحاد التي خرجت من الصراع مع المستعمر لتدخل في صراع مع بعضها مبكرا ً، فبعد سنة واحدة من استقلاله شكّل المغرب جيشا ًَ لتحرير موريتانيا كان من أشهر معاركه معركة "تكل"، وفي سنة 1960 حصلت موريتانيا على استقلالها، وهو ما رفضه المغرب ودشن أول صفحة خلافات بينه وبين تونس التي اعترفت بموريتانيا، ثم بعد سنة واحدة من استقلالها 1962 اندلعت الحرب سنة 1963 بين المغرب والجزائر على الحدود. ورغم أن الحرب استمرت لفترة قصيرة توجت باتفاقية إلا أن البرلمان المغربي لم يصادق على تلك الاتفاقية حتى الآن. وقد دشُن في هذه الفترة المبكرة صراع على الزعامة في المنطقة بين المغرب والجزائر أصبحت فيه دول الاتحاد الأخرى تتبادل الدوران في فلك كل منهما لفترة حسب المصالح والظروف، فقد ساءت العلاقات بين بورقيبة وبومدين ثم دخل القذافي على الخط سنة 1969 بعد دعمه للمحاولة الانقلابية التي جرت ضد الحسن الثاني سنة 1971 لتظل العلاقات بين الدولتين سيئة ثم جاء النزاع على الحدود بين ليبيا والجزائر. واستمرت المنغصات إلى أن جاء ما يسميه الجميع بكارثة الصحراء الغربية سنة 1975 لينقسم المغرب العربي إلى محورين: محور المغرب ـ موريتانيا ومحور الجزائر ـ ليبيا اللتين تدعمان استقلال الصحراء الغربية، ورغم أن موريتانيا خرجت من الصراع المباشر سنة 1979 بتخليها عن حقوقها في الصحراء مقابل السلام فإنها لم تفلح بالنأي بنفسها عن ذلك النزاع. كما لم تتمكن "ثورية" القذافي من التعايش مع معظم طبيعة أنظمة دول الاتحاد. كما أن العلاقات بين الأخوين اللدودين في المغرب العربي، الجزائر والمغرب، لم تعرف حالة من التطبيع الكامل، بل إن العلاقات بين البلدين عرفت مراحل من المد والجزر لا ينتهيان. علما أن التطبيع الكامل بين المغرب والجزائر يمثل شرطاً أساسياً من شروط النهوض باتحاد المغرب العربي، ومطلباً دولياً يجتمع عليه الموفدون عبر المتوسط وعبر الأطلسي. و يقدّم الصحافي المغربي محمد الأشهب سرداً تاريخياً للعلاقات بين البلدين الجارين وتفاصيل الخلافات بينهما(5): في إحدى زياراته القليلة الى الجزائر بعد تولي العاهل المغربي الملك محمد السادس مقاليد الحكم في 1999، سمع مسؤول مغربي كلاماً من مراجع جزائرية عليا مفاده أن المغرب أخطأ في اختيار حليفه في منطقة شمال افريقيا. وجاء الكلام في صيغة عتاب "تعاونتم مع الضعيف وتركتم القوي" في إشارة الى التنسيق الذي ساد الخطوات الأولى لضم الصحراء بين المغرب وموريتانيا. وقتها رد المسؤول المغربي باستحضار وقائع اجتماع تاريخي ضم كلاً من الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين والرئيس الموريتاني الراحل المختار ولد داده في المدينة السياحية أغادير على الساحل الأطلسي للمغرب. ونقل فيه القول عن بومدين ان "لا مطامع للجزائر في الصحراء" وأنه يدعم أي تنسيق بين الأطراف المعنية في مواجهة قرار إسبانيا وقتذاك منح حكم ذاتي لسكان الساقية الحمراء ووادي الذهب، يبقيها تحت سيطرة مدريد. وزاد المسؤول المغربي أن الجزائر أقرت صراحة في القمة العربية التي استضافتها الرباط عام 1974 ان "لا مشكلة بينها وبين المغرب في قضية الصحراء". ويحتفظ المغاربة بتسجيل صوتي للرئيس بومدين بهذا المعنى يقول فيه باللهجة المصرية "بين المغرب والجزائر مافيش مشكل". لكن الموضوع سيرتدي طابعاً آخر بعد صدور الحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول وجود روابط "بيعة وولاء" بين سكان الإقليم والسلطة المركزية في الرباط. وفي الوقت الذي عمدت فيه إسبانيا إلى استمالة شبان يتحدرون من أصول صحراوية لتأسيس جبهة "بوليساريو" إلى جانب بعض الأحزاب السياسية الموالية لإسبانيا على طريق اكتمال خطة الحكم الذاتي الذي رهنته بموافقة "الجماعة الصحراوية" ـ أي البرلمان الصحراوي وقتذاك ـ كانت الجزائر تعمل بتنسيق مع الإسبان لتأمين هجرة مضادة لسكان الصحراء نحو مراكز تيندوف جنوب غربي الجزائر، إذ تزامنت عمليات الهجرة مع دخول القوات المغربية في شباط (فبراير) 1976 إلى الصحراء على خلفية انسحاب القوات الاسبانية منها. لكن الرد الجزائري كان أكثر عنفاً من خلال الإعلان عن تأسيس "الجمهورية الصحراوية" من طرف واحد، ما حدا بالمغرب إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع الجزائر. وإذ يقول الرسميون الجزائريون إن توغل قوات عسكرية جزائرية في منطقة "أمفالا" القريبة شرقاً إلى تيندوف كان بهدف تقديم المواد الغذائية والأدوية للاجئين الصحراويين، تشير وقائع مواجهتين عسكريتين في المنطقة ذاتها إلى معطيات أخرى، هي نفسها التي ستتكرر في منطقة الداخلة جنوب المحافظات الصحراوية عندما توجهت قوات من مقاتلي "بوليساريو" (تحت قيادة جزائرية) إلى هناك بهدف فرض السيطرة على الإقليم إثر انسحاب موريتانيا عام 1979، حين قتل زعيم الجبهة الوالي مصطفى. ويقول رسميون مغاربة إن قادة بعض الدول العربية تدخلوا عام 1976، وفي مقدمهم الرئيس المصري حسني مبارك، وكان وقتذاك نائب الرئيس أنور السادات، لإطلاق الأسرى الجزائريين المعتقلين في مواجهتي "أمفالا" في مقابل حدوث انفراج بين المغرب والجزائر. بيد أن قمة يتيمة على الأقل جرى البحث في تنظيمها لتجمع الحسن الثاني وبومدين في بروكسيل عام 1979 لم يكتب لها الالتئام، رغم تحديد موعد أولي كان تصادف واحتفالات المغرب بعيد الشباب. وتعرض بومدين بعد ذلك إلى أزمة صحية نُقل على أثرها إلى موسكو ليعود منها في غيبوبة كاملة. احتاج الأمر، في غضون ذلك، إلى حوالي أربع سنوات لعقد القمة الأولى بين الملك الحسن الثاني والرئيس الشاذلي بن جديد الذي قال عنه الملك الراحل يوماً "لقد أجبر على تولي رئاسة الجزائر"، غير أنه وجد فيه محاوراً أعاد ملف العلاقات المغربية ـ الجزائرية إلى الواجهة من خلال حدثين، أولهما تجديد العمل باتفاق ترسيم الحدود ضمن معاهدة حسن الجوار المبرمة بين البلدين عندما اجتمع إلى الملك الحسن الثاني في المنتجع الشتوي في ايفران عام 1988، والثاني اجتماع العاهل المغربي إلى قياديين في جبهة "بوليساريو" للمرة الأولى في مراكش في حضور الرجل الثاني في الجبهة بشير مصطفى السيد، ما مهد الطريق أمام انعقاد القمة التأسيسية للاتحاد المغاربي في مراكش في شباط (فبراير) 1989. لكن الاختراق على صعيد تحسين العلاقات الثنائية وبدء التعاون المغاربي انطلق قبل ذلك بمعاودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، لم يعمر طويلاً نتيجة استقالة الرئيس بن جديد تحت ضغط الأزمة الداخلية في بلاده الناتجة أصلا عن ظهور جبهة الانقاذ الجزائرية التي اكتسحت انتخابات البلديات وتعطيل المسار الانتخابي عام 1992. وقتها أسرّ زعيم "الانقاذ" عباسي مدني إلى صحيفة "الحياة" أنه يدعم التقارب بين المغرب والجزائر ولا يرى حلاً لقضية الصحراء خارج السيادة المغربية. وحرص الملك الحسن الثاني لدى زيارته الجزائر وقتذاك على الاجتماع إلى زعماء الأحزاب السياسية الجزائرية. لكن الموقف الذي التزمه عباسي مدني سيجد امتداده في التصريحات الصادرة عن مراجع مغربية حول إمكان الإفادة من دور جبهة الإنقاذ الجزائرية في دعم الخيار الديموقراطي، وبالقدر نفسه سيتحول الخلاف حول التعاطي مع الظاهرة الإسلامية إلى سبب آخر يعطل الانفراج في علاقات البلدين. وفي الوقت الذي بدأ فيه حوار مغربي ـ جزائري من نوع آخر على خلفية المسألة الإسلامية متمثلاً في طلبات جزائرية لتسليم معارضين إسلاميين في مقدمهم الناشط عبدالحق العيادة (أمير الجماعة الإسلامية المسلحة)، دار على واجهة أخرى حوار بين المؤسسة العسكرية الجزائرية والمعارض الجزائري محمد بوضياف الذي كان يقيم في مدينة القنيطرة المغربية ويدير مصنعاً للبناء، وقد حرص لدى مغادرته المغرب ليصبح رئيساً للجزائر يتمتع بالشرعية التاريخية، على تأكيد التزامه إيجاد حل سريع لنزاع الصحراء. غير أن الرصاص الذي صوب نحوه في قاعة اجتماع في عنابة في حزيران (يونيو) 1992، طالت شظاياه العلاقات بين البلدين. ولم تكد تمر شهور حتى اندلعت أزمة حادة بين الجارين، إذ تورط رعايا من أصول جزائرية ومغربية في هجمات فندق أطلس أسني في مراكش التي انعكست تداعياتها سلباً على علاقات البلدين عام 1994. فقد فرض المغاربة نظام التأشيرة على الرعايا الجزائريين وردت الجزائر بالمثل، وزادت عليها قرار إغلاق الحدود البرية في صيف 1994. عندما توفي الملك الحسن الثاني في تموز عام 1999، انتقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتخب حديثاً في هذه المناسبة إلى الرباط، حيث تكلم بحرارة عن مستقبل العلاقات بين البلدين، قابله استعداد مماثل من الملك الشاب محمد السادس لبدء عهد جديد مع الجزائر.و اعتقد الجميع أن مناخاً دافئاً جديداً من العلاقات بين البلدين سيستمر، بيد أنه في اليوم الذي أعلن فيه فتح الحدود البرية الذي تحدد موعده في 20آب1999، حصلت مجزرة رهيبة راح ضحيتها 36 مدنياً على يد الجماعة الإسلامية المسلحة التي تقول الجزائر أن لها قواعد خلفية في المغرب.فتبخرت كل الأمال التي كانت معلقة على معاودة التطبيع بين المغرب والجزائر من جديد. فماهي العوائق البنيوية التي حالت ولا تزال تحول دون التطبيع الكامل؟ 1 ـ لقد ورثت البلدان المغاربية الثلاثة (تونس، الجزائر، المغرب) حدوداً متفجرة، بفعل التقسيم الكولونيالي الفرنسي ـ الإسباني لهذا الجزء الغربي من العالم العربي. وكانت فرنسا القوة الاستعمارية السائدة تعتقد أن الجزائر أصبحت جزءا من إمبراطوريتها، لذا راحت تقضم من الأراضي التونسية والمغربية لضمها إليها. وهذا ما جعل المغرب والجزائر يتواجهان عسكرياً في حرب تندوف الصحراوية عام 1963.كما أن هذا الموروث من التقسيم الكولونيالي وضع البلدين على حافة المواجهة العسكرية حول مسألة الصحراء الغربية عام 1975. 2 ـ إن الثورة الوطنية التحررية الجزائرية ضد الكولونيالية الفرنسية لم تمتد لتشمل توحيد أقطار المغرب العربي، بل حافظت على التقسيم الكولونيالي الموروث هذا، وسعت إلى بناء دولة قطرية تسلطية، لا إلى بناء دولة وطنية هي في الجوهرديمقراطية وأساس التحول إلى دولة قومية.. فكان مصير الثورة الجزائرية الإخفاق التام لأ ن مشروعها التحرري توقف عند الحدود التي رسمها الإستعمارالفرنسي، وأصبحت تدافع عنها بوصفها حقائق تاريخية أبدية. 3 ـ كانت الدولة الملكية المغربية تعتبر نفسها مركزية وعريقة وتاريخية، لذا كانت أولويتها الإستراتيجية تتمثل في الدفاع عن نفسها إزاء معارضة الأحزاب اليسارية لها في الستينيات، والشرعية الثورية لجارتها الجزائر، تماهيها مع المغرب الملكي الأبدي ومصيره ومنعت الملكية المغربية بعد ضم الصحراء الغربية من بروز بومدين مغربي جديد معاد للدولة المخزنية، كما أنها جعلت كل أحزاب المعارضة اليسارية تصطف على أرضية الخط السياسي للملك. 4 ـ وعلى الجانب الآخر، يمثل تشابك المسألة الصحراوية وتعقيداتها الصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب، ويعود أساس التناقض بين فعل الإيمان بالوحدة المغاربية، والعدائية في واقع العلاقات بين البلدين إلى النمط السلطوي في شرعنة الحكم السائد في كلا البلدين. ففي المغرب والجزائرمعاً تحول استغلال الشعور الوطني إلى سلاح سياسي في الصراع على السلطة. وهنا تكمن صعوبة إيجاد حل في نزاع الصحراء الغربية خارج نطاق المشروع القومي الديمقراطي الوحدوي. فبالنسبة للدولة المغربية تعتبر أي تنازل في قضية الصحراء يقود إلى خسارتها، سيعني سقوط العرش. وبالنسبة للنظام الجزائري، فإن المزايدة الوطنية "حول تقرير المصير في الصحراء الغربية"، تشكل عنصراً من عناصر بقاء الدولة التسلطية. وقد حول كل من الجزائر والمغرب قضية الصحراء الغربية بفعل هذه المزايدة الوطنية إلى قضية أكبر من فلسطين. علما أن الدولتين لا تبديان أية معارضة ولو شكلية إزاء المخطط الأمريكي الصهيوني لتصفية فلسطين. 3 ـ القمة المغاربية من إخفاق إلى إخفاق عجز قادة اتحاد المغرب العربي مرة أخرى عن عقد قمتهم في طرابلس. وفيما كان القادة المغاربيون يستعدون جميعا للذهاب إلى العاصمة الليبية بعد 12 عاما من دون قمة تجمع قادة دول الاتحاد الخمس (موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا)، وبعد أن أخفقوا في الالتقاء في الجزائر عام 2003 لأول مرة بعد آخر قمة جمعتهم في تونس عام 1994، وهي القمة اليتيمة منذ قيام الاتحاد عام 1989، جاءت رسالة التهنئة التي بعث بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى زعيم جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس جبهة البوليساريو، لتصب الزيت على النار، عندما جدد موقفه التقليدي بدعم حركة البوليساريو، الأمر الذي أدى إلى رد فعل طبيعي من المغرب، لجهة اعتذار الملك محمد السادس عن المشاركة في قمة طرابلس. غير أن هذا التوجه نحو التطبيع بين الجزائر والمغرب، وفتح حدود البلدين لمرور الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال، تعرض لانتكاسة، بسبب ما وصفته الرباط بانحياز الجزائر ضد المصلحة العليا للمغرب، كما أن وصف جبهة البوليساريو بأنها حركة تحرير اعتبرته الحكومة المغربية تجاهلاً لأغلبية الصحراويين المتشبثين بانتمائهم إلى المغرب.وما كان لذلك الاستعداد أن يتم أصلا لولا أن اللقاء الذي جمع العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر علي هامش القمة العربية الأخيرة في آذار (مارس) 2005،مهد السبيل لإعادة إحياء مؤسسة القمة التي تكلست لا سيما منذ إعلان الرباط عام 1995 تعليق مشاركتها في هياكل الاتحاد. هل "اتحاد المغرب العربي" لقيط إلى درجة أن أحداً لم يعد يريد تحمّل تبعات أبوته؟ هذا هو على كل حال الانطباع الذي يخرج به المتابع لقرار ليبيا الأخير تخليها عن رئاسة الاتحاد العتيد بسبب "تعثر مسيرته"، وتركت "موضوعه" لكي تبت به "الشعوب"، على اعتبار أنها صاحبة الكلمة الفصل في المسألة. وكانت الجزائر قبل ذلك قد تنفست الصعداء عندما قرر الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية المغاربيين الذي استضافته قبل نهاية العام الماضي، إسناد رئاسة الاتحاد إلى ليبيا، وإنزال هذا الهم عن كاهلها. كان الظن أن الجماهيرية هي الأقدر على لمّ الشمل المغاربي، لاسيما أن مسؤولياتها الجديدة تزامنت مع انخراطها المفاجئ في معسكر الخير، وصرفها مليارات الدولارات لتعويض الضحايا الغربيين في الاعتداءات التي اتهمت بها أجهزتها أيام "الثورة العالمية". واعتبرت طرابلس حينها الأقدر على محاورة الفرقاء كلهم. وكان العقيد القذافي هو وحده من بين القادة المغاربيين من هنّأ العاهل المغربي محمد السادس في ذكرى المسيرة الخضراء لضم المحافظات الصحراوية في تشرين الثاني المنصرم، بعد أن كانت الجماهيرية في زمن مضى مصدر التمويل والتسليح الداعم الأساسي لجبهة البوليساريو. لكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفن "الاتحاد" مرة أخرى، فإضافة إلى موضوع الصحراء الغربية الذي شكّل حتى الآن العقبة الكأداء في رص الصفوف المغربية، وإزالة الجفاء في علاقات المغرب بالجزائر، برزت عقدة جديدة تمثلت في تدهور العلاقات الليبية ـ الموريتانية بعد توجيه اتهامات موريتانية إلى طرابلس بالوقوف وراء المحاولات الانقلابية التي تعاقبت على نواكشوط في الأشهر الماضية. وكانت تلك الاتهامات قد صدرت عن الرئيس الموريتاني نفسه معاوية ولد سيد أحمد الطايع في منتصف تشرين الأول الماضي، وطالت بوركينا فاسو إضافة إلى ليبيا(6). وقد سعى الزعيم الليبي معمر القذافي جاهداً إلى إعادة وضع بلاده المنتجة للنفط على الخريطة الدولية بعد أن تخلت ليبيا عن برامج أسلحة الدمار الشامل، من خلال جمع زعماء اتحاد المغرب العربي في طرابلس، لكي يعزز من موقفه كصانع للسلام في إفريقيا. وكان بوتفليقة قد أخفق في عقد قمة للاتحاد المغاربي عام 2003. لقد كانت الآمال معقودة على قمة طرابلس التي دعا إليها الزعيم الليبي وعمل لها طويلا، لاسيما بعد نجاح مساعيه في عقد القمة الأفريقية المصغرة حول دارفور، وما صدر عنها من نتائج إيجابية مشجعة. وبدا أن كل الأمور تسير على ما يرام، حتى أنه تم التوافق على استبعاد قضية الصحراء الغربية من جدول الأعمال تجنباً لأي توتر أو اضطراب مغربي ـ جزائري. كما تم التوافق على حصر جدول الأعمال في قضايا التعاون بين الدول الخمس سواء لجهة علاقاتها جنوباً مع إفريقيا أو شمالاً مع أوروبا، وخاصة لجهة تعاونها المتبادل في الميادين الاقتصادية والمالية والسياحية والتنموية. السبب وراء كل هذا التأجيل والإلغاء واحد ومعروف وهو الذي يطل دائماً برأسه ليكون وراء التجميد أو التأجيل أو الإلغاء: نزاع الصحراء الغربية القائم منذ 1975 والذي فشلت الأمم المتحدة في حله،و الذي أدى إلى تردي العلاقات بين دول المغرب العربي طيلة العقود الثلاثة الماضية،و إلى تقويض الاستقرار في المنطقة التي يراقبها الغرب عن كثب بوصفها مصدرًا محتملاً للتيار الإسلامي المتشدد ونقطة وثوبٍ بالنسبة إلى الهجرة غير المشروعة إلى القارة الأوروبية.فضلا عن أن تجاهل قضية الصحراء الغربية سيلحق الضرر بالتكامل الإقليمي. والحال هذه، فإن تأجيل قمة طرابلس المجهضة إلي أجل غير مسّمى لن يسهم إلا في مزيد من الاستخفاف باتحاد لم ير الناس منه منفعةً واحدةً في وقت تخسر فيه دوله سنويا 10 مليارات دولار بسبب انعدام التعاون بينها في مواجهة أوروبا واحدة تزداد اتساعاً وقوة فيما تزداد الضفة الجنوبية للمتوسط تفككا وتبديداً للجهد والوقت. ما لم ينجح في تحقيقه "اتحاد المغرب العربي" العصيّ على الانعقاد منذ أكثر من عشر سنوات، وما لم تنجح في تحقيقه اللجان المشتركة، والاتفاقات الثنائية، والزيارات المتبادلة، نجحت في اتخاذه الحركات المسلّحة في دول المغرب العربي الخمس التي أصبحت على قدر كبير من التنسيق والتعاون وشنّ الهجمات وتبادل "الخبرات" ورصّ الصفوف من بنغازي إلى نواكشوط. فقد تحوّلت الساحة المغاربية بأكملها مع امتدادها في الساحل الصحراوي وجنوب الصحراء الكبرى، إلى ساحة مواجهة جديدة بين "القاعدة" وامتداداتها المحلية، وبين الأنظمة القائمة وانخراط الولايات المتحدة في دعمها. قصب السبق في هذا التحول الجديد يعود إلى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، الجزائرية التي عوّضت عن انحسار نشاطها داخل البلاد، والانشقاقات التي تعصف بها بعد التحاق "أميرها" السابق حسّان حطّاب بركب المصالحة والوئام، بامتدادات أُفقية عابرة للحدود. وأصبح من الممكن الربط بين ما تقوم به، وما قامت به "الجماعة الإسلامية للمقاتلين المغاربة" التي نفّذت اعتداءات الدار البيضاء في أيار 2003، وبين محاولة اغتيال العقيد معمّر القذافي في بنغازي في الفترة ذاتها. فقد أصبحت أجهزة الاستخبارات في الدول المعنية على قناعة أن صلات وثيقة تمت إقامتها بين الحركات المختلفة خلال وجودهم في "الجهاد الأفغاني". لا بل إن المشرف على المخابرات المغربية الجنرال حميدو لعانيق ري، يرى أن "المقاتلين" المغاربة جرى تكوينهم وتدريبهم على يد الجماعة الليبية.وجاء إلقاء القبض في آذار الماضي في الجزائر على عشرة أعضاء في "الجبهة الإسلامية التونسية" ليؤكد عمق العلاقات بين التنظيمات في المنطقة، إذ تكوّنت قناعة أن هؤلاء كانوا في طريقهم إلى معسكرات "الجماعة السلفية" الجزائرية لتلقي التدريبات على يد مُدرّبين "أفغان"، وأنهم كانوا ينوون العودة الى تونس بعد ذلك لشن هجمات ضد مصالح ومؤسسات غربية، الأمر الذي يُفسّر التحذير الصادر عن الإدارة الأميركية الى رعاياها بعدم التوجه إلى تونس(7). 4 ـ مكافحة الإرهاب تمهد السيطرة الأمريكية على المغرب العربي من دون حرب إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية تعتبر الوجود الفرنسي داخل شمال إفريقيا عقب الحرب العالمية الثانية ضمانة حقيقية تقف في وجه المد السوفياتي الداعم لحركات التحرر الوطنية الإفريقية والأنظمة الوطنية التقدمية في وقت حاولت باريس الاستفادة من هذا الوجود في حمى الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي، فإنه في الظروف الراهنة أصبحت واشنطن حاضرة بقوة على الساحة المغاربية، وترسم خطوط سياستها بدقة لضمان هيمنتها الأحادية، كما ظهر في كثير من القضايا، لعل آخرها تراجع الدور الفرنسي في منطقة المغرب العربي، وإعادة توزيع الأدوار فيها لمصلحة الولايات المتحدة. اهتمام واشنطن بإفريقيا عامة، وشمال إفريقيا خاصة، لم يكن وليد اليوم، بل كان خطة قديمة، تبلورت ملامحها من حيث القدرة على التجسيد واقعيًا منذ نجحت الإدارة الأمريكية في خلق الاختلاف العميق بينها وبين فرنسا (الدولة الكلونيالية في إفريقيا). وكان التهديد لأول مرة على لسان "بول ولفويتز" بتاريخ 04 تشرين الأول/أكتوبر من سنة 2003 حين تكلم لأول مرة عن ضرورة التواجد في القارة الإفريقية، في كلمته التي أدلى بها بمناسبة الاحتفاء بما يسمى بجهاز الأمن القومي الأمريكي الذي كان نتاجًا "عسكرياً ومخابراتياً" تجسد بشكل ملموس منذ وصول المحافظين الجدد إلى البيت الأبيض عام 2001. وإن كان الاختلاف الذي فجره قرار إدارة بوش بضرب العراق قد فجر آليا جبهة معارضة للحرب، إذتحولت أيضا "الحرب الباردة" بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى حرب معلنة في المناطق التي تحتكرها الكولونيالية الفرنسية، في إفريقيا وآسيا الشرقية أيضا. فرنسا التي ظلت تتكلم عن إفريقيا أنها "مستوطناتها القديمة" وجدت نفسها أمام "صراع من نوع آخر" فرضته الاستراتيجية الأمريكية في الهيمنة على العديد من الدول الإفريقية، وبالتالي إصرار أمريكا على التواجد في الشمال الإفريقي ظل هو نفسه الهدف الاستراتيجي الذي على أساسه تكلم "دونالد رامسفيلد" بعد سقوط بغداد في ندوة صحفية جمعته بالمستشار الألماني في العاصمة الألمانية "برلين" حين قال بلهجة حربية موجها كلامه للفرنسيين: " لولا أمريكا لكانت فرنسا تتكلم اليوم بالألمانية !". وهي الجملة التي أزعجت الفرنسيين والألمان على حد سواء، لاسيما وأن رامسفيلد ذهب إلى حد التهديد بطريقته أنه سيكون لأمريكا الحق في الذهاب بعيدا لأجل "الدفاع عن الحريات والديمقراطية"، وكان الهدف من وقتها " المغارة الفرنسية" حسب جريدة "الواشنطن بوست" في عددها الصادر يوم 22كانون الاول/ديسمبر2003(8). [/align] |
|
|
|

|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [8] | |
|
كاتب نور أدبي ينشط
  
|
رد: اتحاد المغرب العربي بين الإحياء والتأجيل ـــ توفيق المديني - دراسة تاريخية سياسية
[align=justify] وجاءت الجولة المغاربية بالتناوب: لمدير مكتب التحقيقات الفيديرالي موللر يومي 6و7 شباط/فيراير 2006 أولاً، ثم لوزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفليد، ما بين 11و 13 شباط/فبراير 2006 ثانيا ً، لتؤكد أن واشنطن تضع المسائل الأمنية والعسكرية على رأس الأولويات في هذه المرحلة، قبل الملفات السياسية ومن ضمنها الإصلاحات التي كان محور "منتدى المستقبل" الذي استضافت الرباط حلقته الأولى أواخر سنة 2004 في حضور عدد كبير من وزراء الخارجية الغربيين والعرب. غير أن دعوات الإصلاح والتغيير خفت بوضوح في الفترة الماضية في مقابل ارتفاع وتيرة التنسيق الإستخباراتي والعسكري. ويرى المحللون المتابعون للشؤون المغاربية أن محادثات رامسفيلد مع الزعماء المغاربيين وكبار القادة العسكريين، لم تتطرق إلى المشكلة المستعصية في المغرب العربي ألا وهي قضية الصحراء الغربية، بل تركزت على قضايا الأمن الإقليمي وتطوير التعاون العسكري بين المغرب العربي والولايات المتحدة، وكذلك مع الحلف الأطلسي، في إطار ما بات يُعرف ب"الحوار المتوسطي".و الذين يراقبون التحرك الأمريكي نحو الشمال الأفريقي يستحضرون معطيات بالغة الدلالات، منها أنه في وقت لم يكن أحد يفكر في إمكان التدخل الأميركي في العراق أبرم المغرب والولايات المتحدة اتفاقاً عسكرياً يسمح للقوات الأمريكية بالتوقف في القواعد المغربية والتزود بالوقود في حال تعرض منطقة الخليج إلى مخاطر. وأهمية الاتفاق الذي يعكس جانباً من الاستراتيجية الأمريكية البعيدة المدى أنه أبرم في مطلع الثمانينيات. والحال أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أمريكا والجزائر بقيت متطورة وزادت قيمتها في فترة الحرب الباردة، إلى درجة انقلبت فيها معادلة التحالفات. فالمغرب الحليف التقليدي لواشنطن أقام كذلك علاقات اقتصادية مع الاتحاد السوفياتي سابقاً ضمن ما يعرف بصفقة القرن التي تضمنت توريد الفوسفات المغربي من جهة، والإبقاء على التحالف السياسي مع أمريكا من جهة ثانية، ولم يحدث في ضوء تطورات نزاع الصحراء أن أبدت الولايات المتحدة اهتماماً بتسريع عمله إلا في الآونة الأخيرة، مستفيدة في ذلك من حشد التحالفات وإبرام الاتفاقات. ورغم تداول معلومات حول استبعاد فرضية البحث في نزاع الصحراء خلال جولة رامسفيلد إلى كل من الجزائر والمغرب، فإنه أعلن أخيراً عن تمنيات أمريكية بإفادة المغرب والجزائر معاً من عودة الإستقرار إلى المنطقة، ما يكشف أن لدى الإدارة الأميركية تصورًا حول مضمون التسوية قد تطرحها في الوقت الملائم في حال إخفاق مساعي الأمم المتحدة، ما يعني بحسب أوساط مراقبة أن حل نزاع الصحراء رهن تطورات من نوع آخر تكمن في الربط الأميركي بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر مفهوم سلام الشرق الأوسط والإصلاحات الديموقراطية في العالم العربي(9). إن الاهتمام الأمريكي بالمنطقة المغاربية لم يعد مقتصرا ً على الملف الأمني، وإنما أصبح يشمل أيضا ً الملف العسكري مثلما تجسده التقارير التي تصنف منطقة الصحراء على أنها "بؤرة رئيسية للجماعات الإرهابية في أفريقيا"، لاسيما بعدما صار المغرب العربي أحد المعابر الرئيسة لعناصر تلك الجماعات نحو أوروبا تحت ستار الهجرة السرية. وكانت صحيفة "النيويورك تايمس" أوردت في عددها الصادر السبت 5/6/2003،أن الجيش الاميركي يريد تعزيز وجوده في إفريقيا التي يرى أنها تشكل ملاجئ محتملة لمجموعات إرهابية. وذكرت أن وزارة الدفاع "البنتاغون" تسعى لتوسيع نطاق الوجود العسكري فى الدول العربية الواقعة فى منطقتي شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى عبر تعزيز علاقاتها مع حلفاء كالمغرب وتونس والوصول على المدى الطويل إلى قواعد في مالي والجزائر وإبرام اتفاقات مع السنغال وأوغندا لتزويد الطائرات العسكرية الأميركية وقوداً. وفي تصريح لصحيفة نيويورك تايمز قال الجنرال جيمس جونز رئيس القيادة الأوروبية في هيئة الأركان الأميركية المكلف قسما كبيرا من القارة الأفريقية "إن إفريقيا تشكل ـ كما تظهر ذلك الأحداث الأخيرة ـ مشكلة ملحة". وأضاف "لخوض الحرب على الإرهاب، يجب علينا أن نتوجه إلى حيث يوجد الإرهابيون. ولدينا أدلة تمهيدية على الأقل، تظهر أن مناطق خارجة عن أي مراقبة وسيطرة حكومية (في إفريقيا)، قد تتحول إلى ملاجئ محتملة للقيام بهذا النوع من النشاطات". وأشارت نيويورك تايمز إلى أن البنتاغون لا يسعى للحصول على قواعد دائمة في إفريقيا ولكنه يريد أن تتمكن قواته من زيادة تنقلاتها بين أوروبا وإفريقيا. ويشار إلى أن الولايات المتحدة شكلت قوة مؤلفة من 1300 عسكري في القرن الأفريقي ومركز قيادتها في جيبوتي مهمتهم ملاحقة وأسر من أسموهم الإرهابيين وقتلهم إذا ما اقتضى الأمر. وجاءت أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 لتؤكد تنشيط موقع إفريقيا في منظومة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.ولعل أبرز الملامح التي انعكست على القارة من هذه الأحداث هي : 1 ـ تأكيد المصادر الأمريكية أن غالبية الانتحاريين الذين يقودون سيارات ملغومة في العراق يتحدرون من الخليج، بيد أن هناك 20 في المئة يأتون من الجزائر ونحو خمسة في المئة من المغرب وتونس معاً. وإذا كانت ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي الموضوع الرئيس الذي يؤرق الأوروبيين، فإن ما يؤرق الأميركيين هو التقارير التي أظهرت أن واحداً من كل أربعة "استشهاديين" في العراق أتى متطوعا ً من المغرب العربي لقتالهم.. واستجابة للطلبات الأميركية الملحة اتخذت الحكومات المغاربية كل التدابير الممكنة لسدِ منافذِ السفر للعراق وسن بعضها قوانين جديدة صنفت نية التطوع للقتال إلى جانب المقاومة العراقية في خانة الأعمال الإرهابية. واعتقلت أجهزة الأمن التونسية والجزائرية والمغربية في السنتين الأخيرتين عشرات الشباب الذين قيل إنهم كانوا يعتزمون السفر للعراق للمشاركة في عمليات ضد القوات الأميركية وأحالتهم على القضاء. وسلّم الأمن الجزائري العام الماضي مجموعة من المتطوعين التونسيين اعتقلوا بعد مغادرة بلدهم في اتجاه العراق وأُحِيلُوا على المحاكم. وتضيف هذه المصادر الأمريكية أن "الاتصالات بين شبكات إرهابية من شمال أفريقيا وأخرى من الشرق الأوسط زادت في الفترة الأخيرة" من دون إعطاء تفاصيل. وأفادت أن أجهزة الاستخبارات الجزائرية والمغربية والليبية كثفت من ملاحقاتها للشبكات المحلية والخارجية اعتقادًا منها أن الذين انتقلوا إلى العراق سيعودون يوماً لتنفيذ عمليات في بلدانهم. وأفاد ت أن الجماعات المغاربية خصصت نحو 200 ألف دولار لتأمين نقل "المتطوعين" إلى العراق عبر أوروبا وسورية، لكنه أشار إلى وجود طرق أخرى عبر تركيا وإيران حيث يقطع المتسللون المناطق الحدودية التي لا تخضع للرقابة للدخول إلى العراق. ويعزو المحللون لشؤرون المغرب العربي تزايد اهتمام واشنطن بمنطقة الشمال الإفريقي وامتداداتها الجنوبية في جانب منه إلى تنامي المخاوف من نقل تنظيم "القاعدة" نشاطاته إلى المنطقة بسبب الانفلات الأمني وغياب سيطرة الدول على حدودها، والإقرار بوجود قواعد للتدريب، واستقطاب المناصرين المعادين للغرب، ما يعني في رأي أكثر من مراقب أن أخطار تنامي الظاهرة الإرهابية لم يعد موجهاً ضد أنظمة المنطقة، كما في حال تداعيات الصراع على السلطة في الجزائر أو الهجمات الانتحارية في الدار البيضاء المغربية أو تعرض ثكنة عسكرية موريتانية إلى هجمات سرقة وتهريب الأسلحة، وإنما أصبح يهدد المصالح الأميركية، لا سيما في ضوء إفادات معتقلين يتحدرون من أصول مغربية لهم ارتباطات بشبكات مغاربية وأوروبية أنهم كانوا يعتزمون تشكيل تنظيم مغاربي لـ"القاعدة" على غرار تنظيم "القاعدة في بلاد الرافدين". وزاد في القلق الأميركي أن أعداداً كبيرة من انتحاريي المقاومة في العراق يتحدرون من أصول مغاربية، فيما تحدثت مصادر أمنية في الرباط عن تفكيك خلية أطلق عليها اسم "الساحل والصحراء" في إشارة إلى المناطق العازلة بين حدود دول الشمال الأفريقي وامتداداتها الجنوبية، وهي شريط صحراوي تزدهر فيه تجارة تهريب الأسلحة والسجائر والبضائع والهجرة غير الشرعية ما دفع إلى الاعتقاد بضرورة قيام تنسيق أمني بين الدول المعنية، خصوصاً بين المغرب والجزائر وموريتانيا، يتجاوز الخلافات ذات العلاقة بنزاع الصحراء(10). 2 ـ مسارعة الأمريكيين لرد الفعل على هذه المعلومات الاستخباراتية بتكثيف مساعداتهم العسكرية لبلدان المغرب العربي خصوصاً، من خلال تعزيز عمليات التدريب والتسليح لإعانة القوات المحلية على ملاحقة الجماعات المتشددة إسوة بـ"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" الجزائرية التي يُعتقد أن لديها علاقات مع تنظيم "القاعدة"، والتي وضعتها أمريكا على لائحة المنظمات الإرهابية. ويتوقع أن يرتفع حجم المساعدات الأمريكية للجيوش المحلية إلى مستوى لم يبلغه منذ عقود، وهو يرمي للحؤول دون إقامة قواعد للجماعات المسلحة في الصحارى والغابات والمناطق الحدودية التي لا تراقبها جيوش نظامية. وكان الظهور الشبه الرسمي للأمريكيين في المنطقة في شهر مارس2004، في عملية عسكرية قادتها أربع دول من دول الساحل وهي (مالي، تشاد، النيجر، والجزائر) ضد ما يعرف بالجماعة السلفية للدعوة والقتال والتي كان يتزعمها المدعو "عماري صايفي" المعروف باسم: عبد الرزاق البارا (الصورة) الذي حيكت حوله العديد من القصص الغريبة.. ربما لأن عبد الرزاق البارا نفسه كان الذراع الأيمن للجنرال الجزائري"خالد نزار"، من أم فرنسية وأب جزائري، كان على وشك الارتباط بابنة الجنرال قبل أن يحدث ما سمي فيما بعد بالانشقاق الذي جعل " عبد الرزاق البارا" يقرر الهرب إلى الجبال وتشكيل تنظيما مسلحا ضد النظام الجزائري. ولعل العلاقة القريبة جدا التي كانت تجمع "عبد الرزاق البارا" بالجنرال "خالد نزار" هي التي أثارت الكثير من الشكوك فيما يخص الحقيقة الأخرى لتلك الشخصية التي ذهب البعض إلى القول أنها " مخابراتية مدسوسة" داخل التيارات الجهادية سواء في الجزائر أو في دول أخرى كانت لها علاقات "تنظيمية" مع تنظيم القاعدة، كما جاء في التقريرالأسبوعي عن صحيفة الخبر الجزائرية بتاريخ 10 أكتوبر2004. قيل وقتها أن الدور الأمريكي للقبض على زعيم تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال كان كبيرا، وأن وحدة أمريكية خاصة شاركت مع الجيش الجزائري لمحاصرته في منطقة تشادية كانت موجودة تحت سيطرة متمردي الحركة التشادية للديمقراطية والعدالة، وهي الحركة التي مولتها جهات أمريكية منها ما يعرف بالمؤسسة الوطنية لأجل الديمقراطية(11) (NED)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التي لهما أذرع كثيرة مع وكالة الاستخبارات الأمريكية السي. آي. إ يه(12). 3 ـ قيام قوات أميركية متمركزة في أوروبا طيلة أسبوعين من العام الماضي(2005) بمناورات للتدريب على مكافحة الجماعات الإرهابية مع قوات من الجزائر وموريتانيا وتشاد ومالي والسنغال ونيجيريا والنيجر وتونس والمغرب. وتوزعت أربع فرق أميركية قوامها ألف جندي على كل من تشاد والنيجر ومالي والجزائر وموريتانيا حيث نفذت تدريبات مشتركة مع ثلاثة آلاف جندي إفريقي. وأدرجت المناورات في إطار "المبادرة العابرة للصحراء لمكافحة الإرهاب" التي كانت مقررة منذ أشهر، إلا أن الغارة التي نفذتها "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" الجزائرية مطلع شهر أيار/مايو 2005على قاعدة عسكرية شمال موريتانيا حملت على التعجيل بإجراء المناورات التي أشرف عليها الجنرال هولي سيلكمان قائد القوات الأميركية في أوروبا. وكان الكونغرس وافق على الترفيع من حجم الاعتمادات المخصصة للبلدان التسعة في إطار تلك "المبادرة" من 6 ملايين دولار إلى 100 مليون دولار في السنة على مدى خمسة أعوام اعتبارًا من السنة ألفين وسبعة. ويدرس حلف شمال الأطلسي حاليا إمكان إقامة قواعد مراكز للتدريبات العسكرية في منطقة المغرب العربي، لتدريب قوات الحلف. وقد تم اقتراح اسم الجزائر كدولة محورية في الإستراتيجية الأميركية وفي المنطقة ككل لاحتضان هذا المشروع، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا يمتد على مسافة 1200 كلم. وكان المغرب يسعى هو الأخر لاستضافة هذا المركز، غير أن الإدارة الأمريكية تميل أكثر إلى الجزائر، لاسيما بعد التحاقها بعملية "اوبيريشن اكتيف اندرفور" التي تهدف إلى تأمين منطقة البحر المتوسط وتأمين الملاحة الجوية وإحباط العمليات الإرهابية. 4 ـ شروع الجيش الاميركي أخيرا في تدريب قوات تسع دول من الساحل الإفريقي بينها الجزائر، حسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" منذ فترة للتصدي لما وصفته بـ"غزو القاعدة والشبكات الإرهابية للدول الإسلامية والفقيرة في القارة الإفريقية بتمويل 500 مليون دولار على مدار سبع سنين".وتعتبر هذه الخطوة في نظر الإدارة الاميركية إيذانا ببدء مرحلة جديدة في تعامل الولايات المتحدة مع الحرب العالمية ضد الإرهاب.ويرى المتتبعون أن هدف الإدارة الاميركية من هذه الخطة هو توريط الجزائر والدول الإفريقية في الحرب ضد الجماعات الإرهابية.ويعتزم البنتاغون تدريب ألاف القوات الإفريقية في كتائب مجهزة لعمليات الحدود والصحراء الممتدة، كما ينوي ربط جيوش دول الساحل بالبرنامج عن طريق اتصالات جرى تأمينها على درجة عالية من الدقة، وبعيدة من أي اختراق عبر الأقمار الاصطناعية. ويشمل البرنامج تدريب قوات كل من الجزائر وتشاد ومالي والنيجر وموريتانيا والسينغال ونيجيريا والمغرب وتونس، على أمل أن يمتد البرنامج ليشمل ليبيا في حصول مزيد من التطبيع في العلاقات بين طرابلس وواشنطن. ونقلت الصحيفة عن مصادر من وزارة الدفاع الأميركية أن البنتاغون سيعين مزيدا من العسكريين في سفارات الولايات المتحدة في الدول المذكورة آنفا، من أجل تعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتعاون في المجال الاستخباري، إضافة إلى إبرام العديد من الاتفاقات بين واشنطن ودول الساحل المعنية بالبرنامج الأمني الجديد، بما يسمح وصول اكبر حماية شرعية للقوات الاميركية. 5 ـ بتاريخ 23 و24 آذار/مارس2004، شاركت ـ لأول مرة وبشكل سري(13) ـ قيادات من القوات المسلحة لعدد من الدول الإفريقية هي "مالي، تشاد، موريتانيا، المغرب، النيجر، السنغال، الجزائر، تونس" في اجتماع عسكري داخل مقر القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي (US ـ Eucom) في مدينة شتوتغارت الألمانية. كانت تلك القمة أمراً غير مسبوق، باعتبار أن أعمالها ظلت سرية ومحاطة بالمصطلحات عينها الجاهزة مثل " التعاون العسكري في إطار الحرب الشاملة على الإرهاب". كانت النظرة الأهم في هذا النوع من "اجتماع الثمانية" قد صاغتها الولايات الأمريكية قبل ثمانية أعوام ماضية في منطقة الساحل الجنوبي التي تعتبر جغرافيا وأمنيا أنها الحد الأخطر بين المغرب العربي وأفريقيا السوداء، وبين المناطق البترولية للشمال وتلك المترامية في خليج غينيا. كان أهم مطلب أمريكي من الدول الإفريقية المعنية هو صياغة مفهوما جديا لماهية الإرهاب، إذ صاغته الإدارة الأمريكية على شكل "إرهاب إسلامي". والحال هذه،صارت الأنظمة كلها تحت نفس الخط الأحمر إزاء ما يمكن للإدارة العسكرية الأمريكية أن تقدمه لها: أي المساعدات اللوجستيكية والدعم السياسي الذي يعني صرف النظر عن كل الجرائم ضد الإنسانية التي يمكن لتلك الأنظمة الإفريقية المعنية أن ترتكبها ضد شعوبها، لأن الغاية تبرر الوسيلة للأمريكيين، أي استغلال المخاوف الأمنية الإفريقية لزرع مزيد من الرعب الذي على أساسه يمكنها أن تتدخل مباشرة في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، لاسيما الدول العربية والإفريقية ذات الأكثرية الإسلامية. وهو الهدف الذي لم يكن بريئا نظرًا لارتباطه بالموارد الطبيعية التي تزخر بها العديد من الدول الإفريقية، كالنفط للجزائر وغينيا ونيجيريا، واليورانيوم الذي اكتشف في عدد من الدول مثل النيجر. وكان تقرير صادر عن المركز الأمريكي للأبحاث الإستراتيجية بواشنطن بتاريخ 13 ايار/مايو 2004، ذكر أن صوراً ملتقطةً عبر الأقمار الصناعية كشفت عن احتمال كبير (70%) عن وجود النفط في منطقة دارفور السودانية، وقد أشارت دراسة سابقة عن نفس المعهد الاستراتيجي الأمريكي سنة 1979 عن وجود النفط في صحراء غينيا. وهو الشيء الذي تأكد فعليا فيما بعد أن انفجرت العديد من النزاعات في القرن الغربي الإفريقي، امتدت إلى القرن الشرقي، والتي تمثلت في حروب ونزاعات داخلية تدخل في إطار الحروب الأهلية.. 6 ـ اعتبار التوجه الإفريقي الجديد للولايات المتحدة في رأي قيادة البنتاغون مسألة حيوية جدا ً، من أجل وقف تسلل الجماعات الإرهابية التي تسعى، حسبها، إلى ضرب العديد من الحكومات في العالم.ويرى محللون أن الإستراتيجية الأمنية الجديدة من خلال انتشارها في دول الساحل الإفريقي وبرنامجها الأمني دليل قاطع على أن الإدارة الأميركية تعاني متاعب جمة في العراق، وبالتالي لا تريد أن يتكرر السيناريو العراقي في مناطق أخرى من العالم في إطار حربها الدولية ضد البعبع الإرهابي، وهو ما يؤكده لجوؤها إلى تبني برنامج تدريبي لجيوش دول الساحل الإفريقي، وبالتالي تهربها من المواجهة المباشرة وترك هذه الدول تتحمل مسؤولية ذلك بعد إعدادها الإعداد الجيد لذلك. وحسب المراقبين فإن احتفاظ البنتاغون بمهمة الإشراف التقني واللوجيستي للعمليات ضد الإرهاب في دول الساحل الإفريقي والمغرب العربي يعني أن إدارة بوش عازمة على مواصلة الحرب على الإرهاب ولكن بالنيابة، من خلال استعمال جيوش غيرها، بسبب ما تتكبده يوميا من خسائر في العراق وأفغانستان. وهناك بعد آخر يتعلق بزيارة دونالد رامسفيلد للبلدان المغاربية، يتعلق بالحصول على مساهمة مغاربية تخفّف مأزق الولايات المتحدة في العراق، عبر استبدال جزء من القوات الأمريكية المقرر سحبها من العراق، بقوات عربية وأخرى مغاربية. ويظهر، للوهلة الأولى، أنّ مسعى رامسفيلد سيشكل إحراجًا للدول المغاربية التي تعرف تأييدًا شعبياً للمقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي، ولم تنجح عملية اغتيال دبلوماسيين جزائريين واختطاف عاملين في السفارة المغربية في بغداد، في تحجيم هذا التأييد، كما امتنعت هذه الدول رغم الضغوط الأمريكية، عن إرسال سفراء لها إلى العراق، وفضّلت حكوماتها النأي عن إقامة علاقات حميمية مع ما ظهر خلال الاحتلال من هيئات وحكومات، علما أنّها ارتبطت جميعها بعلاقات وثيقة مع عراق صدام حسين. 7 ـ إذا كان التقارب الجزائري الأمريكي يصنع مباهج الأمريكيين الطامحين للإستحواذ على أخطر المناطق الإستراتيجية في الساحل الإفريقي، فإنه يصنع تعاسة الفرنسيين المستاءين جدًا منذ عدة أشهر. زيارة رامسفيلد إلى عدد من الدول المغاربية أججت ثورة الفرنسيين، بحيث أن الصحف الفرنسية الرسمية الكبيرة لم تخف استياءها من الشراكة المغاربية الأمريكية التي لن تكون إلا على حساب فرنسا " التي ستدفع ثمن موقفها من الحرب على العراق من جديد!" كما قالت صحيفة "لاديبيش دو ميدي"(14) في عددها الصادر الاثنين 13 شباط/ فبراير2006.وهو الثمن الذي هددت به شخصيات أمريكية بتغريمه لفرنسا بعد عبارة" أوروبا القديمة" التي قالها رامسفيلد للتقليل من دور الفرنسيين في الاستراتيجيات القادمة! التحركات الفرنسية كانت سريعة بزيارة وفد فرنسي للجزائر في نهاية شهرشبط/ فبراير الماضي، وهي الزيارة التي أريد لها أن تدخل في إطار "الشراكة" الاقتصادية بالرغم من الموقف الحاد الذي تبديه وسائل الإعلام الفرانكفونية الجزائرية من "الغزل" الرسمي الجزائري الأمريكي. فرنسا التي تعتمد على اللوبي الفرنسي في الجزائر، تشعر بالتهديد الأمريكي المباشر، ربما لأن السياسة الفرنسية نفسها لم تعد تثير "شغف" الجزائريين، بعد أن سقطت العديد من النقاط الفرنسية على المستوى الشعبي جراء التعاطي الإعلامي الفرنسي " المتعصب" من انتفاضة الضواحي في باريس والتي استعمل فيها وزير الداخلية الفرنسي " نيكولا ساركوزي" عبارة " الأوباش" للحديث عن المهاجرين الأفارقة والمغاربة. سبر الآراء التي قامت به صحيفة "صوت الأحرار"(15) الجزائرية جاء فيه أن أكثر من 55% من القراء يفضلون أمريكا عن فرنسا، وهو ما نقلته أكثر من صحيفة فرنسية باستياء ظاهر.. " الأمريكيون يسعون إلى معاقبتنا بقسوة على عدم مشاركتنا في الحرب على العراق. إنهم يحاولون بكل الطرق زعزعة المناطق ذات التأثير الاستراتيجي. يقول برنارد منيار في كتابه "فرنسا والتغيير الاستراتيجي"، والحال أن الجزائر تبدو أكثر ميلا للأمريكيين لأن واشنطن أقل صرامة فيما يخص بيع الأسلحة، باعتبار أن فرنسا ظلت تمارس على الجزائريين حظرًا حقيقيًا فيما يخص أنواع محددة من طائرات "الميراج" و"الفونتوم" الفرنسية الحديثة، وهو الشيء الذي انتبه الأمريكيون إليه حين فتحوا جزئيا مغارة "علي بابا" العسكرية للجزائريين الذين حظوا هذا العام على أكبر صفقة أسلحة أمريكية في تاريخ العلاقات بين البلدين. ربما كان مضحكًا أن يراهن دونالد رامسفيلد في أبريل من عام2004 على الدور الأحق للولايات الأمريكية في القارة الإفريقية وفي الشمال الإفريقي بالخصوص. كانت عبارته موجهة في الحقيقة إلى نظيره الفرنسي الذي اتهمه بالهيمنة. والحال أن رد رامسفيلد لم يكن سقطة أمريكية في التعبير، بل كان إستراتيجية أخرى بدأ التحضير لها قبل غزو العراق. وإن كانت الولايات الأمريكية نجحت في "نتف" ريش الفرنسيين بعد الحرب على العراق، فإنها أيضا نجحت في إجبار الفرنسيين على التراجع عن العديد من المواقف، إلى درجة أن الضغوطات الفرنسية على سورية مثلا وعلى إيران صارت ملفتة للانتباه، وهو يعكس تماما أن فرنسا تكاد تكون مطيعة "لبيت الطاعة الأمريكية" كما جاء في افتتاحية الواشنطن بوست بتاريخ 12 أيلول/ سبتمبر2005. وكانت عبارة "ديك تشيني" ( في الواشنطن بوست أيضا) أن أمريكا ستدخل إلى إفريقيا من أوسع الأبواب، بمنزلة الحرب الباردة بين واشنطن وباريس على منطقة ظلت رهينة مزاجات سياسة الكبار، باعتبار أن فرنسا التي تحتكر المغرب العربي على أكثر من جانب، أهمها الجانب اللغوي والثقافي، تستشعر خطر التقارب المغاربي الأمريكي الذي يبدو بدوره أشبه بالانتقام الذي على أساسه تسعى كل دولة من الدول المغاربية إلى ممارسته بشكل ما بتقاربها مع واشنطن، بعد أن "أفلست" باريس سياسياً وأيديولوجياً. لكن الأخطر أن الساسة يلعبون بمستقبل شعوبهم، وأن الأحضان الأمريكية أو الفرنسية ستكون كارثة استعمارية جديدة اسمها" الاحتلال الأبيض" ! (1) كمال عبد اللطيف ـ اتحاد المغرب العربي... الإصلاح السياسي أولاً، صحيفة الشرق الأوسط تاريخ 19 آب 2004. (2) مصطفى الخلفي ـ الأزمة بين التوترات الثنائية والدور الخارجي ـ المصدر: موقع العصر بتاريخ 20 ديسمبر 2003. (3) الهواري عدِي ـ عود على بدء بين الجزائر والمغرب:الأخوة المستحيلة ـ لوموند ديبلوماتيك، النسخة العربية الصادرة عن جريدة النهار اللبنانية، كانون الأول /ديسمبر 1999. (4) عبد الهادي بوطالب ـ الاتحاد المغاربي يدخل مرحلة الموت السريري. www.abdelhadiboutaleb.com. (5) محمد الأشهب الخلاف المغربي الجزائري حول الصحراء الغربية: تصعيد المواجهة. .. والعودة الى نقطة الصفر – صحيفة الحياة ـ 7/10/2004. (6) جورج الراسي ـ الجراد وحده يوحِّد المغرب العربي ـ صحيفة المستقبل اللبنانية ـ الأربعاء 15 كانون الأول 2004 ـ العدد 1779 ـ رأي وفكر ـ صفحة 17 (7) جورج الراسي ـ اتحاد الإرهاب في المغرب العربي ـ صحيفة المستقبل اللبنانية ـ الاربعاء 29 حزيران 2005 ـ العدد 1962 ـ رأي وفكر ـ صفحة 21 – (8) جريدة اللوموند ديبلوماتيك، أنظر إلى الرابط التالي: ww.monde ـ dipmomatique.fr (9) محمد الأشهب ـ الخوف من «القاعدة» في شمال افريقيا يوسّع الاختراق الأميركي في منطقة النفوذ الفرنسي ـ مقال منشور في صحيفة الحياة، بتاريخ 5 مارس 2006. (10) المرجع السابق. (11) إدجار كونزاليس رويز(الكاتب المكسيكي، مقال: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والشبكات الإرهابية.أنظر إلى موقعwww.syti.net (12) حوار جريدة الخبر مع السفيرة الأمريكية في الجزائر منشور على موقع الصحيفة عبر الانترنت. (13) ياسمينة صالح ـ واشنطن والصحراء الجزائرية: قاعدة أمريكية لمراقبة إفريقيا؟ انظر موقع الانتقادنت www.intiqad.netبتاريخ 6آذار/مارس2006. (14) أنظر لصحيفة" لاديبيش دو ميدي" على الرابط التالي: www.ladépechedemidi.com (15) سبر الآراء الذي أجرته كل من جريدة "صوت الأحرار" و"المجاهد الأسبوعي" الجزائريتين بتاريخ 6 حزيران/يوليو 2005، جاء فيه أن أكثر من 50% من القراء يفضلون أمريكا عن فرنسا ! [/align] |
|
|
|

|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [9] | |
|
كاتب نور أدبي ينشط
  
|
رد: اتحاد المغرب العربي بين الإحياء والتأجيل ـــ توفيق المديني - دراسة تاريخية سياسية
توطئة: جدلية صراع الجغرافياوالتاريخ [align=justify]يقول ميشال جوبير وزير الخارجية الفرنسي السابق في كتابه عن المغرب العربي: " لا بد أن تتمكن شعوب شمال إفريقيا بصورة عامة من تسوية غالبية مشكلاتها الخاصة. ولعل آخر شيء يجب أن تفكر فيه هو اعتبار هذه المشكلات نهائية أو أبدية. ويتعين على المسؤولين المغاربيين أن يقتنعوا بهشاشة الزمن الحاضر، وأن لا يدركوا سوى غبار الأزلية الذي لا يفتأ يتصاعد ويهبط مع الأشعة، وأن يتسلحوا بالعقل لا ليقتنعوا بأنهم على صواب أوليبرروا ما يقومون به من أعمال، لأن المحامين الجيّدين يتكفلون بإغلاق الملفات، أما رؤساء الدول فيجب أن يكونوا ملهمين وذوي عزيمةٍ وإصرارٍ. ومن أجل حماية نفسه من الشمس الطاغية التي تطل عليه، لا يملك المغرب العربي المتألق من أملٍ سوى ظل أيديه، وعليه أن يجمع أيديه من نواكشوط إلى طرابلس في مسيرة تضامن مستمرة وفي ثقة قوية وعالية بالنفس ". ويلاحظ المرء، أنه إذا كان الخيَّاط الباريسي الشهير" فرانسيس سمالتو" هو الذي يحافظ على علاقة دائمة مع قادة المغرب العربي،لأنه يقدم لهم خبرتــه وذوقه في التفصيل والخياطة، فإن الرجل السياسي الفرنسي يقف شاهدا ً على هشاشة الزمن الحاضر، حتى أن المغرب العربي بات لا يملك من أمل فيالوحدة سوى " ظل أيديه ". لقدبدأت وحدة المغرب العربي كمشروع بناء إقليمي، تتردد في الخطاب الرسمي للأنظمةالسياسية الحاكمة، ولدى النخب السياسية والثقافية، منذ أن أصبح أسلوب خلط الأوراقفي السياسة الرسمية المغاربية، وقلب التحالفات على أرضية لجم التناقضات المستعصية بالتوفيق فيما بينها، تقليدا ً عريقا ً عند الأنظمة، في ظل سيطرة ممارسة تركيزالمحاور، وتكوين التجمعات الإقليمية. وهكذا،ولدت معاهدة "الإخاءو الوفاق" بين تونسوالجزائر في 11 آذار/مارس 1983،انضمت إليها موريتانيا لاحقا ً، وبالمقابل تشكل "الاتحاد الإفريقي – العربي "الموقع في جدة في 3 آب/آب / أغسطس1984، بين الملك الحسن الثاني والعقيد معمر القذافي.وعرفت العلاقات المغاربية – المغاربية جو الصفاء والتقارب خلال أزمة الثمانينيات. وتأسست نواة اتحاد المغرب العربي على قاعدة سياسيةرسمية ـ أي اتحاد النظم بدلا من اتحاد الشعوب ـ في 17 شباط/شباط / فبراير 1989. وكانت المعوقات الكبرى التي اصطدم بها مشروع بناء"وحدة المغرب العربي" هي التالية: أولاً: الإشكاليات التي برزت على الحدود بين الدول المغاربية المعنية (الجزائر والمغرب) خلال المرحلة الماضية، سواء من حيث تحديد الحدود وحل النزاعات الترابية، باعتبارهذا يدخل في نطاق استكمال بناء "الدولة الوطنية" بمفهومها القطري، أم من حيث الحيلولة دون تحول هذه الحدود إلى معبرٍ للقوى المعارضة، يستخدمها نظام معين في صراعه السياسي مع نظام آخر، كما هو الحال على الحدود الليبية ـ التونسية، والحدود الجزائرية – التونسية، والحدود الجزائرية – المغربية الخ... ثانياً:حرب الصحراء الغربية القائمة منذ العام 1975، وأثرها المباشر في احتدام صراع المحاورالإقليمية بين المغرب والجزائر،والموقع الذي احتلته في استراتيجية التطويق والمحاصرة لدى كل من النظامين. ثالثًا: التناقضات الأيديولوجية والسياسية العميقة التي كانت تفصل أنظمة المغرب العربي بعضها عن بعض، جراء انحياز كل نظام لاختياراتٍ اقتصاديةٍ –اجتماعيةٍ، وارتباطاتٍ دوليةٍ محددتين.وفضلا ً عن ذلك، فإن التصور المستقبلي لبناء هذا المشروع الإقليمي المغاربي كان مفقودا ً أو غائبا ً،ومرجئا ًإلى الزمان الذي تتوافر فيه حلول لهذه المعضلات القائمة التي تم ذكرها. وإذاكان من نافلة القول أن مسار البناء السياسي لأنظمة المغرب العربي(باستثناء الجماهرية الليبية) انصب بشكل رئيسٍ على بناء الدولة القطرية، في تناقض جذري مع خطالبناء القومي والوحدة العربية، والتحرر من السيطرة الإمبريالية، فإنه من المفيد التذكير بالعوامل الرئيسة التي دفعت أنظمة المغرب العربي إلى التوجه نحو بناء هذاالتكتل الإقليمي "اتحاد المغرب العربي". علما ًأن الاتحاد العربي الشامل لم يتحقق،والاتحادات الإقليمية لم تنجح في الماضي. إن المواطنين العرب ما عادوا يكترثون كثيراً، عندما يسمعون أنباء إعلان اتحاد بين دولتين عربيتين أو أكثر.لا لأنهم غير معنيين بالوحدة، بل لأنهم ما إن تعلن حتى تنطفىء. فهناك أكثر من مشروع وحدة اتحادية أعلن وانطفأ. ونذكر من ذلك: الاتحاد الهاشمي بين الأردن والعراق. والوحدة الاتحادية بين مصر وسورية والعراق سنة 1963. واتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسورية وليبيا سنة 1971. وهناك اتحاداث ثنائية،وسوق عربية مشتركة، واتفاق دفاع مشترك. إلاأن كل هذه المشاريع، التي لم يحقق أي منها الاندماج، والمرتبط نجاحها بالتقلبات السياسية، الداخلية والخارجية، مازالت تطرح وتعلن. أما اتجاه الوحدة الشاملة، فقدأصبح جزءا ً من الماضي السحيق. ولهذا فإن المواطن العربي، ما إن يسمع نبأ اتفاق وحدوي جديد، حتى يدير ظهره غير عابىء. ولذلك سببان: أولهما، يعود إلى أن المواطن العربي لا يثق بالاتجاه الوحدوي أوالاتحادي، بكل أنظمته. لأنها أنظمة، كما أثبتت التجربة غير معنية بكل ما هو وحدويأو اتحادي، أو حتى كل ما يمت للعلاقات الطبيعية بين دولة وأخرى.و ثانيهما، يعود إلىأن المواطن العربي لا يريد أن يخدع "بالهلوسات" الإعلامية الرسمية. و معذلك، فقد كان إعلان قيام "اتحاد المغرب العربي"حدثا ًمهما ً، حتى لو م يبادرالمواطنون العرب إلى إعلان اهتمامهم.و يتسم تجمع اتحاد المغرب العربي، بما يلي: لقدشهدت بلدان المغرب العربي خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي سلسلة كاملة من الانفجارات الشعبية الكبيرة، والانشقاقات العارمة، وشكلت جميعها حركة تصاعدية من النضال الاجتماعي والسياسي ضد الطبقات الحاكمة. وقد أحدثت هذه الانتفاضات اختلالا ًفي بنية الأنظمة السياسية، في تونس، والجزائر، والمغرب،و هو ما جعلها تقدم علىتقديم تنازلات اضطرارية، تمثلت في انتهاج سياسة "الانفتاح الديمقراطي والتعددية السياسية". غير أن هذا الإصلاح الديمقراطي المحدود والمبتور، والمقنن والمضبوطبقواعد جذرية، لم يقض على الاحتكار السياسي من قبل النخب الحاكمة، ولم يقض على التسلط الاستبدادي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية على رقاب الجماهير والقوى الوطنية والديمقراطية. و لما كانت هذه الأنظمة أصبحت تخاف إلى درجة كبيرة،من اندلاع انفجارات شعبية جديدة، قدتؤدي إلى الإطاحة ببعض الأنظمة الضعيفة، الأمر الذي سيكون لـه انعكاس مباشر علىمصير بقاء هذه النخب في الحكم، بات تطوير العلاقات السياسية، وتكثيف الاتصالات فيمابينها، وإقامة نوع من التضامن مبني على أسس سياسية جديدة، ووحدتها في إطار اتحادالمغرب العربي، أمرا ً ضروريا ً، من الناحيتين السياسية والتاريخية، في سبيل بقائهامحمية بهذا التكتل الإقليمي المرتبط بالسياسة الأمريكية. وينطلق البناء الإقليمي لاتحاد المغرب العربي منالأرضية التي تقوم عليها هذه الأنظمة المعنية، أي أرضية التبعية والتخلف والتجزئة،والاستسلام لخط التسوية على الصعيد القومي. وهو كمشروع وحدة إقليمية، يحكمه منطق التعاون الجماعي المتعدد الأوجه بين هذه الأنظمة، في محاولة لبناء وحدة فوقية منطبيعة تأليفية بين الدول الخمس لبناء لبنة المغرب العربي الكبير، يحقق السلم لهذه الأنظمة عبر حل الأزمات المتفاقمة سياسيا ً واقتصاديا ً وأمنياً، ويعمل على منعالانفجارات غير المتوقعة، والسيطرة على بؤر التوتر، ويحمي فيه النظام القوي النظام الضعيف. فهوبناء إقليمي يحافظ على الخصوصيات القطرية، ولا يعمل على إزالة الحدود الموروثة منعهد التقسيم الكولونيالي، والتي دعمتها ورسختها الطبقات والنخب الحاكمة. وهو لايعدوأن يكون محورا ً سياسيا ً مؤقتا ً محدود الأهداف، لا يلزم أطرافه بتغيير اختياراتهمالسياسية والاقتصادية، ولايقطع علاقاتهم بالإمبريالية الأمريكية، ولا يطرح موضوع الوحدة الاندماجية الكاملة التي تزيل الحدود، وهو ما طرحه العقيد القذافي مرارا ًدون أن يجد آذاناً صاغية. منالجدير بالذكر هنا أن مفهوم القومية العربية الذي يحيل في الخطاب الأيديولوجي والسياسي في المشرق العربي على أيديولوجية الوحدة العربية التي جسدتها كل من الناصرية والفكر البعثي،يتموقع في الخطاب السياسي المغاربي كهوية عربية معيشة. ذلك أن العروبة السياسية التي تبدو كمرجعية قوية في المشرق العربي، نجدها في المغرب العربي مبنية بشكل أضعف.إذ لم تستطع بلورة منطقها المستقل في هذه البلدان، لأنها ارتبطت بردود الفعل الوطني في جل مراحل تطوره. وتتميز العروبة في بلدان المغرب العربي،وبالتأكيد لعدة عوامل، منهاإخفاق التجارب القومية العربية بالمشرق، وطبيعة سلوك النخب السياسية المغاربية الحاكمة، بسمتين طبعاها بشكل واضح: 1 ـالتشبث بالدولة الوطنية، ذلك أن النخب السياسية التي قادت حركات التحررالوطني ضمن الشروط التاريخية والسياسية محددة لتطور حركات الاستقلال وسيرورتها في هذه البلدان،اتخذ وعيها القومي العربي معناه الكامل في الوعي الوطني الخاص، واضطرت إلى تفضيلالجانب الوطني. 2 ـالتلازم بين العروبة والإسلام، إذ تشكل هذه العلاقة عنصرا ً يميز المغرب عن المشرق. ففي المغرب العربي يستحيل العثور على وعي قومي عروبي من دون الرجوع إلى الإسلام سواء في الكتابات المغاربية في فترة ما قبل الاستعمار، أو في النصوص السياسيةالمعاصرة. فالأمر يسير وكأنه لا انفصام بين بعد العروبة والإسلام في الخطاب السياسي المغاربي. إن الميتودولوجيا المغاربية للوحدة تقوم على التدرجية، ذلك أن الخطابات السياسيةالمغاربية مرحلية في عمقها ومنطقها. ومع ذلك استبشرت الجماهير العربية خيرا ًلولادة هذا الاتحاد المغاربي، الذي يشمل المنطقة من حدود ليبيا مع مصر،إلى نهرالسنغال. وفي هذا الاتحاد دولتان مهمتان، من حيث الموقع وعدد السكان، هما المغرب والجزائر. فقد حاولت الجزائر أن تلعب الدور الرئيس في اتحاد المغرب العربي، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، لتخلف قيادتها السياسية، وضعف جيشها، واضطراب وضعهاالاقتصادي، ودخولها في أتون حرب أهلية طاحنة طيلة عقد التسعينيات بين العسكر والأصولية الإسلامية، وإن كان النظام المغربي، الأدهى سياسيا ً لم يستطع الفوزبالسبق، بسبب تفاقم مشكلاته الاقتصادية، وعدم رغبته في تنمية قواته العسكرية، وعد مقدرته عليها، إضافة إلى قضية الصحراء الغربية التي تمثل عقدة الاستعصاء في تطبيع العلاقات الجزائرية – المغربية. لقد قام الاتحاد المغاربي، والحركة الشعبية مقموعة، والأحزاب والقوى السياسية مسلمة لقياداتها، والحركة القومية العربية منيت بهزيمة تاريخية عادلة، وبالتالي، فإنالحركة الشعبية وقوى ومنظمات المجتمع المدني لا تستطيع أن تدعي أنها أسهمت الآن في فرض قيام مثل هذا التجمع الإقليمي، أو أن لها برامج لتطويره. إنشهر العسل هذا المرتبط بقيام اتحاد المغرب العربي، لم يطل إلا قليلا ً مع اندلاعالصراع بين بعض الأنظمة المغاربية والحركات الإسلامية الأصولية، وفرض الحصار الدوليعلى الجماهيرية بسبب أزمة لوكربي، وبلوغ أزمة العلاقات بين المغرب والجزائر حالةالاختناق القصوى بتمادي الجزائر في خلق الفرص وافتعال الذرائع بشأن قضية الصحراءالغربية،ما يعني أن قضية توتر العلاقات المغاربية أصبحت تشكل الخطر الكاسح، وأنالحديث عن المغرب العربي الكبير أصبح حديث خرافة، وأن هذا الاتحاد دخل مرحلة الموتالسريري ويوشك أن يلفظ أنفاسه في غيبة أسرته التي تشتت شملها نتيجة التلاعب بمصيرالوحدة المغاربية الذي كان حلم الجماهير في كل بلدان المغرب العربي أيام الكفاحالوطني ضد الاستعمار الفرنسي. وهناكإجماع لدى الباحثين والدارسين والسياسيين في منطقة المغرب العربي، يؤكد أن أسباب إخفاق التجربة الوحدوية لبلدان المغرب العربي تعود بالأساس إلى العوامل التالية : ـغياب الإرادة السياسية والاستقالة التي تعيشها النخب المغاربية عن وظيفتهاالنقدية. ـ انعدام حرية الرأي والتعبير، فقد حُكِمت بلدان المغرب العربي منذ الاستقلال بشكلفيه الكثير من التعسف ومنع لحرية التعبير، وهو ما جعل أغلبية المجتمعات العربية تعلن استقالتها من المشاركات في تدبير الشأن العام. ـ عدم توفر قادة المغرب العربي على الإرادة السياسية اللازمة للقيام بهذه الخطوة، ولعل الصراع على زعامة المغرب العربي بين القيادات التاريخية التي حصلت على الاستقلال ـ بورقيبة الحسن الثاني أولا ً، وبين الحسن الثاني وهواري بومدين ثانيا ً، وبين قيادات شابة تميل إلى الثورية وتسعى إلى "تصدير " تصوراتها المجتمعية ـ القذافي – ثالثا ً،قد لعب دورا ً مهما ًفي تأخير نشوء هذا الاتحاد. ـ اختلاف المسارات التي عرفتها بلدان المغرب العربي بعد الاستقلال، ففي حين اتجهت بعض البلدان شرقا ً إلى الاتحاد السوفييتي – ليبيا والجزائر – اتجهت بلدان أخرى غربا ً – تونس والمغرب – بل إن هذه الثنائيات نفسها عرفت صراعا ً كبيرا ً أو على الأقل هيلم تستطع أن توجد اتفاقا ً فيما بينها. فالصراع بين فرنسا وأمريكا على المنطقة انعكس في خلاف بين المغرب وتونس. كما أن البلدان التي اختارت أن تتجه شرقا ً لمتتمكّن من توحيد تصوراتها المجتمعية فشهدنا نظاما ً أقرب إلى هيمنة الأحزاب الستالينية في الجزائر في حين كانت ليبيا تعيش تجربة " الجماهيرية". ـ إن القيادات السياسية المغاربية لم تكن واعية تماما بأهمية المشروع الوحدوي المغاربي.والحال هذه، ظلت العلاقات بين بلدان المغرب العربي مرتبطة إلى حد اليوم بطبيعة تلك القيادات السياسية، وحالاتها،وانفعالاتها، وهو ما يجعل القرارات السياسية بل النظم السياسية نفسها تتماشى حسب مخيّلات وخيارات تلك القيادات. وهذايعود بالأساس إلى غياب المؤسسات. و كان من نتائج حالة الانغلاق السياسي وانعدام الحريات هروب عدد كبير من الكفاءات التيكان من المفترض أن تتحمل عبء التطوير والتغيير في بلدان المغرب العربي. إنمشكلة وحدة المغرب العربي ليست مشكلة عيب التركيب الديني أو الثقافي الخاصب العروبة، بل مشكلة النخب السياسية الحاكمة التي أصبح همها الرئيس هو الاندراج في قنوات النظام الدولي الأمريكي بانضباط محكم للإستمرار في الحكم دون غاية غيرها.و هي نخب لا تشعر بأي نوع من الانتماء للعروبة السياسية،إسلامية كانت أم علمانية.ثم إن معظم الطبقات والفئات التي ظهرت في الجزء الثاني من القرن العشرين لتحكم المغرب العربي باسم شرعية قيادة حركة التحرر الوطني، لم تتمكن من كسب الحد الأدنى منالشرعية الديمقراطية تجاه شعوبها لفقدان الإنجازات الحقيقية في تحقيق الديمقراطية،وبناء دولة الحق والقانون بالتلازم مع بناء المجتمع المدني الحديث. كل هذا لم يتحقق، بل حصل عكسه تماما ًَ، أي بناء الدول التسلطية، وهبوب رياح القوميات القطريةالاصطناعية التي باتت تشكل "جدارا ً حديديا ً" يفصل بين بلدان المغرب العربي. [/align] |
|
|
|

|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [10] | |
|
كاتب نور أدبي ينشط
  
|
رد: اتحاد المغرب العربي بين الإحياء والتأجيل ـــ توفيق المديني - دراسة تاريخية سياسية
[align=justify]
توطئة: جدلية صراع الجغرافياوالتاريخ القسم الأول الموانع السياسية تقف حائلا ً أمام الاندماج المغاربي: ـ الفصل الأول الاتحاد المغاربي مسيرة متواصلة من التعثر الفاضح 1 ـــالاتحاد المغاربي مشلول بعد 17 سنة على تأسيسه لاأحد يشك من الذين تعاطوا ولو بقليل من الجدية والموضوعية مع فكرة إنشاء اتحاد دولالمغرب العربي في أن هذه الفكرة والحلم يمران اليوم بأزمة ليست كسابقاتها المتكررةفي عهد لم يتعد عقدا أو أكثر من نصف عقد من الزمن، وأخطر ما في هذه الأزمة أنهاتتعدى في حجم استعصائها على المعالجة حدود أزمات الإقليم العصية على الاختراق إلىأخرى تجوب انتماءه القومي الأرحب والقاري والعالمي، وتتحكم بموجبها بعض الدول "الكبرى" في مصير الدول والشعوب العاجزة عن خلق نظامها الإقليمي الطبيعي الذي يعتبرلها ضرورة تاريخية كما هو حال الوحدة بين أقطار دول المغرب العربي. إذيؤكد التاريخ للباحثين والمهتمين بشؤون المنطقة أن هذا الإقليم ظل طيلة مراحلتاريخية يكوّن وحدة اقتصادية وجغرافية وثقافية واحدة، وإن لم تنف هذه الحقيقةبالطبع واقع أن شمال إفريقيا، كما هو الوضع في العديد من أقاليم العالم الموحدةاليوم، قد عرف خلال مراحل متقطعة من تاريخه وجود دول أو عدة دول على أراضيهالشاسعة، لكن تلك الدول لم تكن تشكل في حد ذاتها وحدة اقتصادية أو ثقافية مستقلة،كما أن وجودها بقي ثانويا مقارنة مع وجود الدول الموحدة، كما يشهد تاريخ المنطقةالذي ظلت فيه الوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية والجغرافية هي القاعدة الأصل. وفيالعصر الحديث استطاعت الدول الوطنية التي ظهرت داخل الإقليم أن تواجه خطر القضاءعلى الهوية الذي مورس ضدها بلا هوادة من طرف الجهة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط،لا سيما فرنسا، لكن تلك الدول لم تتمكن من استيعاب آليات تستعيد بها وحدتهاالتاريخية، بل دخلت أحيانا آليات عديدة في لعبة الصراعات الحدودية، واقتسام النفوذوالسيادة على المناطق التي لم يشأ الاستعمار حسم أمرها النهائي بين دول جديدة اقتطعخريطتها بعناية لمقاصد سيئة لا تخفى على المراقب. منأخطر تلك الأمور ما فجر أزمة الحدود بين الجزائر والمغرب، وما عرف بأزمة إقليمالساقية الحمراء ووادي الذهب الذي أدخل الجزائر في مواجهة مزدوجة مع المغربوموريتانيا سنة 1975، وما زال أهم العقبات أمام محاولات الأنظمة المغاربية في أنتحتذي بالنماذج التوحيدية في ضفة البحر الأبيض الشمالية، محاولات لم تتعرض لهذهالإعاقة الوحيدة وإنما تعرضت لعجز الأنظمة السياسية في بلدان المغرب العربي عنتحديث ممارساتها السياسية في الحكم، وفرز نخب تعبر عن إرادة شعوبها الحقيقية، لأنذلك الأمر كفيل وحده بتعزيز مسار الوحدة المغاربية بحكم أنها مطلب شعبي تعززهالحاجة الاستراتيجية في خلق كيان يواجه به تهديد الاتحادات القائمة والمنتظرة فيالمنطقة والعالم. لمتنجح المجموعة المغاربية في تحويل مشروع المغرب العربي الكبير إلى فعل تاريخي قادرعلى تعزيز مقومات التنمية في الأقطار المغاربية، بل إنها لم تنجح في تركيب برامجمشتركة في العمل قادرة على تحويل بنود ميثاق الاتحاد إلى معطيات ومواد قابلةللانغراس في تربة الواقع، وقادرة في الآن نفسه على تحويل المشروع إلى تاريخ.ورغمالمعطيات الجغرافية والتاريخية والثقافية العامة التي صنعت مشروع الاتحاد وحلمه،فإن ضغوط الواقع في أبعاده المختلفة قد كرست واقع الحال القائم بين أقطار المغربالعربي. يفترضالمراقب من الخارج أن دول المغرب العربي مهيأة أكثر من غيرها لرسم معالم تعاون عربيإقليمي فاعل في محيطه المجتمعي ومطور لآليات في التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي،وذلك بحكم الطابع الواقعي والبراغماتي الذي وسم أغلب سياسات أقطاره. ولعله يفترضأيضا ً أن غياب الوعي القومي الشمولي عن نخبه السياسية، كما هو الحال عليه فيالمشرق العربي عموماً، قد يساعد في بلورة أهداف واضحة ومتدرجة، وهو ما يمنحهاإمكانية التحقق الفعلي في مستوى الممارسة والإنجاز.. إلا أن ما حصل منذ إعلان ميثاقالاتحاد لا يدعم مثل هذا الرأي، ولعله يكشف بكثير من القوة، وجود خلل ما في الإرادةالسياسية يقف بمنزلة حجر عثرة أمام الطموح المجتمعي المغاربي في بناء قوة عربيةإقليمية في شمال غرب إفريقيا، قوة قادرة على ركوب درب التنمية بإيقاع أسرع، وقادرةفي الوقت نفسه على إعداد محاور للاتحاد الاوروبي الذي يزداد قوة، ويتجه لتعزيزمسيرته التاريخية في بناء القارة الأوروبية.(1). منالواضح أن الإحساس بالأزمة البنيوية العميقة وانغلاق سبل الخروج منها، هو الذي دفعالأنظمة المأزومة إلى محاولة البحث عن مخرج جماعي بإحياء وحدة المغرب العربي بهدفالتخفيف من المخاطر الداهمة، علماً أن اتحاد المغرب العربي قام على أساس قطريواندمج في إطار تشكيل وحدة إقليمية على غرار الوحدات الإقليمية العربية، وحدة أنظمةقطرية مسيطر عليها من قبل الإمبريالية الأميركية، ولها وظيفة في هذه الاستراتيجيةالأميركية في العالم العربي، والبحر الأبيض المتوسط، لدعم ركائز هذه الأنظمةالقطرية، ومنع الحركات الإسلامية الأصولية المغاربية من أن تحقق أهدافها، وخلق نوعجديد من التوازنات يساند فيه النظام القوي النظام الضعيف، ويمنع الأقطار الأكبر مناحتواء الأقطار الأصغر. اتحادالمغرب العربي ( ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، وموريتانيا ) الذي تم إنشا ؤه فيمدينة مراكش بالجنوب المغربي في 17 شباط/فبراير 1989، يجابه تحديات داخلية وخارجيةيلخصها الشلل الكامل لمؤسساته، والتأجيل المستمر لاجتماع مجلس الرئاسة الذي كانمفترضاً أن يعقد في الجزائر عام 1995. ويضم هذا الاتحاد المغاربي حوالي/80/ مليون نسمة من العرب، ويشمل المنطقة منحدود ليبيا مع مصر إلى نهر السنغال، وتصل مساحتها إلى نحو 5.380591 كيلو مترا ًمربعا ً، وفي هذا الاتحاد دولتان مهمتان من حيث الموقع وعدد السكان هما المغربوالجزائر. لا شكفي أن وحدة المغرب العربي كمشروع بناء إقليمي قديم متجذر في ضمير شعوب المنطقة، غيرأنه يمكن تصنيف المعوقات الكبرى التي اصطدم بها مشروع بناء وحدة المغرب العربي إلىثلاث: مرحلة إزالة الاستعمار وبناء الدولة الوطنية الحديثة: فبعد عامين من استقلالتونس والمغرب عام 1956، وتجذر الثورة الجزائرية في مقاومة الاستعمار الفرنسي عقدتفي مدينة طنجة أول قمة مغاربية ضمت قادة أحزاب الاستقلال المغربي والدستور التونسي،وجبهة التحرير الوطني الجزائرية، لا الحكومات بحكم أن الجزائر لم تنل استقلالهابعد. وبعداستقلال الجزائر عام 1962 كان بناء المشروع المغاربي في قلب المفاوضات بين البلدانالثلاثة، حيث تم توقيع اتفاقيات الرباط في عام 1963، التي نصت على تحقيق التطابق فيسياسة البلدان الثلاثة تجاه السوق الأوروبية المشتركة، وتنسيق مخططات التنمية،وسياسة التبادل التجاري. غيرأن كل هذه الاتفاقات لم تتجسد مادياً على الأرض، ولم يتجاوز بناء المغرب العربيإطار المشروع النظري بسبب الصراع التنافسي الذي دب بين حكوماته المختلفة علىزعامته، واستمرار النزاعات الحدودية الموروثة من الحقبة الكولونيالبة بين مختلفالبلدان المغاربية (نذكر في هذا الصدد النزاع المسلح بين المغرب والجزائر في تشرينالأول/أكتوبر 1963 )، وهو ما عكس لنا بروز المظاهر والنعرات الإقليمية التي أصبحتسائدة في عقول وممارسات النخب الحاكمة، والتي قضت على أي تفكير جدي في بناء المغربالعربي الكبير، على نقيض الاعتقاد الذي كان سائداً، والذي كان يعتبر أن استقلالالجزائر سوف يساعد على تحقيقه. ومغزىآخر هو أن الدول المغاربية أغلقت أبوابها على نفسها، ووضعت حدودا ً لها بحواجزإدارات الهجرة والجمارك، وبثقافة جديدة تخلع كل قطر من هويته المغاربية والاسلامية،وسلمت بالكيانات القطرية، وصارت تنظر إلى مشروع المغرب الكبير على أنه مجرد تعاونفي المجالات الاقتصادية والثقافية دون التفكير في تنازل الدول عن أي شيء من سيادتهالحساب هيئةاتحادية مهما كانت هذه الهيئة مجردة من السلطات. وهي روح تختلف عن تلك التي سادتمؤتمر طنجة سنة 1958. وأسهماختلاف الاستراتيجيات الاقتصادية في البلدان المغاربية في تهميش مشروع التكاملالاقتصادي الإقليمي خلال عقدي الستينيات والسبعينيات، وإلى تأجيج الصراعاتالايديولوجية بين محوريه تونس والمغرب من جهة، مقابل الجزائر وليبيا من جهة أخرى. وأمامتفاقم الضغوطات الهائلة التي مارستها الأزمة الاقتصادية، والخوف المرتقب من تفاقمهذه الازمة عشية إلغاء الحواجز الاقتصادية، بين دول السوق الأوروبية المشتركة،سارعت دول المغرب العربي إلى تحقيق نوع من التقارب والتنسيق فيما بينها على صعيدالمشاريع الاقتصادية. في ظلالأزمة الاقتصادية الخانقة، والعزلة السياسية للأنظمة، بدأت السلطات الحاكمة فيبلدان المغرب العربي البحث في بعث وتفعيل المشروع المغاربي من جديد في أواسطالثمانينيات، عبر تطويق مجالات الصراعات والتوترات التي تفرقها، والاتجاه نحو تطبيعالعلاقات المغاربية – المغاربية. وقد توجت هذه المحاولات بعقد زعماء الدولالمغاربية الخمس في مراكش في 17 شباط 1989، والتوقيع على معاهدة مراكش المؤسسةلاتحاد المغرب العربي، وتحديد البنيات السياسية لهذا الاتحاد. لقدشكل تأسيس الاتحاد المغاربي في 17 فبراير/شباط 1987 خطوة نوعية في مسار الوحدةالمغاربية، وعقدت عدة آمال على ذلك، أقلها إيقاف الاستنزاف المتبادل بين أطرافالمجال المغاربي، خصوصا أنه جاء بعد معاناة شعوبه ودوله من سياسات المحاور الثنائيةالمتصارعة على الزعامة طيلة عقدي السبعينيات والثمانينيات. وجاءتبلور هذا المشروع إفرازا لسلسلة تطورات نوعية في المنطقة، نجملها في خمسة عناصر: أولاً، عودة العلاقات الدبلوماسية المغربية الجزائرية، بعد قطيعة دامت 14 سنة، وذلك علىإثر لقاء العام 1988 بين الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري الأسبقالشاذلي بن جديد. وهذا التقارب أشار إلى تراخي قبضة المؤسسة العسكرية الجزائرية فيتوجيه السياسة الخارجية للجزائر. ثانياً، التفاهم على تسوية نزاع الصحراء المغربية في إطار خطة استفتاء بإشراف أممي، وجرىالتفاوض على هذه الخطة طيلة 1988 ـ 1990. ثالثاً، تراجع حدة الضغط الأجنبي على المنطقة والناجم عن التقاطب الدولي بين المعسكرينالشرقي والغربي بسبب بداية تفكك المعسكر الشرقي. رابعاً، بروز تحدي التكتل الأوروبي في مواجهة دول الشمال الإفريقي. خامسا، فشل سياسات المحاور الثنائية وخصوصا بعدالتجربة المرة لمحور المغرب ـ ليبيا في مقابل محور الجزائر – تونس ـ موريتانيا،والتي أدت لإضعاف كل الأطراف. وقداستمرت هذه العناصر تحكم مسيرة الاتحاد المغربي إلى غاية اللحظة، مع تغير في العنصرالثالث حيث استبدل عامل التقاطب الدولي شرق ـ غرب بالتقاطب الفرنسي ـ الامريكي، حيثأن الوضعية العامة للاتحاد المغاربي تتغير كلما عرفت هذه العناصر تغيرات وازنة،ولهذا سنجد عند تحليلها كيف أن جمود الاتحاد هو نتاج لتحول هذه العناصر إلى عناصرمضادة وسلبية في مشروع الوحدة المغاربية، وهو ما سنبينه لاحقاً، وذلك بعد بسطحيثيات المشروع المغاربي(2). وعقدتأول قمة للاتحاد المغاربي بعد المؤتمر التأسيسي في تونس بين 21 ـ 23 كانون الثانييناير 1990، واتخذت عدة إجراءات مهمة بشأن التعاون في مجال الدفاع وتعزيز التعاونمع المجموعات الإقليمية العربية الأخرى والعلاقة مع السوق الأوروبية المشتركة الخ. .كما أصبح التعاون السياسي بين البلدان المغاربية الخمسة ممكنا ً عن طريق اتخاذمواقف سياسية مشتركة حول مواضيع الساعة فضلاً عن قبول الزعماء المغاربة أن يكونواحد من بينهم يمثلهم على الصعيد الدولي. وجاءتقمة الجزائر التي عقدت في تموز/ يوليو 1990، بعد الفوز المدوي للجبهة الإسلاميةللإنقاذ في الانتخابات البلدية، لتسجل بداية التراجع في ديناميكية الوحدةالمغاربية. ومما لا شك فيه أن الأنظمة المغاربية تخوفت كثيرا ًُ من مشاهدةالإسلاميين يصلون ديمقراطياً إلى السلطة في الجزائر، باعتبار هذا الوصول في حالتحققه فعلياً سيكون لـه وقع كبير في كل منطقة المغرب العربي، لاسيما تونس، إذ إنحركة النهضة تحتل ما بين 20 ـ 30 % من الناخبين، وتطرح إقامة السلطة الإسلاميةالبديلة في تونس. وجاءتأزمة الخليج لتبين التنوع الكبير في مواقف الدول المغاربية الخمس المختلفةوالمتعارضة أحياناً. ففي القمة العربية التي عقدت بالقاهرة اتخذت الدول المغاربيةمواقف مختلفة حول قرار إدانة العراق،موريتانيا تحفظت، المغرب لمصلحة القرار،الجزائر تحفظت، تونس لا تشارك في القمة، ليبيا ضد القرار. في ظلهذا التنوع في المواقف المغاربية حول أزمة الخليج إضافة إلى نجاح الإسلاميين فيالانتخابات البلدية في الجزائر، وما أظهرته من هوة عميقة تفصل الشعوب عن الأنظمة،واجه اتحاد المغرب العربي أول أزمة حقيقية. ومنذالانقلاب العسكري الذي حصل في الجزائر مع بداية كانون الثاني 1992 بعد فوز الجبهةالإسلامية للإنقاذ، وتدخل الجيش لإلغاء الانتخابات التشريعية، وإرغام الرئيس السابقالشاذلي بن جديد على الاستقالة، دخلت الجزائر في مرحلة الصراع المدمر بين النظاموالمعارضة الإسلامية الأصولية. وكان لهذا الوضع المأساوي الذي استمر في الجزائرطيلة عقد التسعينيات من القرن الماضي، أثره الكبير في إبطاء وتيرة اجتماعات مجالسالرئاسة لاتحاد المغرب العربي، وهي مصدر القرار الرئيس، وبالتالي في إبطاء مركبةالوحدة المغاربية. وهكذاتعثر القطار المغاربي مع بداية الأزمة الجزائرية، وتفجر أزمة لوكربي بين ليبيا وكلمن الولايات المتحدة وبريطانيا والتي تطورت إلى فرض عقوبات دولية على ليبيا في عام 1992، بسبب انكفاء الأنظمة على أنفسها لحل مشكلاتها الداخلية، بدءاً من موريتانياالغارقة في همومها السياسية والاقتصادية، مروراً بالجزائر التي تواجه حرباً أهليةطاحنة، وانتهاء بليبيا التي تطاردها أزمة لوكربي، والمغرب الذي ينشغل بأمور منهاقضية الصحراء وأثرها المباشر في احتدام صراع المحاور الإقليمية بين المغرب والجزائروالموقع الذي احتلته في استراتيجية التطويق والمحاصرة لدى كل من البلدين. وكانتليبيا قد رفضت المشاركة في الاجتماعات الوزارية للاتحاد في العام 1994 بسبب مااعتبرته تقصيراً في إظهار التضامن معها بوجه العقوبات المسلطة عليها منذ العام 1992، إثر رفضها تسلم الرئاسة للاتحاد من الجزائر عام 1995، قبل رفع الحصار الظالمعنها. لكنالاتحاد تعطل منذ قمة 1994 مع انتقال الرئاسة الدورية إلى الجزائر التي تحتفظ بها،لأن الدول الخمس لم تتمكن منذ ذلك الحين من اللقاء على مستوى القمة، على الرغم منإن كلا ً منها لا يترك مناسبة من دون الإصرار على التمسك بالبناء المغاربيوالاستعداد لإطلاق عمل هياكله قوية. صحيح أن مؤسسات تابعة للاتحاد كانت تجتمع بينفترة وأخرى، وحتى على مستوى وزاري، لكن الصحيح أيضاً أن هذه الاجتماعات كانت أقربإلى الفولكلور من اللقاءات المثمرة. ثمةإجما ع على أن الجمود في الاتحاد المغاربي يعود أساساً إلى العلاقات الثنائيةالمتوترة بين دوله، أو تشكيل محاور ثنائية أو ثلاثية يعتبرها مَنْ هو خارجها موجهةضده. وكان التوتر ينتقل من دولتين إلى دولتين أخريين، والمحاور تتشكل وتختفي بحسبالظروف السياسية، وحاجة هذا الطرف أو ذاك إلى دعم من طرف آخر تتلاقى مصلحتهماآنياً. لكن الثابت في كل هذه الشبكة من التوتر والتحالف، هو الخلاف الجزائري ـالمغربي على حل النزاع في الصحراء الغربية. فالجزائر تعتبر أن مصير المستعمرةالإسبانية السابقة من اختصاص الأمم المتحدة بوصفها "قضية تصفية استعمار"، والمغربيتمسك بسيادته عليها كجزء لا يتجزأ من وحدته الترابية. إنالانهاك والتعب اللذين أصابا المجتمع الجزائري بسبب من تعمق أزمته الداخلية، وتدهورالوضع الأمني، ألقيا ظلالاً كثيفة على مسيرة الاتحاد المغاربي، لجهة اضطرار الجزائرالتي تتولى رئاسة الاتحاد منذ أربع سنوات إلى الانكفاء على ذاتها لمعالجة أزمتها. والجزائر تظل قلب الجسد المغاربي، وأطرافه الأخرى موزعة بين المغرب وتونس وليبياوموريتانيا، وعندما يكون القلب مريضًا، ينعكس كليًا على باقي الجسم. فأصيب الاتحادالمغاربي بشكل تام وأصبحت هياكله خاوية بلا دماء تتدفق في شرايينها. واليوم، بعد 17 عاماً على ولادة الاتحاد، نجدانعدام التحرك الوحدوي حتى في المجال الاقتصادي. فلا منطقة التبادل الحر تأسست، ولاالوحدة الجمركية، ولا السوق المشتركة. وفي المقابل فإن المبادلات التجارية بينالدول الخمس المغاربية لا تتجاوز نسبة 3 في المئة من مجمل مبادلاتها الخارجية. فيحين أن هذه النسبة تصل إلى 70 في المئة مع دول الاتحاد الأوروبي. ولولم يتبادل قادة الأقطار المغاربية رسائل التهنئة بمناسبة حلول الذكرى 17 لتأسيسالاتحاد العتيد في 17 شباط 1989، لنسي الناس تماماً وجود مثل هذا المشروع المغاربيالذي بقي في مصاف الأماني، وفي مرتبة الأحلام.بقي شاهدان على ذلك اللقاء التاريخيبين زعماء الدول الخمس (المغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا) هما الرئيسالتونسي زين العابدين بن علي، وقائد ثورة الفاتح العقيد معمر القذافي. الثلاثةالباقون رحلوا. واحد إلى رحمته تعالى (العاهل المغربي الحسن الثاني) والآخر إلىمنزله بعد دفعه إلى الاستقالة مطلع العام 1992 (الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بنجديد)، والثالث إلى المنفى القطري بعد الاطاحة به في الصيف الماضي (الرئيسالموريتاني معاوية ولد سيد أحمد الطايع).هؤلاء الخمسة كانوا على موعد يوم 17 شباط 1989 في مدينة مراكش المغربية لإعلان ولادة "اتحاد المغرب العربي"، قبل أن يستقلوامعاً سيارة "الكاديلاك" المكشوفة، فيعبرون بها شوارع عاصمة المرابطين، وسط الحفاوةالجماهيرية، مُتجهين إلى مسجد "القتبية" ليؤدوا معاً صلاة يوم الجمعة، على أمل أنتُكلّل البركة الالهية مسعاهم الحميد. يبقىأن مطلب الوحدة المغاربية أصبح اليوم مطلباً أميركياً... وأوروبياً... مُلحاً،للأسباب الأمنية والاقتصادية والسياسية المعروفة، التي يجهر بها يومياً دفقالمبعوثين الذين يتوافدون على المنطقة... بلا انقطاع! 2 ـالعلاقات المغربية الجزائرية تبلورالإحباطات و علىالرغم أن الجزائر والمغرب ينتميان إلى فضاء عربي – إسلامي واحد،هو العالم العربي،والأمة العربية، ولا ينفكان يتغنيان بالروابط المشتركة بينهما :اللغة العربية،والدين الإسلامي(المذهب المالكي)، والتاريخ المشترك منذ الفتح العربي ـ الإسلامي،والجغرافيا الواحدة، والعادات والتقاليد والخصائص النفسية المشتركة،و هي كلها عوامللا تشجع على التطبيع وحسن الجوار بين البلدين فقط، بل إنها تشكل أساسا ً صلبا ً لأيوحدة اندماجية خالصة، فإنه ومنذ إستقلال الجزائر عام 1962 اتسمت العلاقات بين "البلدين الشقيقين" ـ بالعدائية في معظم مراحلها، وكانت دائما على حافة القطيعةباستثناء المرحلة الواقعة بين 1969 و1974. وقد ترجمت حالة العداء المستمرة هذهبالمواجهة العسكرية في تندوف عام 1963، وهي تضع البلدين منذ عام 1975 على حافةالمجابهة حول مسألة الصحراء الغربية. ويعود أساس هذا التناقض بين فعل الإيمانبالوحدة والعدائية في واقع العلاقات إلى النمط السلطوي في شرعنة الحكم السائد فيكلا البلدين. بالنسبة للنظام المغربي يشكل استمرار الملكيةمحوراً استراتيجيا ًتعطى لـه الأولوية. وبالنسبة للجزائر، وأقله حتى غياب هواريبومدين عام 1978، فالثورة مهددة بالفشل إذا كانت ستتوقف عند الحدود المغربية.و ماكثبان الرمل ومساحات الأرض في تندوف عام 1963 أو في الصحراء الغربية منذ 1975 سوىذرائع للمنافسة بين النظامين اللذين يرى كل منهما في الآخر تهديدا ً لـه. وكان دفاعالملكية عن نفسها إزاء معارضة الأحزاب اليسارية لها في الستينيات تماهيها مع المغربالأبدي ومصيره. أما الجزائر فقد ادعى نظامها شرعية ثورية أعاق مشروعها التحرريالتحالفات التي عقدها المغرب الجار مع مع الدول الغربية(3). ويقولالدكتور عبد الهادي بوطالب وزير الخارجية المغربي السابق عن بدايات العلاقاتالمغربية – الجزائرية، إنها كانت تبشر بمستقبل مغاير لما شهدناه طيله العقودالماضية :ابتدأت شهور العسل حيث قام الملك الحسن الثاني بزيارة مودة وتكريم وتهنئةإلى حكومة الجزائر الأولى بعد الاستقلال التي كان على رأسها الرئيس أحمد بن بلّه،واصطحب معه وفدا وزاريا كنت أحد أعضائه بوصفي وزيرا ً للإعلام. وعن كثب شاهدت وعشتجو المودة والصفاء الذي ساد الزيارة الملكية، وأضفى عليه الرئيس الجزائري حلةالابتهاج بمقدم الوفد المغربي الذي جاء حاملا لهدايا سلاح متنوع ثقيل وخفيف إلىالجزائر الشقيقة، و23 سيارة مرسيدس مهداة من ملك المغرب إلى وزراء الحكومةالجزائرية البالغ عددهم 23 وزيرا ً. وقدعبر الملك الحسن الثاني للرئيس الجزائري عن تمنياته الشخصية وتهاني المغرب باستقلالالجزائر، وقال عنه إنه امتداد لاستقلال المغرب، ووضع جميع إمكانات المغرب المستقلفي خدمة تعزيز استقلال الجزائر، مؤكدا ً على أن الدعم المغربي للجزائر المستقلةسيكون امتدادا ً لدعمه لقضية تحررها من الاستعمار الفرنسي الذي أسهم فيه المغرببسخاء. ورد عليه الرئيس الجزائري منوها بما قدمه المغرب للجزائر من دعم مادي وسندمعنوي لتحقيق تحرر الجزائر من الاستعمار. وقد كانت أغلبية الوزراء الجزائريين قضتفي المغرب فترة المنفى، ولقيت دعم المغرب وسنده بلا قيد أو شرط، ما جعل من مدينةوجدة المغربية طيلة سنوات الكفاح الجزائري بالأخص الواجهة الثانية للتحرير. خلالهذه الزيارة قبل الملك الحسن الثاني طلب الرئيس أحمد بن بلّه أن ترجئ الجزائر إعادةالتراب المغربي الممتد على حدوده الشرقية مع الجزائر الذي كانت اقتطعته فرنسا منالمغرب وضمته إلى التراب الجزائري الواقع تحت احتلالها في نطاق سياستها الاستعماريةالتي كانت تعتبر الجزائر جزءاً منها لا يتجزأ، وكانت تطلِق على الجزائر اسمالمقاطعات الفرنسية الثلاث. ولم تكن الجزائر تنازع في مغربية هذا الجزء، لكن الرئيسبن بلّه طلب إلى المغرب أن يرجى تسليمه إلى المغرب بعد أن تنهي الجزائر إقامةبنياتها الأساسية. ووافق الملك على هذا الإرجاء المؤقت، إذ كان الأهم هو أن يجددالرئيس الجزائري لملك المغرب قبوله إعادة الأراضي المغربية المغتصبة من لدنالاستعمار الفرنسي إلى صاحبها (المغرب). لكنشهر العسل هذا لم يطل إلا قليلا باندلاع حرب الرمال بين البلدين، وذلك بعد عودةالملك الحسن الثاني إلى المغرب، وعلى إثر مناوشات بين الجيشين الجزائري والمغربي. وجرت وقائع الحرب فوق الأراضي المغربية المغتصبة التي كانت ضمنها منطقة تندوف التيتؤوي اليوم الجزائر فوقها جماعة البوليساريو المتمرد ة على وطنه، وتدعمه وتسلّحهوتموّله. وعرفتالعلاقات جو الصفاء والتقارب بعد الانقلاب الذي أجراه العقيد هواري بومدين وزيرالدفاع في حكومة الرئيس الجزائري بن بلّه وأطاح فيه بحكمه. وتأسست نواة اتحادالمغرب العربي على قاعدة اقتصادية، وحرص العقيد بومدين على أن يكون التعاون المغربيحلقة أساسية في المؤسسة الاقتصادية. لكن الجزائر أصبحت بعد سنوات من التجربة تعلنأنها تفضل اتحاد الشعوب على اتحاد النظم. وبذلك تعثرت مسيرة العمل المغاربي. وفيهذه الأثناء انعقدت في السابع من آيار/مايو1970 قمة تلمسان بين المغرب والجزائر،وحضرتها بوصفي وزير خارجية المغرب ضمن الوفد الذي رافق الملك الحسن الثاني. وفي هذهالقمة صُفيت قضية الأراضي المغربية التي اغتصبتها فرنسا وضمتها إلى الترابالجزائري، وذلك بقبول المغرب التنازل عن هذه الأراضي لفائدة الشقيقة الجزائر. وسجلالاتفاق وصول الطرفين إلى وفاق لإقامة شراكة ثنائية في منجم غارة جبيلات الواقع فيالتراب المغربي المتنازَل عنه للجزائر، على أن يؤمّن المغرب للجزائر المرور عبر سكةحديدية لنقل إنتاج المنجم من ميناء مغربي على المحيط الأطلسي لتصديره وتسويقه. ولمتنفذ الجزائر للمغرب التزاماتها، ولم يلحّ المغرب على الجزائر للوفاء بوعدها، مفضلاً ألا يثير مع الجزائر ما من شأنه أن يعكر الجو السياسي بين الجارتين. وأثناء انعقاد القمة العربية في المغرب أعلنالرئيس هواري بومدين أمام القادة العرب أن الجزائر تساند المغرب في مطلبه استرجاعالصحراء المغربية، وأنها لا طمع لها فيها، وأنها تؤيد بشأنها ما يتفق عليه الطرفانالمعنيان: المغرب وموريتانيا، وأنها على استعداد لتقديم سند عسكري للمغرب من أجلتحرير الصحراء ومدينتي سبتة ومليلية من الاستعمار الإسباني. بيد أن العلاقات دخلتفي أزمة كبرى امتدت إلى اليوم بعد تحرير المغرب أقاليمه الصحراوية بالمسيرة الخضراءوإبرام المعاهدة الثلاثية مع إسبانيا في مدريد، إذ ظهرت الجزائر كاشفة عن وجههالتعلن أن المغرب لا حق لـه في الصحراء التي ينازع في مغربيتها جماعة "البوليساريو" المتمردة. كما طالبت ـ ولا تزال ـ بتخويل الشعب الصحراوي (أي شعب ؟) حق تقريرالمصير. وتبنت الدفاع عن مطلب البوليساريو لدى هيئة الأمم المتحدة، وأصبحت الناطقباسمه في المحافل الدولية. وهو ما حوّل أزمة العلاقات إلى قطيعة مستمرة، وشلّ مسيرةالاتحاد المغاربي، وأصبح انعقاد مؤسساته مستحيلا في جو مواجهة الجزائر لحق المغربفي استرجاع صحرائه، وهو المطلب الوطني الذي ينعقد عليه الإجماع المغربي. وبالرغم منزيارة الملك محمد السادس للجزائر مرتين، وعرضه على الرئيس بوتفليقة تحييد دعمالبوليساريو، ووضع هذا الملف على الرف ولو مؤقتا، وبالرغم من فتح المغرب الحدود،وإلغاء التأشيرة بالنسبة للمواطنين الجزائريين، فإن الجزائر لم تجب على التحياتالمغربية إلا بقبلات مسرحية كان يتقن الرئيس بوتفليقة إطالتها على وجه شقيقهالمغربي. ولا يزيد الأمر على ذلك(4). ومنذرحيل الاستعمار الفرنسي عن أرض الجزائر، لم يشهد تاريخ العلاقات بين الدولالمغاربية سوى تراكم العقبات التي تعترض سبيل بناء وحدة المغرب العربي، إلى درجةأنه يمكن القول أن سد هذه العقبات أصبح يحجب أطول الأعناق عن التمتع بالنظر إلى حلمالوحدة المغاربية، أهمها قضية الصحراء وهي محل خلاف بين المغرب والجزائر. ولكيتنجلي الصورة أكثر لا بد من العودة للوراء قليلا حتى نعرف طبيعة المشكلات بين دولالاتحاد التي خرجت من الصراع مع المستعمر لتدخل في صراع مع بعضها مبكرا ً، فبعد سنةواحدة من استقلاله شكّل المغرب جيشا ًَ لتحرير موريتانيا كان من أشهر معاركه معركة "تكل"، وفي سنة 1960 حصلت موريتانيا على استقلالها، وهو ما رفضه المغرب ودشن أولصفحة خلافات بينه وبين تونس التي اعترفت بموريتانيا، ثم بعد سنة واحدة من استقلالها 1962 اندلعت الحرب سنة 1963 بين المغرب والجزائر على الحدود. ورغم أن الحرب استمرتلفترة قصيرة توجت باتفاقية إلا أن البرلمان المغربي لم يصادق على تلك الاتفاقية حتىالآن. وقد دشُن في هذه الفترة المبكرة صراع على الزعامة في المنطقة بين المغربوالجزائر أصبحت فيه دول الاتحاد الأخرى تتبادل الدوران في فلك كل منهما لفترة حسبالمصالح والظروف، فقد ساءت العلاقات بين بورقيبة وبومدين ثم دخل القذافي على الخطسنة 1969 بعد دعمه للمحاولة الانقلابية التي جرت ضد الحسن الثاني سنة 1971 لتظلالعلاقات بين الدولتين سيئة ثم جاء النزاع على الحدود بين ليبيا والجزائر. واستمرتالمنغصات إلى أن جاء ما يسميه الجميع بكارثة الصحراء الغربية سنة 1975 لينقسمالمغرب العربي إلى محورين: محور المغرب ـ موريتانيا ومحور الجزائر ـ ليبيا اللتينتدعمان استقلال الصحراء الغربية، ورغم أن موريتانيا خرجت من الصراع المباشر سنة 1979 بتخليها عن حقوقها في الصحراء مقابل السلام فإنها لم تفلح بالنأي بنفسها عنذلك النزاع. كما لم تتمكن "ثورية" القذافي من التعايش مع معظم طبيعة أنظمة دولالاتحاد. كماأن العلاقات بين الأخوين اللدودين في المغرب العربي، الجزائر والمغرب، لم تعرف حالةمن التطبيع الكامل، بل إن العلاقات بين البلدين عرفت مراحل من المد والجزر لاينتهيان. علما أن التطبيع الكامل بين المغرب والجزائر يمثل شرطاً أساسياً من شروطالنهوض باتحاد المغرب العربي، ومطلباً دولياً يجتمع عليه الموفدون عبر المتوسط وعبرالأطلسي. ويقدّم الصحافي المغربي محمد الأشهب سرداً تاريخياً للعلاقات بين البلدين الجارينوتفاصيل الخلافات بينهما(5): في إحدى زياراته القليلة الى الجزائر بعد تولي العاهلالمغربي الملك محمد السادس مقاليد الحكم في 1999، سمع مسؤول مغربي كلاماً من مراجعجزائرية عليا مفاده أن المغرب أخطأ في اختيار حليفه في منطقة شمال افريقيا. وجاءالكلام في صيغة عتاب "تعاونتم مع الضعيف وتركتم القوي" في إشارة الى التنسيق الذيساد الخطوات الأولى لضم الصحراء بين المغرب وموريتانيا. وقتها رد المسؤول المغربيباستحضار وقائع اجتماع تاريخي ضم كلاً من الملك الراحل الحسن الثاني والرئيسالجزائري الراحل هواري بومدين والرئيس الموريتاني الراحل المختار ولد داده فيالمدينة السياحية أغادير على الساحل الأطلسي للمغرب. ونقل فيه القول عن بومدين ان"لا مطامع للجزائر في الصحراء" وأنه يدعم أي تنسيق بين الأطراف المعنية في مواجهةقرار إسبانيا وقتذاك منح حكم ذاتي لسكان الساقية الحمراء ووادي الذهب، يبقيها تحتسيطرة مدريد. وزاد المسؤول المغربي أن الجزائر أقرت صراحة في القمة العربية التياستضافتها الرباط عام 1974 ان "لا مشكلة بينها وبين المغرب في قضية الصحراء". ويحتفظ المغاربة بتسجيل صوتي للرئيس بومدين بهذاالمعنى يقول فيه باللهجة المصرية "بين المغرب والجزائر مافيش مشكل". لكن الموضوعسيرتدي طابعاً آخر بعد صدور الحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول وجود روابط "بيعة وولاء" بين سكان الإقليم والسلطة المركزية في الرباط. وفي الوقت الذي عمدتفيه إسبانيا إلى استمالة شبان يتحدرون من أصول صحراوية لتأسيس جبهة "بوليساريو" إلىجانب بعض الأحزاب السياسية الموالية لإسبانيا على طريق اكتمال خطة الحكم الذاتيالذي رهنته بموافقة "الجماعة الصحراوية" ـ أي البرلمان الصحراوي وقتذاك ـ كانتالجزائر تعمل بتنسيق مع الإسبان لتأمين هجرة مضادة لسكان الصحراء نحو مراكز تيندوفجنوب غربي الجزائر، إذ تزامنت عمليات الهجرة مع دخول القوات المغربية في شباط (فبراير) 1976 إلى الصحراء على خلفية انسحاب القوات الاسبانية منها. لكن الردالجزائري كان أكثر عنفاً من خلال الإعلان عن تأسيس "الجمهورية الصحراوية" من طرفواحد، ما حدا بالمغرب إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع الجزائر. وإذيقول الرسميون الجزائريون إن توغل قوات عسكرية جزائرية في منطقة "أمفالا" القريبةشرقاً إلى تيندوف كان بهدف تقديم المواد الغذائية والأدوية للاجئين الصحراويين،تشير وقائع مواجهتين عسكريتين في المنطقة ذاتها إلى معطيات أخرى، هي نفسها التيستتكرر في منطقة الداخلة جنوب المحافظات الصحراوية عندما توجهت قوات من مقاتلي "بوليساريو" (تحت قيادة جزائرية) إلى هناك بهدف فرض السيطرة على الإقليم إثر انسحابموريتانيا عام 1979، حين قتل زعيم الجبهة الوالي مصطفى. ويقول رسميون مغاربة إنقادة بعض الدول العربية تدخلوا عام 1976، وفي مقدمهم الرئيس المصري حسني مبارك،وكان وقتذاك نائب الرئيس أنور السادات، لإطلاق الأسرى الجزائريين المعتقلين فيمواجهتي "أمفالا" في مقابل حدوث انفراج بين المغرب والجزائر. بيدأن قمة يتيمة على الأقل جرى البحث في تنظيمها لتجمع الحسن الثاني وبومدين فيبروكسيل عام 1979 لم يكتب لها الالتئام، رغم تحديد موعد أولي كان تصادف واحتفالاتالمغرب بعيد الشباب. وتعرض بومدين بعد ذلك إلى أزمة صحية نُقل على أثرها إلى موسكوليعود منها في غيبوبة كاملة. احتاجالأمر، في غضون ذلك، إلى حوالي أربع سنوات لعقد القمة الأولى بين الملك الحسنالثاني والرئيس الشاذلي بن جديد الذي قال عنه الملك الراحل يوماً "لقد أجبر علىتولي رئاسة الجزائر"، غير أنه وجد فيه محاوراً أعاد ملف العلاقات المغربية ـالجزائرية إلى الواجهة من خلال حدثين، أولهما تجديد العمل باتفاق ترسيم الحدود ضمنمعاهدة حسن الجوار المبرمة بين البلدين عندما اجتمع إلى الملك الحسن الثاني فيالمنتجع الشتوي في ايفران عام 1988، والثاني اجتماع العاهل المغربي إلى قياديين فيجبهة "بوليساريو" للمرة الأولى في مراكش في حضور الرجل الثاني في الجبهة بشير مصطفىالسيد، ما مهد الطريق أمام انعقاد القمة التأسيسية للاتحاد المغاربي في مراكش فيشباط (فبراير) 1989. لكنالاختراق على صعيد تحسين العلاقات الثنائية وبدء التعاون المغاربي انطلق قبل ذلكبمعاودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، لم يعمر طويلاً نتيجة استقالة الرئيسبن جديد تحت ضغط الأزمة الداخلية في بلاده الناتجة أصلا عن ظهور جبهة الانقاذالجزائرية التي اكتسحت انتخابات البلديات وتعطيل المسار الانتخابي عام 1992. وقتهاأسرّ زعيم "الانقاذ" عباسي مدني إلى صحيفة "الحياة" أنه يدعم التقارب بين المغربوالجزائر ولا يرى حلاً لقضية الصحراء خارج السيادة المغربية. وحرص الملك الحسنالثاني لدى زيارته الجزائر وقتذاك على الاجتماع إلى زعماء الأحزاب السياسيةالجزائرية. لكن الموقف الذي التزمه عباسي مدني سيجد امتداده في التصريحات الصادرةعن مراجع مغربية حول إمكان الإفادة من دور جبهة الإنقاذ الجزائرية في دعم الخيارالديموقراطي، وبالقدر نفسه سيتحول الخلاف حول التعاطي مع الظاهرة الإسلامية إلى سببآخر يعطل الانفراج في علاقات البلدين. وفيالوقت الذي بدأ فيه حوار مغربي ـ جزائري من نوع آخر على خلفية المسألة الإسلاميةمتمثلاً في طلبات جزائرية لتسليم معارضين إسلاميين في مقدمهم الناشط عبدالحقالعيادة (أمير الجماعة الإسلامية المسلحة)، دار على واجهة أخرى حوار بين المؤسسةالعسكرية الجزائرية والمعارض الجزائري محمد بوضياف الذي كان يقيم في مدينة القنيطرةالمغربية ويدير مصنعاً للبناء، وقد حرص لدى مغادرته المغرب ليصبح رئيساً للجزائريتمتع بالشرعية التاريخية، على تأكيد التزامه إيجاد حل سريع لنزاع الصحراء. غير أنالرصاص الذي صوب نحوه في قاعة اجتماع في عنابة في حزيران (يونيو) 1992، طالت شظاياهالعلاقات بين البلدين. ولم تكد تمر شهور حتى اندلعت أزمة حادة بين الجارين، إذ تورطرعايا من أصول جزائرية ومغربية في هجمات فندق أطلس أسني في مراكش التي انعكستتداعياتها سلباً على علاقات البلدين عام 1994. فقد فرض المغاربة نظام التأشيرة علىالرعايا الجزائريين وردت الجزائر بالمثل، وزادت عليها قرار إغلاق الحدود البرية في صيف 1994. عندماتوفي الملك الحسن الثاني في تموز عام 1999، انتقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقةالمنتخب حديثاً في هذه المناسبة إلى الرباط، حيث تكلم بحرارة عن مستقبل العلاقاتبين البلدين، قابله استعداد مماثل من الملك الشاب محمد السادس لبدء عهد جديد معالجزائر.و اعتقد الجميع أن مناخاً دافئاً جديداً من العلاقات بين البلدين سيستمر،بيد أنه في اليوم الذي أعلن فيه فتح الحدود البرية الذي تحدد موعده في 20آب1999،حصلت مجزرة رهيبة راح ضحيتها 36 مدنياً على يد الجماعة الإسلامية المسلحة التي تقولالجزائر أن لها قواعد خلفية في المغرب.فتبخرت كل الأمال التي كانت معلقة على معاودةالتطبيع بين المغرب والجزائر من جديد. فماهيالعوائق البنيوية التي حالت ولا تزال تحول دون التطبيع الكامل؟ 1 ـلقد ورثت البلدان المغاربية الثلاثة (تونس، الجزائر، المغرب) حدوداً متفجرة، بفعلالتقسيم الكولونيالي الفرنسي ـ الإسباني لهذا الجزء الغربي من العالم العربي. وكانتفرنسا القوة الاستعمارية السائدة تعتقد أن الجزائر أصبحت جزءا من إمبراطوريتها، لذاراحت تقضم من الأراضي التونسية والمغربية لضمها إليها. وهذا ما جعل المغرب والجزائريتواجهان عسكرياً في حرب تندوف الصحراوية عام 1963.كما أن هذا الموروث من التقسيمالكولونيالي وضع البلدين على حافة المواجهة العسكرية حول مسألة الصحراء الغربية عام 1975. [/align] |
|
|
|

|
|
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| إحياء، تأجيل،المغرب العربي، اتحاد |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| أدباء من المغرب العربي (1) | محمد الصالح الجزائري | متفرقات | 10 | 05 / 03 / 2021 53 : 12 PM |
| إصدارات جديدة لأعضاء اتحاد كتاب المغرب | زين العابدين إبراهيم | الشؤون المغاربية | 0 | 15 / 12 / 2014 05 : 12 PM |
| سوريا/ في رحاب وطننا العربي.. اطلالة تاريخية/ الفتح العربي الإسلامي | مازن شما | الجغرافيا والسياحة العربية | 0 | 29 / 01 / 2014 39 : 02 AM |
| انتقادات سياسية للمهرجانات الثقافية في المغرب | نجاة دينار | الشؤون المغاربية | 0 | 07 / 08 / 2008 21 : 10 PM |
| منتديات قصص المغرب العربي | عبده حقي | قال الراوي | 0 | 19 / 07 / 2008 07 : 03 PM |
الساعة الآن 02 : 11 PM
|
|

















