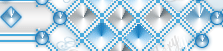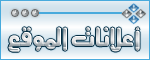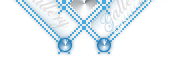|
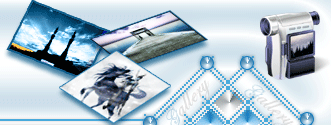 |
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
رقم المشاركة : [1] | |
|
أديب وناقد - باحث متخصص في السياسة والأدب الإسرائيليين- قاص وأديب وناقد -أستاذ مادة اللغة العبرية - عضو الهيئة الإدارية في نور الأدب
          
|
ميت في إجازة!!!
القصة العاشرة والأخيرة في مجموعتي التي حملت نفس عنوان هذه القصة وهو (ميت في إجازة)، الصادرة عن دار المسبار، في دمشق، (2004)
[align=justify]حين خرجتُ من قبري، صبيحةَ ذلك اليوم الصيفي المشمس، قاصداً شاطئَ البحر لقضاء إجازةٍ قصيرة انتظرتُ الموافقة عليها، أكثرَ من خمسِ سنوات، استوقفني حفيدُ أحدِ الجرذان المحترمين الذين تغذَّوا ذات يوم بجثتي، ورجاني أن أصطحبه معي، في تلك الإجازة ليرى البحر بأمِّ عينه، ولو لمرة واحدة، بعد أن رآه على صفحة خياله النَّشِطِ في الحكايات الكثيرة التي حكيتُها له، منذ أن اختار قفصي الصدري العاري من اللحم تماماً، مسكناً له... ومع أنِّي كنتُ شديدَ الرغبة في قضاء إجازتي الأولى، بعد الموت، منفرداً، على شاطئ منعزلٍ، عَزَّ عليَّ أن أكسرَ بخاطر ذلك الجرذ الذي يَسكُنُني، منذ نحو سنة ونصف تقريباً؛ لكنَّني، وانطلاقاً من طيبتي التي اشتهرتُ بها، قبل أن أموت، حسمتُ أمري، واتخذتُ قراري، وأخبرتُه بأنَّ عليه أنْ يُجهِّزَ نفسَه للسفر معي إلى شاطئ البحر، وعلى نفقتي الخاصة... وما كاد ذلك الجرذ يطيرُ من الفرح بقراري، حتى عَنَّ لي سؤال، ألقيتُه عليه، وأنا لا أدري بأنَّه سيقلبُ فرحَه المفاجِئَ إلى حيرةٍ مفاجئة امتزجَتْ بكثير من الخيبة التي ظهرتْ علاماتها على مُحَيَّاه الأليف، إذْ ما كاد يسمعني أسألُه بلهجةٍ باديةِ الاهتمام: - هل لديك مايوه؟ حتى بُوغِتَ، واهتزَّ شاربُه الطويل من طرفيه... ذلك الشاربُ العزيز عليَّ كثيراً، لأنَّه طالما ذكَّرَني، وأنا في قبري، بشواربِ قبضايات حارتي التي كنتُ أقيم فيها، وأنا على قيد الحياة، ثم احتقنَتْ عيناه بالدموع، وهو يرفعُ يديه الصغيرتين مُبدِياً حيرتَه وعجزَه عن الجواب والعثور على مخرجٍ من هذه المعضلة التي لم تخطرْ له على بال... ثم قال لي بأسى: - وهل المايوه ضروري كثيراً؟ فهززتُ جمجمتي التي فرغَتْ إلَّا من بعض ذراتِ التراب، علامةَ الموافقة، وقلت: - بالتأكيد يا عزيزي.. فعلى شواطئنا، ما يزال الناس محافظين يرفضون ظهور أيِّ مخلوق عارياً.. لو كنا في أوروبا مثلاً، لكان الأمر بسيطاً للغاية، فهناك لديهم شواطئُ للعراة، ولا فرقَ هناك بين مخلوق ومخلوق، أيْ بين إنسان وجرذ محترمٍ مثلك، ذلك أنَّ ظهورَ أيِّ مخلوق عارياً، لا يُفْقِده شيئاً من احترامه.. وفُوجِئْتُ به يَتَنَهَّد من قلب محروق، وهو يقول لي: - آه... يا ليتنا كنا هناك.. - نعم، ولكن المشكلة أنَّنا هنا، وهنا لا توجد شواطئ للعراة، وهذا يعني أنَّه يجب عليك العثورَ على مايوه، إذا كنتَ سترافقني.. - وإذا لم أَجِد؟ صَمَتُّ لحظةً، قبل أن أجيبَ بنبرة يائسة: - لن تذهبَ معي... في الواقع، والحقُّ يُقال، آلَمَنِي ما سَبَّبْتُه له من انزعاج واضطراب، فَرُحْتُ أبحثُ في تلافيفِ عقلي عن مخرج، وسرعان ما عثرتُ على الحلّ، فقلتُ له بلهجةٍ أشبه بلهجة (أرخميدس) حين اكتشف الدافعة التي اقترنَتْ باسمه: - وجدتُها...! ولأنَّه لم يَنَلْ حظاً كافياً من التعليم، إذْ أنَّ معارفَه العلمية لا تتعدَّى معارفَ أيِّ خريج جامعي حديث التخرج، في العالم الثالث، لم ينتبهْ إلى وجهِ الشبه بين وجدتُها الأرخميدسية، ووجدتُها التي نطقَ بها لساني أمامه، فبادرَني إلى السؤال، وهو يبحثُ بعينيه عن شيءٍ ظنَّني أضعتُه: - ماذا وجدْتَ؟ فقلتُ له موضحاً: - الحلّ لمشكلة المايوه الذي لا تملكه.. وما كاد يسمع ذلك مني، حتى عاد وجهُه يتهللُ فرحاً، وهو يسألني بلهجةِ مَن لا يُصدِّق ما سمعَتْه أذناه: - حقاً؟ وأين؟ قلتُ له بثقة اعتادَها في كلامي: - لا عليك... اذهبْ إلى القبر المجاور لقبري... فقاطعني مُستنكراً، وكأنَّه قرأَ ما جَالَ بفكري: - تقصدُ قبرَ ابنكَ الذي دُفِنَ البارحة بجوار قبرك؟ تجاهلْتُ استنكارَه الساذج، وقلتُ لا مبالياً: - نعم.. - ولماذا؟ فنهرتُه مُتصنعاً الغضبَ، لأقطعَ عليه سيلَ أسئلته الحمقاء: - إذا ظللْتَ تقاطعني على هذا النحو، فلن أخبرَك بما يجبُ أن تفعلَ لتحصلَ على مايوه، وأنتَ تعلْمُ ما يعني هذا... فصمَتَ على مضضٍ، كما تَهَيَّأَ لي، ثم قال: - أَعْتَذِرْ... تابعْ من فضلك... فتابعتُ أقول، وأذناه تُتابعان مذهولتين ما يسمع: - اذهبْ إلى قبره، ومَزِّقْ قطعةً من كفنه، ثم عُدْ بها إليّ، وأنا سأصنعُ لك منها مايوه بنفسي..! - ولكنْ...... إنَّه ابنك...! - أيُّها الأبله.. وهل تظنُّ أنَّه بحاجة إلى الكفن، بعد أن مات؟ الكفنُ يا صاحبي أحدُ تفاهات الأحياءِ التي لا مُسَوِّغَ لها، فهيَّا أَطِعْنِي واذهبْ، قبل أنْ أغضبَ منك.. ولم ينتظر لسماع المزيد، فقد امتدَّ البحرُ في مخيلته، أزرقَ رائعاً، فقفزَ من أمامي، وتَسَلَّلَ إلى قبرِ ابني، وما هي إلا برهة قصيرة، حتى عاد يحمل بفمه مِزْقَةً كبيرة من كفنه، وَضَعَها أمامي، ووَقَفَ مُنتظراً كيف سأُحَوِّلُها إلى مايوه.. فالتقطْتُها بلا مبالاة، ثم رَبَطْتُها على خصرْه ومَرَّرْتُ أحدَ أطرافِها من بين ساقيه القصيرتين، ثم عقدْتُ هذا الطرف بمحيطها الذي زَنَّرَ خصرَه، ثم قلتُ له مُبتهجاً: - ها أنتَ لديكَ مايوه أخيراً، وبإمكانكَ مرافقتي إلى البحر الآن، فهيَّا...[/align] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ [align=justify]على الشاطئِ الرمليِّ المكتظِّ بالسابحين والسابحات، من مختلف الأعمار والألوان، بحثْتُ طويلاً عن مكان مُنعزِلٍ، وحين وجدْتُه بعدَ طولِ عناء، سارعْتُ أستلقي على رملِه الدافئ، مُستمتعاً بأشعة الشمس التي غَمَرَتْ نفسيَ العاريةَ تماماً، بعد أنْ تركتُ بقايا عظامي في القبر، مُقَرِّراً قضاءَ إجازتي الأولى خارجَه، دون أيِّ ستار، لأنَّني كنتُ مُطمئناً إلى أنَّ أحداً لن يراني، بعد أنْ صِرْتُ مخلوقاً شفافاً، لا تُدركُه أبصارُ الأحياء، على الرغم من أنَّه يراهم بوضوح.. أمَّا الجرذُ اللطيف الذي كان يسكنُنِي في القبر، فقد استلقى هو الآخر على الرمل مُعتَزّاً بمايوهِه الغريب الذي لَفَتَ نظرَ معظمِ روادِ الشاطئ، أثناءَ جولانِنا بينهم، ونحن نبحثُ عن مكان منعزل، وكان مصدرُ فخرِهِ بذلك المايوه، ما سَمِعَهُ من بعضهم وبعضهنّ، من عباراتِ الإعجاب وتَهَامُسهم بالرغبة في اقتناء مايوه مماثل له... بعد أن مضى علينا وقتٌ طويل، ونحن نستلقي صامتين مُتَأَمِّلَين روعةَ البحر الصافي، تَنَحْنَحَ صديقي الجرذ، وبعد قليل من التَّرَدُدِ، قال لي بلهجة خجولة: - هل لديكَ سيجارة؟ - لا.. ولماذا تسأل؟ - المنظرُ هنا، وهذه الجلسة الشاعرية قبالةَ البحر، جعلتني أشتهي تدخينَ سيجارة...! - ومنذ متى تُدخِّن؟ - في الحقيقة أنا لا أُدخن، إلَّا إذا كنتُ في جلسةٍ شاعرية كهذه.. - يا لكَ من مُخادِع.. ومتى جلستَ مثلَ هذه الجلسة قبل الآن؟ سَعَلَ محاولاً مداراةَ حَرَجِهِ، ثم قال: - الحقَّ أقولُ لك، رأيتُ الجميعَ هنا يُدخِّنون، فقلتُ أفعلُ مثلهم.. - لا.. لا تفعل.. وإلا اعتبرْتُك جرذاً قليلَ التهذيب... فكما أعلمُ يُعتبَر التدخينُ بين أبناء جنسِكَ من الأمور المعيبة والمُخِلَّةِ بالأخلاق العامة... - نعم.. أنا آسف.. ثم، وبعد لحظة صمتٍ أخرى، قال لي، وكأنَّه يُتابِع ما انقطعَ من حديثه: - ولكنَّني أشعرُ بالملل، فماذا أفعل؟ - لا أدري.. - هل معك جريدة لأتَسَلَّى بقراءتها؟! - لا... فأنا، كما تعلم، لم أَعُدْ أقرأُ الجرائد منذُ وفاتي، ولهذا تَحَسَّنَتْ صحتي النفسية كثيراً... - ماذا تعني؟ - الجرائد لا تأتيك إلا بالأخبار السيئة، ولهذا أنصحُكَ بعدم قراءتها... - إذاً ماذا أفعل؟ - انزلْ إلى الماء، واسبحْ قليلاً... - فكرة جيدة لا بأس بها، لماذا لم تخطرْ ببالي؟ - حسناً نَفِّذْهَا إذاً، مادامتْ جيدة.. وهكذا، نزلَ الجرذُ إلى الماء، لكنَّه لم يَغِبْ طويلاً، إذ رأيتُه يعودُ مُسرعاً، بعد عدة دقائق، وهو يلهثُ انفعالاً وخوفاً، وراحَ يقفزُ أمامي، وهو يصرخُ بصوته الحاد، قائلاً: - رأيتُ رجلاً على تلك الصخرةِ يَهِمُّ بقتلِ رجلٍ آخر.. فقلتُ آتي إليكَ لتذهبَ معي، عساكَ تُنقذه.. وحين وجدَ أنَّ كلامَه لم يحرِّكْ فيَّ ساكناً، انفعلَ، ونَسِيَ تهذيبَه في مخاطبتي، وقال: - ماذا؟ أقولُ لكَ إنَّ جريمةَ قتل ستقع، وأنتَ لا تتحركُ، كأنَّك لم تسمع؟! - نَفَخْتُ بغيظٍ، وقلتُ له: - لماذا تفسدُ عليَّ إجازتي بمثل هذه التفاهات؟ - تفاهات؟! - نعم تفاهات الأحياء.. وماذا إذا قتلَ رجلٌ رَجلا؟ إنَّ القتلَ عاديٌّ في الدنيا، وخصوصاً هذه الأيام؛ فلماذا تُحَمِّلُ الموضوعَ أكثر مما يَحْتَمِل. دَعْكَ منهما واستمتعْ بإجازتكَ، وكأنَّكَ لم تَرَ شيئاً..! - يا إلهي.. أَيُعْقَلُ أنَّك قليلُ الإحساس إلى هذه الدرجة؟! - احتفظْ بأدبكَ في مخاطبتي... فقد تجاوزتَ حدودَكَ.. - ولكنْ جريمة.. فقاطعتُه مُتصنِّعاً الغضب: - كُفَّ عن هذيانك... أتعلمْ؟ إنَّ الذي يجب أنْ تُشفِقَ عليه هو القاتل وليس المقتول! تسألنُي لماذا؟ حسناً.. أنا سأُخبرك، ولكنْ قبل ذلك أريدُ أن أستحلفَك بشرفِكَ الجرذِيِّ، وبشاربيك الضخمين هذين، هل رأيتَني غيرَ سعيد، ولو لدقيقةٍ واحدة، طيلة فترة مُساكَنَتِكَ لي في قبري؟ - الشهادة لله.. لا؟ - هذا يعني أنَّ موتَ الإنسان، في هذا العصر، خيرٌ له من حياته...! فلماذا تُريدني أنْ أمنعَ إنساناً مثلي من التَّمتُعِ بسعادة الموت؟ أُقسمُ لك أيُّها الجرذُ العزيز أنَّنا نحن الأموات، في سعادةٍ لو دَرَى بها الأحياءُ لقاتلونا عليها بالسيوف والمدافع والقنابل الذرية أيضاً...! - ولكنها جريمة.... - يوه.. لماذا أنت مصرٌّ على إفساد إجازتي؟ - لا والله.. ولكنِّي أعجَبُ ممَّا أسمعُه منك وأنتَ منْ كنتَ قبل الموت... أتذكرْ أنَّكَ قضيتَ حياتَكَ كلَّها مُدافعاً عن المظلومين، وأنَّكَ قُتلتَ وأنتَ تُدافعُ عنهم، ولأنَّك تُدافعُ عنهم؟ - اسمعْ.. لقد نَفَدَ صبري.. يجب أنْ تفهمَ أنَّني الآن ميت، ولا يعنيني عالمُ الأحياء بشيء.. - ولكنَّه يعنيني.. فأنا ما زلتُ حيّاً، وسأمنعُ تلك الجريمة بأيِّ شكل، حتَّى لو كَلَّفَني ذلك حياتي... وقبل أن أصرخَ به، أَنِ ارْجِعْ يا مجنون، كان قد قفزَ إلى الماء قفزةً يَحسدُه عليها أبرعُ الغطَّاسين، مُتجهاً إلى حيث قال إنَّ جريمةً ستقع.. عند ذاك، اضطررتُ لإخراج نفسي من متعةِ الاستلقاء في أشعة الشمس، واللحاق به، لا لأمنعَه من التَّهَوُّرِ وارتكاب حماقةٍ لن تعود عليه بغير الضرر، جَرَّاءَ تَدَخُّله فيما لا يعنيه، ولكنْ لأشهدَ تلك المعركةَ الطريفة بين جرذ نبيل الطباع وإنسان قاتل... [/align] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ [align=justify]هناك، على صخرةٍ بعيدة، جلستُ على قمَّتِها أنظرُ إلى الجرذ الذي وقفَ مُتَحَدِّيّاً القاتلَ الذي تركَ ضحيتَه، وراح يحاولُ قتلَ الجرذِ أولاً... وبعد محاولة أو محاولتين فاشلتين، تَمَكَّنَ الرجلُ الذي كان في موضع الضحية من تَمَالُكِ نفسه واستعادة قواه، فبادرَ إلى مهاجمةِ قاتلِه الذي لم يستطعْ أن يتفادى ضربةً وَجَّهَها إليه خصمُه بحجرٍ كبير على أُمِّ رأسه، فَخَرَّ الذي كان قاتلاً، قبل قليل، قتيلاً.. وكان الفضلُ في ذلك يعود لجرذي الذي صَفَّقْتُ له إعجاباً.. وفيما هو ينظرُ إليَّ مُفتخِراً بما فعل، فُوجئنا معاً بالرجل الذي أَنقذَهُ جرذي وهو يَهمُّ بإلقاءِ حجرٍ كبير آخر على رأسِ الجرذ ليقتلَه.. وللأسف، لم يستطعْ الجرذُ المسكين أنْ يتفادى ذلك الحجر الذي سَحَقَ جمجمتَه فوراً، فَخَرَّ صريعاً على أرض المعركة مُضَرَّجاً بدمه. وما هي إلَّا دقائق، حتى غادرَ جثتَه، واتجهَ نحوي وهو يقول بلهجة كسيرة أَسْيَانَة: - لقد كنتَ مُحِقّاً، فهيَّا بنا نَعُدْ إلى القبر..! وما كدنا نخطو بضعَ خطواتٍ باتجاه المقبرة، حتى سمعنا صوتَ القتيلِ يُنادينا بتَوَسُّل: - انتظراني، لأرافقَكُما إلى المقبرة، فأنا سريعُ المللِ من المشي وحدي...[/align] دمشق في 1997/10/5 نور الأدب (تعليقات الفيسبوك) |
|
|
|

|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [2] | |
|
كاتب نور أدبي مضيئ
        
|
رد: ميت في إجازة!!!
أستاذي العزيز
بعيدا عن الأدب والسرد واللغة والقصة والحبكة والقفلة فأنا أحيك على الفكرة والمعنى والتأويل فقد أبدعت في ايصال رسالتك بطريقة تهكمية ساخرة رائعة كل الاحترام |
|
|
|

|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [3] | |
|
أديب وشاعر جزائري - رئيس الرابطة العالمية لشعراء نور الأدب وهيئة اللغة العربية -عضو الهيئة الإدارية ومشرف عام
            
|
رد: ميت في إجازة!!!
[align=justify]دعني أستمتع أولا..ولي عودة تليق .. سأنسخ القصة أولا لأقرأها دون تشويش وكأني كاتبها يريد المراجعة (ابتسامة)..تحيتي وتقديري..[/align]
|
|
|
|

|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [4] | |
|
أديب وشاعر جزائري - رئيس الرابطة العالمية لشعراء نور الأدب وهيئة اللغة العربية -عضو الهيئة الإدارية ومشرف عام
            
|
رد: ميت في إجازة!!!
[frame="1 98"][align=justify]قصّة طريفة ، مليئة بالمفاجآت.. حملتْ الكثير من الأفكار في قالب ساخر ماتع ! أخي الأكبر الدكتور الصواف..حتى في قصصك تعمد إلى جرّ القارئ إلى إعمال فكره وعقله قبل حواسه الأخرى..فالعنوان ، مثلا ، مدعاة للتفكري العميق.. فعلا فنخن والأموات في إجازة ، لا ندري متى تنتهي! والجرذ الذي يسكنك ، أعني يسكن القاص (ابتسامة) من سلالة نبيلة.. وهذا من خلال موقفه مع المتناحريْن .. في القصة جوانب عديدة تصوّر وبذكاء كبير واقع الإنسان في هذا العصر..فاختيار قضاء الإجازة على شاطئ البحر ، واختيار الجرذ رفيقا ، وأخذ قطعة من كفن الابن ، وبداية القصة بميّت واحد ونهايتها بثلاثة ـ له أكثر من دلالة ! باختصار شديد قصة أكثر من رائعة ! ودون مجاملة أسلوبك يمتعني كثيرا ، لذلك أستغرب ما الذي يجعل أعضاء المنتدى لا يهتمّون بقصص الدكتور الصواف ؟! شكرا لك على متعة القصّ وعمق الدلالة وروعة السرد..تحيتي وإعجابي..[/align][/frame]
|
|
|
|

|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [5] | ||||||||||||||||||||||||
|
أديب وناقد - باحث متخصص في السياسة والأدب الإسرائيليين- قاص وأديب وناقد -أستاذ مادة اللغة العبرية - عضو الهيئة الإدارية في نور الأدب
          
|
رد: ميت في إجازة!!!
[align=justify]أخي الحبيب محمد الصالح، أسعد الله أوقاتك بكل خير.. أعتذر عن التأخير بالرد، والسبب أنني لم أنتبه لتعليقك القيم هذا على قصتي، بسبب إسهال المواد السخيفة التي يمطرنا بها صاحبك، والذي يطرد عناوين موادنا بسرعة فائقة من شريط المشاركات العشر الأخيرة.. أنا دائماً بانتظار قراءتك المتميزة لأعمالي كلها، فرأيك يساعدني على تبين طريقي، لأنه رأي أخ وصديق صدوق.. دمتَ لي ذلك الأخ، وأعدك بأن أبذل كل ما بوسعي لتنقية الموقع من السخافات، لكن ليت الجميع يمدون لي يد العون في هذه المهمة..[/align] |
||||||||||||||||||||||||
|
|

|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [6] | |
|
عروبة شنكان - أديبة قاصّة ومحاورة - نائب رئيس مجلس الحكماء - رئيسة هيئة فيض الخاطر، الرسائل الأدبية ، شؤون الأعضاء والشكاوى المقدمة للمجلس - مجلس التعارف
           
|
رد: ميت في إجازة!!!
القراءة لكم دكتور توسع الأُفق، تستدعي الذائِقةَ الأدبية، لِتجود قصصاً
استمتعنا وبانتظاركم على الدوام تحيتي |
|
|
|

|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [7] | |
|
أديب وناقد - باحث متخصص في السياسة والأدب الإسرائيليين- قاص وأديب وناقد -أستاذ مادة اللغة العبرية - عضو الهيئة الإدارية في نور الأدب
          
|
رد: ميت في إجازة!!!
[align=justify]أستاذة عروبة..
شكراً لهذا التعليق الموجز جداً، والمعبر جداً، والدقيق جداً.. إنه فعلاً، من نوع (خير الكلام ما قلَّ ودلّ).. تقبلي محبتي وتقديري..[/align] |
|
|
|

|
|
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| إجازة!!! |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| حتى الشيطان كان في إجازة | طلعت سقيرق | في الصمت ....متكأ .. | 2 | 06 / 03 / 2020 38 : 02 AM |
| إجازة الصيف وأمراض الإسهال | ناهد شما | نورالأسرة، التربية والتعليم وقضايا المجتمع والسلوك | 3 | 13 / 06 / 2011 28 : 04 AM |
| في أجازة | عبدالله الخطيب | القصة القصيرة جداً | 2 | 28 / 07 / 2010 05 : 02 AM |
الساعة الآن 31 : 06 AM
|
|